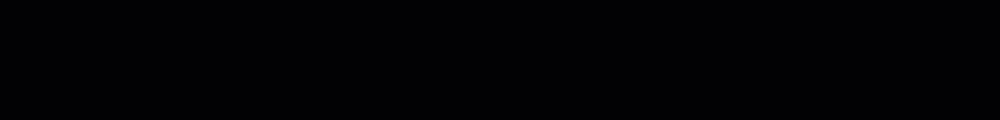عباس التجربة الرائدة
بمناسبة الحديث عن المناضل الرائد عباس بن علي الوزير نعيد نشر المقال التالي الذي سبق وأن نشر في العدد الخاص من جريدة الشورى بمناسبة ذكرى رحليه بتاريخ 3 رمضان 1417 هـ الموافق 12 / 1 / 1997 م العدد ( 209 ) .
“إنها سنةٌ حسنة. سيظل اليمنيون يذكرونها بالتمجيد والإكبار، ويقولون وهم خاشعون: هذه سنة العباس الوزير”.
(أحمد محمد الشامي)
من الناس من يأتي إلى الحياة، فيزيد فيها معنى تخصب به وتمرح، فإذا رحل عنها بقي – هو – في تلك الإضافة يتجدد بها حياة في الحياة. ونقصت – هي – برحيله نقصاناً لا يسد وافتقدت شيئاً لا يعوض، لأنه افتقاد المدد المتجدد كل يوم بعمل جديد..
ولا يمتري أحد بأن عباساً رضي الله عنه كان من هذا النوع النادر، والطراز الفريد.. ولا تطمح هذه السطور إلى تسجيل حياة الرجل ولا حتى فصولاً منها. إنها ترمي – فقط – إلى تناول أولي لتجربة رائدة من تجاربه ختم بها حياته الحافلة بضروب الجهاد وألوان التضحية وأفانين الفداء مقدماً بين يديه، إلى ربه عز وجل، عمله الأخير.
إنها تجربته الاجتماعية. أو قل – إن أردت الدقة – مغامرته الاجتماعية الباسلة.
إن حياة العباس كلها ملحمة بالغة الروعة، بالغة الدلالة كذلك، تكاد تختزل – في شخص – تاريخ مرحلة كاملة من تاريخ أمة.
ولد – رحمه الله – في سنة 1348هـ/1929م وهذا هو العقد الذي شهد أواخره بداية الخلاف بين أبيه العظيم وبين الإمام حول قضايا الأمة ومستقبلها.. ذلك الخلاف الذي استهل به ما سُمي – فيما بعد – بالحركة أو القضية الوطنية والإصلاحية.
وهكذا لم تتفتح مداركه إلا على الساحة المضطرمة بيقظة الأفكار وتصادمها، وأصوات النصح المخلص مختلطة بمشاعر اليأس المحبط، وأصداء النجاح والإخفاق للمحاولات المتكررة دون انقطاع، وتنوع أساليب العمل بكل ما يحيط ذلك من ضروب القلق العام، وأشواق التطلع الحارقة إلى آفاق ترسمها الأحلام ويغلفها الواقع بالغموض والإبهام!.
حتى إذا بلغ مطلع الشباب وجد نفسه يرقب بعين مفتوحة، وبصيرة نافذة ما يدور حوله، ويسمع بأذن لاقطة وعقل يقظ أحاديث الأفكار والخطط والأهداف والآمال، تلك الأمور التي تشكل جميعها عادة “مكونات” ثورة تتخلق.
ثم لم يلبث أن عاد أخوه الأكبر عبد الله من مهجره منطوياً على بركان يتضرم فسرت وقدة حماسه في عزائم الرجال المصممة على اقتحام التاريخ.. بثورة!.
وتحول “دار الصياد” إلى ملتقى لهؤلاء الرجال. أو إلى “معمل” لإنتاج الثورة المرتقبة. وهو – خلال ذلك – يسرح طرفه بين تلك الهامات الشامخة، ويصيخ بسمعه إلى أحاديثهم الحالمة، العالية النبرة، ويختزن عقله ذلك كله، ويحتضن وعيه أبعاده ومراميه، ويوازن ببصيرة نافذة بين وقار أبيه القابع هناك في “المحويت” يوجه الأمور بحكمته، ويدير الأحداث باتزانه، ويعالج المشاكل بأسلوبه الصبور الوقور متوخياً الإصلاح على هدى من ربه، متنكباً المحظور على بصيرة من علمه – وبين حماس أخيه ورفاقه الذين يريدون أن يسوقوا التاريخ سوقاً بعصا غليظة من حماس وأحلام، لا يلوون على شيء، ولا يلتفتون إلى شيء. قد ملأهم الإخلاص اندفاعاً يرمي بهم المرامي. ويصور لهم الأحلام “واقعاً” قائماً ينتظر الخطوة الجريئة ليمثل أمامهم “حاضراً” مكتمل السمات والملامح.
كان عباس حينذاك شاباً يافعاً خجولاً ومهذباً. معروفاً من طفولته الباكرة بالقدرة الهائلة على الصبر والتحمل، وبالأدب الجم الذي يحمله على الصمت المعبر، يختلف إلى المدرسة العلمية، ويتعلم من الحياة ومن رفقة تلك الطليعة النادرة من الرجال أضعاف ما يتعلمه من المدرسة العلمية، وحين لا يكون في صنعاء، فإنه يكون في المحويت بجوار أبيه يعب الحكمة ويستوعب المثل الأخلاقية التي تكون عظمة العظيم.
واندلعت الثورة الكبرى.. (1367هـ 1948م).
………
وفشلت الثورة!
وسيق الأحرار زمراً إلى أعواد المشانق، أو ظلمات السجون، وألقي القبض على عباس في معبر هو وزميلاه المناضلان: ابن عمه أحمد بن محمد، وخاله الشهيد عبد الله بن حسن أبو راس وسيق الثلاثة المغاوير في الأغلال، وطيف بهم في شوارع صنعاء، وتلقوا من الشتم والضرب والبذاءات العملية المتنوعة ما تلقوا.. وأصاب أحدهم العباس في خاصرته بركله أصابت إحدى كليتيه بأذى أورثها مرضاً مزمناً صاحبه حتى وفاته – رحمه الله-. وانتهى بهم المطاف في حجة حيث زج به مع ابن عمه في سجن القاهرة. مع أبيه وآله، وزج بخاله مع أخيه ورفاقه، ونسي العباس وابن عمه كل مصائب الدنيا حين وقع نظرهما على القيد في قدمي الأب العظيم، وهو يستقبلهما بنظراته الحانية الباسمة ووجهه المتألق.. كأنه في سدة حكمه لم تنل منه الأحداث منالاً.. بل زادته جلالاً وهيبة ووقاراً.
بقي بجانب أبيه يخدمه ويتلقى نصحه ودعاءه وهو يودع نزلاء الغرفة ذاتها شهيداً من أهله بعد شهيد بدءاً بإمام الدستور وهاديه الكريم، ويتلقى المصارع الفاجعة للشهداء الميامين الذين يخرجون للإعدام يوماً بعد يوم من سجن نافع وفيهم أخواله، وأساتذته، وأصدقاؤه. أولئك الذين كانوا جميعاً أمل أمة ألقت عليهم أعباء نهضتها!
حتى جاء اليوم الأرهب، وفُتح باب الغرفة المقفلة ونودي على اسم أبيه العظيم. لطالما حدثه أبوه أن هذه الساعة آتية في أي لحظة من ليل أو نهار. ولكم أعرب له ولمن حوله عن تعجبه من تأخرها، كان يقول: إن أحمد لن يفوت فرصة كهذه للتخلص منه، كان يعرف أنه هو المطلوب الأول من زمن بعيد، وكان ما يحيره هو هذا السؤال: لماذا لم يقترف الإمام جريمته بعد؟
ولشد ما أرق عباس أن يشهد تطلع أبيه إلى تلك اللحظة المنتظرة في تهلل جليل وشوق يتضوع إيماناً إلى معانقة “الشهادة” التي كانت دائماً ضمن المأثور من دعواته وصلواته.
رأي العباس أباه يثبت لما سمع الداعي متهلل الوجه باسماً هاتفاً من أعماقه: الحمد لله. ووجم الجميع.. ووثب العباس إلى أبيه يساعده على ارتداء ثيابه. وهو صامت كأنه الكتلة المتحركة من الحزن المتجسد، ولكنه ثابت ثبات المؤمن الذي يعد نفسه لمعانقة اللحظة الجليلة ذاتها.. وأبوه يربت على كتفه مواسياً متهلل الوجه يتلو آيات ربه.. حتى إذا حانت لحظة الانصراف ضرب الأب الحافي على ظهر ابنه في حنان وحب. ملقياً نصيحته الأخيرة إليه وإلى ذويه من حوله: كونوا رجالاً!
ويشهد الله ويشهد الناس أن العباس قد حفظ الوصية وأمضاها، فكان في كل أحواله رجلاً ولا كالرجال بل واحد الآحاد في هذا المضمار ورجل الرجال..
وقضى عباس في السجن بضع سنين. وبعد أن تعب السيف الأهوج من الصعود والهبوط على الأعناق وعاد إلى قرابه لينام من لغوب إلى حين – تهيأ للمساجين أن يختلط بعضهم ببعض. ووفد على سجن القاهرة ضيوف جدد حظي العباس منهم جميعاً بالود والتقدير، وأخذ منهم – بدوره – مزيداً من التجارب وكثيراً من العلم.
وتقلبت به صروف الحياة بعد ذلك من سجن إلى سجن، ومن منفى إلى آخر وهو لا يتوقف عن العمل من أجل أمته، ولا يني عن تطوير نفسه ووسائله، ولا يدخر جهداً أو مالاً يملكه في سبيل الرسالة التي نذر لها نفسه في تبتل القديسين.
شارك في كل جهد ظن فيه خيرا، فكان نائباً لرئيس الاتحاد اليمني – الشهيد الزبيري – في القاهرة المصرية. ومؤسساً لحزب الشورى مع أخيه إبراهيم ورفاقه الأعزاء: علي عبد العزيز نصر، محمد الرباعي، عبد الرقيب حسان، وغيرهم إلى غير ذلك من ضروب الجهاد وألوان الكفاح!
وحين أعلنت الجمهورية صبيحة السادس والعشرين من سبتمبر (1962) وجدناه ينتقل من سفارة إلى أخرى يعلن انتماءه للعهد الجديد. وتوجه إلى القاهرة في طريقة إلى صنعاء، وهناك التقى بنفر من الأصدقاء والزملاء الذين بدأ البيضاني ينفيهم إلى القاهرة، في محاولة لإفراغ البلاد منهم، وينزلونهم في فندق الكوننتال. إنها مرحلة عبرت عنها نكتة لاذعة أطلقها المناضل والمربي البارز أحمد المروني حين أطلق على الفندق اسم: “السجنينتال”!
وبدأت مرحلة جديدة..
وحين يكتب التاريخ المؤرخون فعلاً لهذه الفترة فإن العباس سوف يشغل صفحات طوال منه. كما شغلت مواقفه المضيئة الناس في حياته. لقد تطورت الأمور إلى أن أصبحت حرباً مدمرة غابت عنها الأهداف وبقيت الوسائل المدمرة، وأصبحت البلاد مسرحاً لصراع إقليمي ودولي لا ناقة لها فيه ولا جمل وبات من الضروري إيقاف هذه الحرب لتحقيق الثورة ذاتها وتحقيق الأهداف وبات ذلك شرطاً لإقامة الدولة الحديثة وتحقيق التنمية وصولاً إلى العدالة الاجتماعية، وبناء مؤسسات المجتمع المدني وصولاً إلى الديمقراطية، وهذه هي أهداف التغيير. أضف إلى ذلك أن استمرار الحرب سيأتي على البقية الباقية من القيم الأخلاقية ويفسد الذمم التي باتت تباع وتشترى بثمن بخس في مزاد الحرب فتدمر أغلى ما في الإنسان الذي هو عدة البناء ووسيلة انجاز “المشروع الحضاري” وهدفه في آن!
لذلك كله احتل هدف إنهاء الحرب وتحقيق السلام أهمية تصدرت “الأولويات” في قائمة الراشدين من أبناء الوطن جميعاً باعتباره المدخل الوحيد لتحقيق المستقبل المنشود.
وفي هذا كان لعباس – رحمه الله – نصيب غير منقوص.
وعندما تحقق السلام، وتمت المصالحة وأذنت بعض المؤشرات بإشراق تحول دستوري مدني مبشر بتطور رشيد على طريق التحول العام والمطلوب، وتسلم سدة الحكم زملاء وأصدقاء أعزاء قرر عباس – رحمه الله – أن هذه هي اللحظة المناسبة لشد أزرهم والإسهام في تسريع الإيقاع المتردد لعملية التحول المنشود.
إن بناء الدولة يجب أن يتم على أسس سليمة من الشورى الكافلة لحقوق الإنسان وحرياته ومشاركته الفاعلة في أمور مصيره والتبادل السلمي للسلطة. وذلك شرط لتحقيق العدالة الاجتماعية التي هي أساس للاستقرار الدائم على المدى الطويل وهدفه.
من أجل ذلك حزم عباس حقائبه عائداً إلى الأرض التي هاجر من أجل المستضعفين من بنيها، مفتوح العقل والقلب على زملائه الذين يحكمون. ولكنه ما لبث أن اكتشف أن الأمر ليس على النحو الذي تصوره؟ فالحاكمون الآن يريدون الحفاظ على الحكم القائم على “معادلات” قبلية وعصبية تفرغه من مهماته الأساسية ليكون فقط في خدمة تلك المعادلات المتخلفة التي لا تسمح بقيام دولة حديثة بالمعنى الحقيقي. لم يعد الحكم وسيلة. لقد أصبح غاية بحد ذاته. وتلك آية الانحراف!
وقد حاول.. ولكن هذه المحولات لم تفض إلى نتيجة عملية يطمئن إليها. كانت الأبواب والقلوب مفتوحة له تحاوره وتداوله الرأي ولكن النتيجة كانت هي نفسها” الاصطدام بحائط المعادلات المشؤومة إياها. إن الزملاء الحاكمين لا يريدون المساس بها خوفاً على كراسيهم.. التي – رغم ذلك بل بسبب ذلك على وجه التأكيد – أطيح بها آخر المطاف!
كانت هذه هي التجربة السياسية الأخيرة للمجاهد السياسي الصابر والمثابر، فقد دفعه هذا الموقف إلى إعادة النظر في أساليب العمل المطلوب ونوعيته. وخلا إلى نفسه في مزرعته في “حقو الخير” في بني حشيش أو في داره في الصياد دون انقطاع عن الناس في مقيله اليومي مستعرضاً الآراء والأفكار، منصتاً إلى نبض الواقع، مستطلعاً وعود المستقبل كما يحلم بها المثقفون أو يعبر عنها الجمهور، يطرح من الأسئلة أكثر بكثير مما يتلقى من الإجابات. وما أنفك خلال ذلك كله يدير حواره الداخلي مع نفسه حتى استخلص تصوراً جديداً لدوره، وأسلوبا مختلفاً لعمله، ومجالاً غير مسبوق لنشاطه.
ثم صح منه العزم وتوكل على الله سبحانه. يقرن القول بالعمل ويصحب النظرية بالتطبيق. ويؤلف بين الفكر والواقع..
خلاصة ما وصل إليه: أن العمل السياسي لم يعد مجدياً. لقد كان مجدياً يوم كان لمحاربة الحكم السابق، لأن المعالم واضحة، بين ما يريده الحكم وما يريده الشعب. أما اليوم فقد اختلطت تلك المعالم. وتحول الحكم إلى مناورات فارغة لإدارة المصالح الضيقة لفئة محدودة وأكثر سجعاً وأملك لأدوات التضليل.
فإذا تركت هذه الدائرة، وجدت المثقفين واحداً من اثنين: إما مسحوق تحت العقب الحديدية للقوى المتخلفة باسم التقدم المفترى عليه. فهو يتوارى من الخوف من سوء ما ينتظره، وإما مقتعد مكاناً في “وظيفة” تكفل له العيش والسلامة وقد شتتها الاتجاهات المختلفة ومزقها التطاحن دون أن يجمعها هدف جامع. لقد فقدت القدرة على أداء دور فاعل وأصبحت إحدى شرائح الشتات والتشرذم مكتفية بأحاديث المقايل.
أضف إلى ذلك شريحة هزيلة من وكلاء تجارة يحرصون كل الحرص على خدمة أي ذي سلطة حرصاً على “التصاريح” التي تمكنهم من الاستيراد دون أن يطمحوا إلى تطوير أنفسهم إلى مستوى أعلى من رأسمالية وطنية ناشئة مثلاً، تخرجهم – في آن – من أسار الوكالة للإنتاج الأجنبي ومذلة الخنوع للحكم ويتمكنون من بعد أن يصبحوا قوة فاعلة تستفيد منها البلاد بقدر ما يستفيدون منها. إن توجهاً من هذا النوع من شأنه أن يدعم سيادة القانون، وبناء المجتمع المدني وتحقيق الاستقرار لكن لم تكن هذه الفئة التي أعماها الجشع بأقل ضياعاً من غيرها. إنها بوضعها هذا – قوة إعاقة وتعطيل لحركة المجتمع وتقدمه. بل حتى لمصالحها ذاتها من حيث تظن إحرازها بالتبعية والخضوع الذليل..
إلى ذلك فإن الشعب يعيش عزلة حقيقية عن مجرى الحياة العام. إن أغلبيته غير عابئة بما يدور هناك في دهاليز السياسة المتعفنة، بل إنها في مجموعها لا تكاد تدرك أن ثمة ظروفاً أفضل يمكن إحرازها. لقد سمعت كلاماً كثيراً. ولكن بدون مدلول بالنسبة إليها. وعوداً لا تثمر شيئاً. وجعجعة ولا طحن، أفقدتها الأمل الذي كانت تعيش به، وفرغت الشعارات من مدلولاتها وجردت الكلام من مصداقيته!
ما مؤدى ذلك كله؟
مؤداه – في مرتأى عباس – أن مهمة المثقف، والسياسي والثائر اليوم تتلخص في العمل المباشر، اليومي، مع الناس البسطاء الحالمين بمستقبل لا يعرفونه، ولا يعرفون الطريق إليه. مستقبل يخرجهم من ظلمات ما هم فيه.. إلى شيء أفضل وأكثر عدلاً وإنسانية.. ولا كيف الوصول إليه أو الحصول عليه.
وسبيل تعريفهم لم يعد ممكناً بعد كل الخيبات التي أصابتهم إلا بالجهد المباشر، والعملي، عن طريق الواقع نفسه في أبسط أشكاله. وبداية من البداية. إن إطلاق شرارة الوعي إنما تنطلق من خلال الأشياء التي تغير ما بالنفس، وإن إقران العلم بالعمل والمعرفة بالوعي هما الوسيلة التي يتحقق ذلك بها، وهذا لا يتم إلا من خلال ارتباطهما الوثيق بالتجارب المباشرة أياً كانت صغيرة وبسيطة.. فإن القدوة الماثلة والعمل المجسد لفكر هو الذي يطلق الفاعلية في الإنسان من عقالها الموروث..
وليس أمام المناضل السياسي الثائر اليوم إذا أراد أن يظل وفياً لرسالته من وسيلة إلا الخدمة الاجتماعية، إن هذه الخدمة الاجتماعية هي أساس التنمية الشاملة تنمية الإنسان بتنمية وعيه لدوره وإدراكه لوسائله. فمن خلال تغيير الظروف المحيطة يتم تغيير الإنسان ولكن من المهم جداً أن يتم تغيير الظروف بالإنسان نفسه. وعلى ذلك فلتكن البداية من أولى حاجات الناس وضروراتهم. وأننا لندرك مدى ما يحدثه مجرد حفر بئر – مثلاً – في منطقة لا تشرب إلا من الأحواض الراكدة التي تملؤها الأمطار من أثر بعيد المدى على إنسان تلك المنطقة. إنه يكتشف أن ثمة مصدراً آخر للمياه. وأن ثمة ماءً أنقى فيما يعتاد. والأهم: انه يستطيع الحصول عليه بجهده.. قد يبدو ذلك شيئاً بسيطاً. ولكن المعرفة التي اكتسبها الناس بوجود مصادر جديدة. والوعي الذي أحزروه بقدراتهم على الحصول عليها: بجهودهم ووسائلهم المحدودة تجعل من ذلك تجربة هامة غير بسيطة في تنمية معارف الإنسان وخبراته وثقته بنفسه، واعتماده على وسائله. إنها ستقودهم صعداً من هذه النقطة إلى مدى بعيد. إن التاريخ يعلمنا أن الإنسان لا يتوقف إذا بدأ الخطوة الصحيحة الأولى..
بمثل هذه الأفكار والتصورات، حشد العباس عزائمه واختار منطقة من أشد مناطق البلاد عزلة، وحرماناً وغياباً عن العصر ويمم نحوها مع نفر من بنيها في محاولة عملية لتطبيق أفكاره. قال لي – رحمه الله -: لقد سئمت من مضغ الأفكار مع القات.. ومللت ذات الحوار كل يوم، وإنما أريد أن أكون أميناً مع نفسي ومع الجهاد الطويل. وما من سبيل لذلك إلا بالتفرغ للخدمة الاجتماعية، المجردة من كل غرض، الخالصة لوجه الله عز وجل؛ فإن أدت إلى تطور محمود أو عادت على العمل السياسي بفائدة فذاك، وإن لم فإنها غاية في نفسها.. حسبي أن أكون أديتها..
خرج عباس إلى بني ضبيان من أعمال خولان الطيال، وحمل معه ما استطاع من أدوات العمل اليدوية البسيطة (مفارس ومجارف) لشق طريق توصل المنطقة بالمدينة. وبأنحاء البلاد وتنهي عزلتها. وفي يقينه أن ذلك بحد ذاته عمل سيحدث من التغيير شيئاً كثيراً.
في الطريق انتصب أمامه الخلاف الدامي بين قبيلتين من قبائل خولان، فدعا عقلاء القوم، وأصلح ذات البين.. وهناك في الخط الفاصل بين القبيلتين المتحاربتين رأت العيون الذاهلة أبناء القبيلتين معاً يشقون الطريق بسواعدهم المشتركة يتقدمهم العباس بنفسه حاملاً معوله يضرب الصخر الأصم.
وانفتحت الطريق..
واتصل الجبل الصعب بالسهل غير السهل.. وحدث إذ ذاك أن امرأة حاملاً جاءها المخاض فأعسرت ويئس من حولها من حياتها فما كاد خبر ذلك يصل إلى عباس حتى أمر بحملها على سيارته وإرسالها إسعافا إلى صنعاء.
وأنقذت المرأة.. وعادت بعد قليل مع رضيعها معافاة، لقد كان محكاً لأفكار عباس، حقاً! لقد أحدث ما يشبه الثورة، اكتشف البادون من المحرومين أن ثمة علاجاً بإذن الله لما يحسبونه قضاءً لا يرد، وإن الطريق كانت هي السبب في الوصول إليه، فاندفعوا زرافات ووحدانا يشقون الطرق، ويمدون العاملين بما يملكون من زاد ولبن. وتحول منزلنا في الصياد إلى شبه مستوصف يستقبل كل يوم مريضاً أو أكثر مرسلاً من العباس تقوم على العناية بهم زوجه الفاضلة وابنتاه المكافحتان ويصبح ابنه البار عبد الله موزعاً بين الوظيفة في وزارة الزراعة وبين قضاء حاجات هؤلاء الذين يرسلهم أبوه. وأشهد أني كنت أزيد في مخصصات العائلة سراً منه. لأنه – رحمه الله – كان قد فرض عليها حياة تقشف صارم، ليوفر ما يتوفر لأعماله. ومن الحق القول: أن الجميع كان يتقبل ذلك راضياً!
ولكم رأينا بأم أعيننا دهشة أولئك القادمين والقادمات لمظاهر المدينة البسيطة في صنعاء من كهرباء وماء يجري في أنابيب إلى المطابخ والحمامات وغير ذلك! ولكم سمعنا النساء – بوجه خاص – اللائي يرهقهن حمل “الحطب” وجرار المياه من أماكن بعيدة كل يوم – يقلن: إذن هذا هو ما يريده لنا عباس الوزير.
وجد المياه شحيحة، فحفر بئراً ارتوازية للماء النقي وشاء الله أن ينبجس منها الماء عذباً نقياً. وإذا بالناس يعمدون إلى حفر آبار للمياه هنا وهناك تقيهم ظمأ الحياة وعنت التعب. وأما هو فقد رأي أفكاره تنبت في الأرض حياة، وفي الناس حماساً وثقة وتطلعاً إلى المزيد..
والتف الناس حوله في ولاء عظيم، فأصلح بين المتقاتلين، ووجههم عوضاً عن الاقتتال إلى استصلاح الأراضي، وشق الطرق، وحفر الآبار، ووضع حجر الأساس لمبنى مدرسة، واستقدم لها معلماً فإذا بها تمتلئ بالصبية الذين توافدوا عليها من كل صوب قبل أن يكتمل البناء، الحمد لله. لقد أصبح العلم مطلباً!
وما زال على ذلك دائباً في الليل والنهار، مع كل نقلة من تنقلاته يقوم “مشروع” أو يتم إصلاح بحقن الدماء، ويؤلف بين القلوب، أو يُسعف مريض. أو يعمر مسجد بالمصلين، أو تعج مدرسة بطلابها. ومع ذلك يحصل ما هو أهم: يتفتح وهي، وتتنور عقول، وتتغير نفوس، ويكتشف الناس قدراتهم، ويتولد بذلك، كله إنسان جديد لمجتمع جديد.
ذلك كان جماع تفكيره.
وذلك كان محصلة أعماله.
وأما هو فقد شعر بالرضا النفسي، والسكينة يتلقى محبة الناس بسعادة، ويتلقف مشاعرهم الصادقة نحوه بولاء حميم لمواصلة رسالته. ولكم أسعدته في خيمته، هدية عجوز لا تزيد على قطعة خبز أو جرة لبن. وكان يقول لي – إذا صدف أن كنت عنده – هذه أغلى عندي من كنوز الدنيا.
وتسامعت بأعماله القرى والدساكر، فتوافدوا عليه.. لم يكن يملك مالاً يوزعه، ولا سلاحاً يهبه، ولا مناصب يغري بها من يسعى إليه. إنما كان يملك تبتله وصدقه. فيبذل جهده قدوة للمقتدين. ويوزع نصحه فيوقظ الهمم الجامدة، ويحرك السواعد الكسلى، فتندفع – وهو في الطليعة – تحيي الموات، وتحرث الأرض، وتستخرج الماء وتشق الطريق وتبني المدرسة.. وكادت خولان كلها أن تصبح مصدر إشعاع ونموذج حركة، وساد سلام بين القبل وبينها وبين نفسها. وما يسمع بنامة نار مشؤومة إلا وهب من لحظته ليسكتها في المهد، وكانت كلمة منه، أو حضور مفاجىء كافياً لتحقيق ذلك. وبدأ يفكر في حملة شاملة على مستوى البلاد لتحقيق مصالحات عامة تنهي قضايا الثارات المزمنة، ومصادرة النزاعات المستمرة بين القبائل. ومن ثم توجيهها باعتبارها وحدات حضارية نحو مصالحها ومستقبلها على نفس الطريقة وفي هدى تجربتها.
وجاءت الدعوات من كل مكان..
وانتقل إلى جبل اللوز، ليشق بجهود الناس وسواعدهم أنفسهم الطريق الصعب، في الجبل الصعب، بالوسائل البدائية من مفارس ومجارف حتى تم لأهل الجبل ما أرادوه بسواعدهم بعد أن أعياهم الانتظار، وأرهقهم التجوال في أروقة حكومة غائبة، طلباً للمساعدة في شق تلك الطريق..
أعقب ذلك بناء المدرسة وهبت الحكومة بقضها وقضيضها لحضور احتفال وضع حجر الأساس، سخية بوعود لم تتحقق أبدا لبناء المدرسة، وذلك في محاولة لخطف البريق الذي أحدثه شق الطريق. ولكن مبادرتها انتهت بنهاية الاحتفال.
وتتابعت الخطوات، بنفس النتائج ونفس الأثر ونفس الرضا النفسي الغامر لفارس التجربة الرائدة وهو ينظر الناس ينسلون من كل حدب يشقون طريق حياتهم ذاتها.. بوعي جديد وعزم مستعاد. وإرادة تبلجت مقاصدها!
وفيما كان يستعد – رحمه الله – للانتقال إلى منطقة أخرى – أحسبها مراد وعبيدة – حدث أن تجدد قتال بين قبيلتين ممن كان قد أصلح بينهما، وجاء الداعي مستنجداً. فانطلق لا يلوي على شيء إلى موقع الاقتتال الذي توقف فوراً بحضوره لكنه شمر ليعرف أسبابه ودواعيه. فأراد أن يقضي عليه من جذوره فأخذ ذلك منه جهداً متصلاً.. لم يشفق فيه على نفسه ولا جسده الذي هده الجهد العنيف الموصول: فأصيب بمرض حاد لم ينفع معه إسعاف، فرجعت النفس المؤمنة إلى ربها راضية مرضية.. ومات رجل المروءة، والشهامة والفروسية، مات عباس الوزير..
…………….
عندما عدنا من الدفن، وصلت المنزل في حالة من الحزن لا سبيل حتى الاقتراب من وصفها بين صفوف من المعزين بعد صفوف، وجاء من أقصى الريف رجل يسعى حاملاً صفيحة فارغة، سلم علينا بصوت متهدج وقال: هذه أول صفيحة تملأ من أول دفقة من آخر بئر حفرها لنا ومعنا عباس. انبجس ماؤها يوم وفاته، وجئت بها لأرشها على ثراه الطيب عقب دفنه.. وقد فعلت.
هل هناك تحية عرفان، والتفاتة حب. ونفحة وفاء أرق وأعذب من هذا الصنيع الجميل الكريم؟ أما أنا فكأنما انصب الماء على النفس العطشى إلى قطرة عزاء ورجوت – في دعاء عميق – أن تغسل هذه القطرات التي حملها رجل مؤمن من مكان قصي سحابه نهاره وليله كل ذنب للفقيد الغالي فيلحقه ربه عز وجل برحمته بالأنبياء والشهداء والصديقين.
كان آخر أعماله – رحمه الله – إصلاحاً بين الناس، وحقناً لدماء قوم مسلمين، وكانت آخر هدية تصله رشة ماء عذبة من قوم أنقذهم من العطش، ترش على ثراه الندي يوم رحيله.