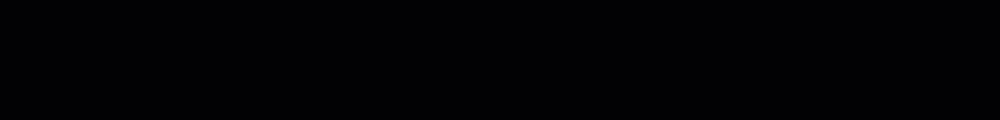صنع في اليمن ( 6 ) ” المقاوم السجين “
إلى الصديق الكريم الذي سألني: وماذا “عن عباس بن علي الوزير”؟، فهذا هو العباس .
(1)
في الفصول السابقة إشارة عن أخي “عباس” مقتضبة، قضى به السياق عند الحديث عن المؤثرات الثورية على قيادة المقاومة التي أنشئت عقب سقوط الثورة الدستورية مباشرة وبدون فاصل زمني. ولأنني اكتب تاريخ هذه المقاومة فأنا أحافظ على التسلسل و على ظهور الأدوار تباعا، في مرحلة نضالية امتدت 69 عاما بما فيها من نضال شاق وسجن ونفي وتشريد، وفشل ونجاح، وخطأ وصواب، ولأن الأمر كذلك فلابد من مراعاة الكتابة – بدون استباق – عن دور كل إنسان أسهم فيها عندما يظهر دوره، ومدى إسهامه في نشوء تلك المقاومة وفي تطويرها إلى أن صارت رقما نخبويا وشعبيا -برغم كل العثرات والتعثير- لها وجود متميز.
وبينما كان أخي “إبراهيم” ورفاقه يؤسسون المقاومة كان أخي “عباس” في هذه الفترة في غياهب “سجن القاهرة” بـ “حجة” مع والده، ومع بقية إخوانه ورفاقه {منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا} ، وعندما وصل “علي بن علي الجرادي”- رسول المهمات- تم الاتصال على نحو متقطع بين “السجن” والهجرة” أي بين أبي وأخي “عباس” وابن عمي “أحمد بن محمد الوزير” وبين أخي “إبراهيم” وأعضاء “المقاومة” كما سيأتي.
(2)
كان أجمل نغم يستحليه أخي “عباس” هذه الكلمة العذبة كلمة مواطن، طالما رددها في فمه، وكأنه يمضغ شهدا سائلا، وعسلا مذابا، وطالما تغنى بها وكأنه يسكب في شبابه أغنية راع، وهو ينحدر صوب القرية على ضوء غارب من شفق الأصيل، أو كأنه حنين ناي يتأوه في حضن الليل.
كانت أفضل كلمة يتمناها أن تطلق عليه، وأن يُسمّى بها. لم يكن يحب الألقاب ولا الكنى، كان يحب فقط أن يسمى المواطن عباس.
وهو يعرف ما تحمل كلمة المواطن من مسئوليات. لم يكن يغريه بها نغمها الحلو، وإنه لنغم جميل، ولم يكن يستحليه رنينها العذب، وإنه لرنين أخاذ، ولكنه كان يستحليها وينجذب إليه لأنها تحمل مسئولية ضخمة، عملا دائبا، تضحية بدون مردود، بذلا بدون فائدة، عطاء بدون ربح. لم يسع في استثمار يستفيد منه، ولا في منفعة يجنيها. كان يعتقد أن العمل في حد ذاته هو الجزاء الأوفى، هو الربح والمردود. ولذلك انطلق إلى الشعاب الداكنة والجبال الخرساء باذلا جهده في سقي حقول لا يملكها، وحرث مناطق لا يستغلها، وإنما هو العطاء المحض والبذل الخالص لا ينتظر على ما يبذل جزاء ولا شكورا.
لم يذهب إلى حيث تتوفر الإمكانيات لجني الحصاد الوفير والسريع حيث الفرص متاحة مغرية جذابة، بل ذهب إلى الجبال الصماء يضرب فيها بمعوله لتورق وعياً، وإلى الأرض القاحلة يضرب فيها بمحراثه لتنبت فكراَ، وماذا ستعطيه الجبال الصماء، وماذا ستمنحه الأراضي المجدبة من مردود. فهو لم يذهب لاستثمار منجم،و لإنشاء مزرعة يدران عليه ربحا وفيرا يستفيد هو وغيره منها، بل ذهب ليستنبت وعياً ويستورق فكرا.يساعد الإنسان في أحلك ظروفه.
كان يعتقد أن العمل سواء أأخصب أم أجدب هو الجزاء الأوفى؛ فإن أخصب فجزاؤه أنه رأى الفكرة تأتلق على جباه الآخرين، وإن لم يثمر فالتجربة جزاء لعمل لم يثمر، وعليه تكرارها.
كان “عباس” يعرف إذن معنى كلمة المواطن، يعرف أنها رسالة ينشرها، وضريبة يؤديها، عملا يبذله، لا مغنما يناله، ولا مكسبا يحصل عليه.
وكمواطن متوله في حب وطنه، فلم يكن يريد على ذلك جزاء ولا شكورا، بالرغم من ذلك حق له. ونحن نعلم أن ما من إنسان إلا وهو يطلب مردودا لعمله: إما مجدا باذخا، أو زعامة على قومه. أرأيت إلى هؤلاء الذين يناضلون من أجل حقوق شعوبهم ويُّزجون في السجون، وتُوضع الأغلال في أعناقهم، وإذا بهم في النهاية زعماء لأمتهم قادة عليها؟ ألا ترى أنه قد حصد جهده مركزا مرموقا، وأمرا مطاعا؟ ثم أرأيت هذا العالم الكبير الذي بذل أيامه ولياليه في سبيل تحقيق فكرة كيف نال جزاؤه إما مالا عميما أو شهرة ذائعة.
ولكن “عباس” المواطن لم يهدف إلى جاه ولا شهرة ولا مركز. كان كبير أخوته سنا ومقاما، ومع ذلك فلم يهتم أن يكون الأول بل رضي لنفسه أن يكون عضوا مع الآخرين.
وكان غنيا في نفسه وفي ماله فلم يضاعف مالا، ولا نقدا بل أنفق ما يملك، وبذل ما يدخر، عاف العاصمة حيث تُصنع الشهرة وحيث تتألق المكانة وتركها إلى واد ذي ثلاث شعب: صخر حاد، وتراب كالرماد، وأناس كالصخر قوة، وكالجماد عنادا.
رفض الوسائل التي تطلق الشهرة والألق حيث المذياع والصحيفة والمنبر واتجه إلى الصمت المنعقد ينسج منه بوحا حيا، ونبعا ثريا.
وهكذا يبدو “عباس” على حقيقته طرازا رفيعا وفريدا. لا أقول ذلك انسياقا مع عاطفة لأنه أخي، بل أقول ذلك حقا لأنه أخي. أخي الذي عرفته في السراء والضراء، في الشدة والرخاء، في الغضب والرضاء، في القرب والبعد، فما عرفته إلاّ متميزا في حالتي الغضب والرضاء، في الشدة والرخاء، في السراء والضراء. كان طرازا فريدا بالفعل. فهو قد نشأ في مناخ ناعم، وعاش في ظل حياة ظليلة، ومع ذلك فقد كان ناعما ولكن نعومة الصخر الأملس أشد ما يكون صلابة. كان أنيقا في مأكله ومشربه وملبسه ولكنه كان متواضعا أشد ما يكون التواضع، رؤوفا أشد ما تكون الرأفة، برا أعظم ما يكون البر. ولقد أعجب من ذلك الأنيق الحالم ابن المجد السياسي والفكر العالي وهو يترك الظل الظليل، والمكانة العالية، والمأكل الناعم والملبس اللطيف إلى الخشونة الخشنة. كان نسيما ينشر عبيره، ويبث فوحه ومع المستعلين كان عاصفا يبث حممه..
كان صبورا متحملا في بيئة لا تدعو إلى كل ذلك الصبر فهو يعيش في كنف والده الكريم، كل شيء متاح وميسر. ومع ذلك فقد شب صبورا، وعاش صابرا، لا تفارق الابتسامة فمه حتى عندما تجثو عليه المصائب.
ذات يوم وكان عمره اقل من العاشرة وقع على شظية صخر مسنونة شقت جزءا كبيرا من فخذه لكنه لم يئن ولم يشكو. وما تزال ذاكرتي تتصوره وهم محمول بين يدي حارسه مبتسما. ولولا أنه محمول حملا لما أحسست بما حدث له، فالابتسامة لم تفارق شفتيه رغم الآلام المبرحة المتقدة. لما وصل إلى البيت مشى على قدميه حتى لا يزعج أمه، ولكي يغالب الألم صعد وحيدا إلى السطح، فغلبته الحمى فأنّ؛ فنبه أنينه بعض المستخدمات فكلمن أمه فسعت إليه ملهوفة فوجدت حارا كالنار فاستدعت الطبيب فعالجه.
هذه الحادثة التي يضج فيها الصغار بكاء، ويبالغون فيها مبالغة شديدة ليكسبوا بها عطفا زائدا، أو حلوى لذيذة، أو مبلغا من المال، كما كنا نسعى عندما تصيبنا حمى بشواظها، أو يتناوشنا برد بزكامه، عندئذ نقبض ثمن العلاج بعض الحلوى اللذيذة، وإلاّ فلا علاج. أما إذا كانت حقنة عضلية فإن الثمن يصبح غاليا. كنا نسعى إلى المرض لنقبض ثمنا.. أما عباس فقد كان يخفي أوجاعه حتى لا يكدر خاطر أبويه أو أخوته أو أحدا من الناس، ضاربا بكل ما يغري الطفل من أشياء.
وفي تلك الفترة من الزمان يمكن أن أسمي المناخ الذي عشنا فيه بشيء من التعسف مناخا يجمع بين المكانة العالية والتواضع، يتناول فيه الأمير المهيب غداءه مع مستخدميه جنبا إلى جنب، ويقعد معهم، ويتحدث إليهم كما يتحدث إلى كبار القوم، وهم قريبون منه لا يحجبه عنهم حجاب، وكان “عباس” يمثل هذه المكانة المتواضعة في تناغم منسجم وعجيب. ومع أرستقراطيته وذوقه الرفيع الأنيق كان يحب ألاَّ يلعب مع أبناء فئاته إن كان هناك فئات، ويفضل عليهم أبناء الجيران البسطاء الطيبين فيلعب معهم حينا، ويتعارك معهم آونة، وينتصر طورا ويهزم طورا آخر فلا يتباهى بنصره ولا يشكو لهزيمته.
وعندما شب عن الطوق لم يكن يحب أن يعيش مع أمثاله من هذه الفئة الأرستقراطية، ولا يقيل مقيلهم، ولا يجلس مجالسهم، ولا يصغي إلى أحاديثهم، إنه ليسأم تكرار هذا النقاش، ويمل من هذه الأفكار الرتيبة المستعلية. كان يعتقده تكرارا من القول، وركودا في الفكر، وما كان يحب الركود، فكان يتنقل من هنا إلى هناك، يقعد أشهرا في “المحويت” ثم يغادرها إلى “صنعا” ثم يتركها بعد بضعة أشهر إلى “السر” فلم تمض أشهر حتى يعود إلى “المحويت” وهكذا. وإنني لا أذكر كيف كان السفر ينقلون خبر تنقله. كيف يقطع المسافة التي يقطعها الناس في ساعات فيقطعها هو يوما كاملا، لا يمر بشجرة إلاّ ويقعد فيها فيتحلق حوله الرعيان، ولا يلم بمحطة استراحة ألاّ ويطيل فيها المكث فيتحلق حوله المسافرون، ولا يمر به عابر سبيل إلا ويستضيفه، وكان في أوقات كثيرة يستظل في جرف من الجبل، أو نفق من الأرض فيقيِّل ويستضيف أي مسافر عابر ليقيل معه. وكم كان الكثيرون يتمنون أن يجدوه في طريقهم فيصرفون معه الوقت ويصغون إلى حديثه العذب اللذيذ. وطالما سمعت تلك الأحاديث، وطالما تاقت نفسي أن أكون معه فاستروح نسماته واستظل بفيئه. وقد كدت أن أنعم بهذه الرفقة ذات يوم لكن لم يحالفني الحظ فشعرت بحزن شديد ما يزال مذاقه يقطر مرارة في فمي حتى الآن.
هذه الحركة الدائبة القلقة علمته الحياة، ووصلته البسطاء من الناس، فعرف توجهاتهم الحقيقية، وبنى عليها خططه.
(3)
كأن أخي “عباس” قد تأثر في وقت مبكر بأفكار والده الإصلاحية، القائمة على حفظ الشريعة النقية و “نظام الإسلام الشوروي الانتخابي، وتنظيف الحكم الزيدي مما عراه من انحرافات أهمها إلغاء “دولة اليمن الإسلامية” -كما كانت تسمى به عند قيام الحكم المتوكلي- وقيام “المملكة المتوكلية”، أي إلغاء “نظام الشورى” وإحلال “نظام الوراثة- ولاية العهد” محله. ومضى على تلك الرؤية حينا.
وفي أحدى زياراته لـ “صنعاء” التقي بالشهيدين “أحمد المطاع” و “عبد الوهاب نعمان” وعقدت بينهم صداقة عميقة، وكانا يقيلان معه في “دار الصياد” ويتبدلان الأحاديث حول الأوضاع السيئة وكيف طريق الخلاص منها، ومن خلال الحوار اطلع على معارضة جديدة اسمها “القضية الوطنية” فتأثر بها أيضا، وعرف من خلالها شيئا يرفد الإصلاح الديني ولا يعارضه، ويتماشى معه ولا يقف ضده، فقد كان الشهيدان “عبد الوهاب” والمطاع” أيضا يتفقان مع نظرية والده الإصلاحية، ويضيفان إليها بعداً يمنياً، ولم تكن “الوطنية” بالشكل الانعزالي الحاد الذي هي عليه.
إلى جانب ما استقاه من والده من معالجة الانحراف السياسي فيزداد علما بما حوله، أضاف إلى ذلك كله ما سمعه من شيخي الوطنية “احمد المطاع”، و “عبد الوهاب نعمان” فتكونت لديه معرفة متميزة: عرف ما عند الناس من تضليل ديني وغباء وطني، وعرف عن والده مخالفة الحكم السياسي لنظام الشورى وظن أنه بهذين الجناحين سيحلق اليمن في آفاق المستقبل النقي، ولكن لا الإصلاح الديني ولا الوطني أثر في وعي الجماهير، وجاءت “الثورة الدستورية” لتؤكد ما بدأ يعيه. أدرك أن عقلية المواطن العادي بقيت صلبة لا تمتص حديث الأخطاء الدينية ولا الإصلاح الديني، ولا التغيير الوطني، إن كلا التفكيرين لم يدخلا في دماغ المسحوقين البسطاء؛ فالثورة الدينية يدركها النخبة، ولا يعرفها البسطاء الذين هم متخمون بالشكلية ، يرون الظلمة يصلون ويصومون ويحجون بل وقد يبالغون في الشعائر، فيكتفون بها ولا يسألون أنفسهم عما وراء ذلك من ظلم وتخلف. فلم تؤثر فيهم دعوات العلماء الثوار. والإمام يحيى له مكانة دينية تصل به إلى درجة القداسة وعندما قتل الإمام “يحيى” التهب حس الثأر للانتقام للإمام القديس عندما وجدوا القائد المهاب.
ولم تكن “الثورة الوطنية” أكثر حظا في تأثيرها من سابقتها، إنها في واد آخر تماما، ومن ثم بقي حس الجماهير المسحوقة مقفلا غبيا كما كان. وكان الخطأ أن تلك الأفكار انحصرت في الأفاق السامية، والأبراج العالية بدون أن تلامس حس القاعدة العريضة وتنورها. ومن هنا قرر عباس أن يعيد صياغة وسائله على منطق الثورة الدينية وعلى منطق الثورة الوطنية، وأدرك أن ترديد النظريات نوع من الركود، وهو لا يحب الركود. ونذر نفسه لمهمة أخرى كما سيأتي.
(3)
كان هناك إذن خطان متلازمان متناغمان، خط يضع أولوياته “وطن -إسلام”، وخط يضع “إسلام –وطن”، وكلاهما متفقان، بيد أن أولوية أخي “عباس” يتمثل في خط وطن يتكيف وفق الإسلام الصحيح، وأولوية أخي “إبراهيم” يتمثل في خط إسلام يكيف وطنا، ولم يكن بين الخطين تنافر، وإنما كانت هناك حسابات أولويات، بمعنى آخر كان “عباس” يمثل “رجل دولة” يتعامل مع المكائد والتقلبات بيد مرنة تحاول توظيف ما يجري لصالح خطه، بينما كان “إبراهيم” يمثل “زعامة شعبية” صلبة، وأظهر التوجهان نفسيهما في أكثر من موقف، وإذ فضل “عباس” أن يضع مجال تعاونه في حدود قضية ومعتقد، فضل “إبراهيم” مجال تعاونه في حدود معتقد ومعتقد، من هنا عندما كان “إبراهيم” بالقرب من تخوم الاشتراكية- والاشتراكية أيضا معتقد- كانت العدالة الاجتماعية في الإسلام هي التي تدفعه في ذلك الاتجاه فيتقارب مع من يعتنق هذا الخط، بينما لم يكن “عباس” ليشترط المعتقد مع من يتعاون، وإنما الإخلاص والثبات في القضية المشتركة، سواء أكان الشخص شيوعيا أو رأس ماليا، يمينيا أو يساريا؛ فالإيمان بالقضية هي الجامع المشترك، ليس ثمة من شرط إلا الصدق والثبات وعدم التقلب للوصول إلى الشاطئ الموعود.
وللحديث عنه بقية