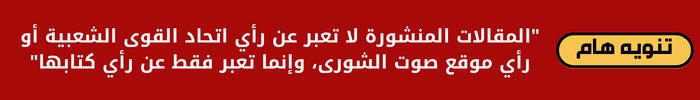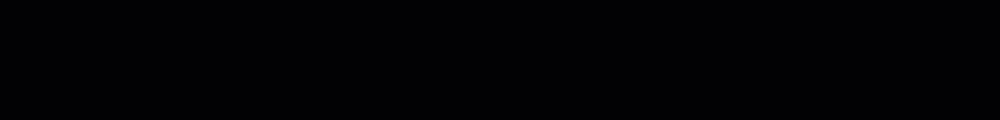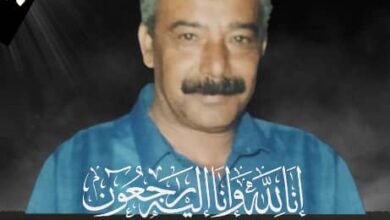ثقافة الذكورة في المجتمعات العربية

ثقافة الذكورة في المجتمعات العربية
أمين الجبر
الخميس 30 أكتوبر 2025-
تتميز المجتمعات العربية والإسلامية، وعلى رأسها اليمن، ببنية اجتماعية محافظة ومحكومة بإرث أبوي عميق الجذور، يعكس هيمنة البطريركية وثقافة الذكورة التي تتغلغل في صميم ذاكرتها الجمعية.
وصف عبد الرحمن ابن خلدون هذه المجتمعات بدقة بالقول: “تحتكم البوادي والأرياف العربية لعوامل العصبية القبلية والقرابية، وللولاءات التقليدية التي تحكمها الأعراف في إطار اقتصاد تقليدي مرتبط بالأرض والمواشي.” هذه الجذور الاجتماعية العميقة تكرس نمطاً من العلاقات التراتبية التي تستند إلى عصبية قرابية ضيقة، مستندة إلى ما وصفه فيرديناند توتيز بالمجتمع الجماعي البسيط القائم على روابط أولية حميمة وعلاقات عرفية قائمة على القرابة، حيث تغلب الإدارة الطبيعية على مفهوم الإدارة الرسمية.
وفي تصنيفات علم الاجتماع الكلاسيكية، يجسد هذا الواقع ما أسماه روبيرت ريدفيلد بـ “المجتمعات التقليدية” التي تفتقر إلى الروح الديمقراطية، وتتسم بالعزلة والانضباط العرفي، متعالية على مفاهيم الحداثة والدنيوية. أما إميل دوركايم، فيرسم صورة لهذه المجتمعات عبر قوة روابط النسب والقرابة كآليات آلية تكرس البنية التقليدية الثابتة. ولقبول التقليدية ومقاومتها، جاء بول فاليري ليعتبرها وجهاً عدائياً للتقدم الإنساني، مما يعكس صراعاً حضارياً بين ثوابت الماضي وديناميات التطور.
وبعیدًا عن النظريات الاجتماعية المجردة، فإن الواقع العربي، لا سيما في اليمن، يشهد استمرار احتكام ثلاثة مرتكزات سلطوية راسخة: الموروث الديني، الثقافة الشعبية، والفكر الإعلامي، الذي يعزز تكريس الأعراف ويحولها إلى تقاليد ملزمة تُفرض بالقوة الاجتماعية والسياسية، مما يؤدي إلى تهميش المرأة وتقليص حقوقها إلى حدود وظيفة التابع والتابع مراقبة.
تغذي هذه البنية التربوية والتنشئة الاجتماعية في الأسرة العربية أشكالاً من التسلط والتذبذب والحماية المفرطة التي تعيق تشكيل شخصية مستقلة للنمو الاجتماعي للمرأة، وتؤدي إلى ضعف مهارات اتخاذ القرار وتكبيل الفكر النقدي. هذا الواقع انعكاس مباشر لكون الإنسان كائنًا اجتماعياً يتشكل عبر منظومات قيمية تنمو في بيئات محافظة تُكرّس الهيمنة الذكورية.
في ضوء هذه المعطيات، تظل العلاقة بين الرجل والمرأة في مجتمعاتنا مجتزأة منطقياً واجتماعياً، تهيمن عليها ثقافة رجولية تقمع حضور المرأة وتقلص فرص مشاركتها في الحياة العامة والحريات الشخصية. ومن هنا يبرز نقد جون ستيوارت ميل الراقي الذي يدعو بجرأة إلى تبني مبدأ المساواة المطلقة والعادلة بين الجنسين، معتبرًا أن استمرار نظام الخضوع القانوني للنساء هو أحد العوامل الرئيسة التي تعيق تطور البشرية.
كما تؤكد الدراسات الاجتماعية المقارنة على قابلية المرأة لقبول وضعية التبعية رغم تفوقها في المجالات التعليمية، محدودية مشاركتها بعد ذلك في مجالات التأثير السياسي والاجتماعي بسبب احتدام الأعراف والتقاليد المنغلقة، وتمثيل القوانين في كثير من البلدان العربية امتداداً لهذه الثقافة السلطوية، حينما تصون ولاية الرجل على المرأة تحت شعارات حماية مزعومة لا تعدو أن تكون وسيلة لإدامة السيطرة.
وبنتيجة هذا البناء المعقد تتعزز المقاومة المجتمعية لأي نقاش حول تحرير المرأة من قيودها، حيث يتماهى هذا النقاش مع تهديد للقيم الاجتماعية التقليدية التي تُختزل في الشرف والطاعة، مما يحصر دور المرأة في وظائف ضيقة ذات أبعاد نمطية اجتماعية واقتصادية، بعيدة عن الإمكانات العقلية والقيادية.
وفي اليمن، حيث تحطمت عصبة التحديث على صخور المحافظة الريفية وقلة الخدمات الاجتماعية، تتقوى المؤسسات التقليدية كإطار مرجعي يُحتكم إليه في تحديد أدوار الأفراد وانتماءاتهم، مما يجعل المرأة أكثر فقرًا في الساحة الاجتماعية والسياسية، ومعزولة عن فضاءات القرار، وهدفًا للأحكام الذكورية المسيطرة التي تحاصر حقوقها بحجج دينية واجتماعية وثقافية.
إن الحالة اليمنية تعد نموذجًا صارخًا لتشابك عوامل التهميش والاضطهاد، حيث لا تزال المرأة أسيرة منظومة رجولية ترسخت عبر تحكمها في أسمائها ووجودها، وتشويه صورتها حتى في الثقافة والمجتمع المدني. وهو ما ينجم عنه انعكاسات سلبية على مسارات تعليمها، ومشاركتها السياسية والاقتصادية، وقدرتها على تشكيل قراراتها الشخصية ومستقبلها.
اقرأ أيضا: