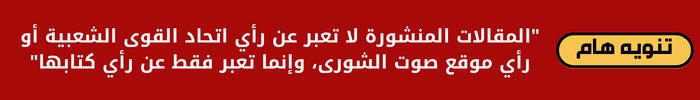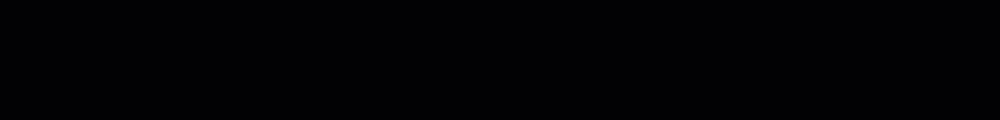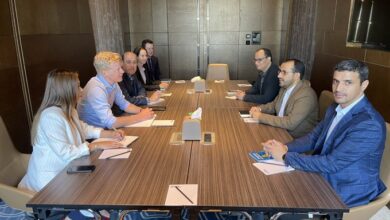ثورة 14 أكتوبر.. الخلفية المسار الاستقلال (5-1)

ثورة 14 أكتوبر.. الخلفية المسار الاستقلال (5-1)
ثورة 14 أكتوبر.. الخلفية المسار الاستقلال (5-1)

قادري أحمد حيدر
الأحد 5 أكتوبر 2025-
– بمناسبة الذكرى الثانية والستين لثورة الرابع عشر من أكتوبر 1963م، ثورة التحرير والاستقلال الوطني الكامل غير المنقوص أرضًا وسيادةً، نستحضر بكل فخر واعتزاز ملحمة النضال التي توّجت بتحقيق وحدة الجنوب في إطار دولة وطنية جنوبية يمنية واحدة مستقلة، ولأول مرة منذ قرون طويلة.
• ثورة 14 أكتوبر.. الخلفية المسار الاستقلال (5-1)
إن كل ما نكتبه في وحول التاريخ السياسي والاجتماعي، هي محاولات ذاتية (أيديولوجية/ سياسية)، لكتابة التاريخ، أو إعادة كتابته في سياق العملية التاريخية، ولا يدعي أحد أنه يقول فصل الخطاب فيما يكتبه، هي رؤية (وجهة نظر)، في هذه المرحلة أو تلك المطلوب فقط، ونحن نكتب عن ثورة 14 أكتوبر 1963م، أو غيرها، أن نلتزم الموضوعية، والتاريخية، وأنه “ينبغي أن نقيم ثورة أكتوبر في سيرتها عامة، وتطورها العام، لا الانطلاق من بعض الأخطاء التي حدثت”(1) كما هو شأن كل تجربة تاريخية إنسانية.
مفتتح صغير عن الدولة
“أبدأ الموضوع – البحث – بعبارة موجزة، وهي أن أزمة مفهوم وواقع” الدولة الحديثة”، من أنها إشكالية عربية، بل عالم ثالثية، وليست مشكلة يمنية.. أزمة ما تزال مستمرة الحضور حتى اللحظة، وليس ما يجري في أكثر من بلد عربي منذ أكثر من سبعة عقود، سوى تجسيداً ودليلاً على غياب المفهوم الحديث لمعنى “نظرية الدولة”، في تفكيرنا وسلوكنا، (ثقافتنا التاريخية)، وهي إشكالية سنجدها عند رواد النهضة العربية في قراءتهم لمسألة السلطة والدولة، “فقد تركز النقد النظري في الحقبة المعقدة من نهاية القرن التاسع عشر العهد الاستعماري على نموذج الدولة الأمبراطورية العثمانية أو المملوكية أو الإمامية”(2)، وليس نموذج السلطنات والإمارات والمشيخات في جنوب اليمن، والإمامة “القروسطية” في شمال اليمن، سوى النموذج الأكثر بؤساً.
حضرت السلطة وغابت الدولة، حتى ابتلعت السلطة – تدريجياً وتاريخياً- الدولة، وفككت وبنت المجتمع على مقاس مصالحها.
بقي خلالها الفكر السياسي اليمني- والعربي- بعد الثورة والجمهورية، وحتى اليوم – بدرجات متفاوتة- يشتغل ويتحرك ويفكر ضمن المفهوم السلطاني للسلطة والدولة، مع مكياج حديث خارجي حول شكل الدولة، وتصورات ذهنية/ أيديولوجية غير واضحة حول مفهوم” الدولة الحديثة”. ولذلك حملت تجربة الثورة اليمنية على جلال قدرها وعظمة دورها وانجازاتها، ذلك الأرث السلبي في داخلها حول معنى” بناء الدولة”، بعد أن تم اختزال مفهوم؛ الاستقلال والشرعية والسيادة والحرية في “الزعيم”، أو في الحزب “القائد للدولة والمجتمع”، كما في العديد من الدساتير والتجارب العربية، القومية واليسارية الاشتراكية، (3) وهنا يكمن جذر المشكلة في كل مسار التطور السياسي الاقتصادي الاجتماعي.
ومن هنا – كذلك- أزمة تكوين النظام السياسي، وبالنتيجة أزمة بناء الدولة، كما شهدتها تجاربنا السياسية العربية.
*- الاستعمار البريطاني ومشاريع تعويق الثورة في جنوب اليمن المحتل.
كان الاستعمار البريطاني يخاف من وحدة الجنوب اليمني، ناهيك عن وحدة الجنوب والشمال، ولذلك واجه مشروع “رابطة أبناء الجنوب العربي “، بقوة، وهي الرائدة لوحدة الجنوب السياسية في دولة وطنية جنوبية (4)”الجنوب العربي”، ولذلك سعى الاستعمار لتكريس تجزئة وانقسام الجنوب إلى أكثر من (23 سلطنة وإمارة ومشيخة، إضافة إلى عدن)، وهو سؤال يجيب عنه التاريخ السياسي الاستعماري في جنوب اليمن، وجاء” الميثاق الوطني” للجبهة القومية، 1965م، ليضيء نظرياً وسياسياً على هذا المعنى. (5)
إن المشاريع الفيدرالية الاستعمارية، هي محاولات لإطالة عمر بريطانيا في جنوب اليمن: من المشروع الفيدرالي، 1954م، إلى مشروع 1956م، إلى مشروع الاتحاد الفيدرالي، 11 فبراير 1959م، وجميعها مشاريع مؤامرة على وحدة الجنوب كدولة وطنية، تمنع نضوج وتبلور مشروع التغيير والثورة، وهناك مناقشة تفصيلية معمقة لهذه القضية (6).
وقد أضاءت “حركة القوميين العرب” على ذلك في كتيبها، “الاتحاد الفيدرالي مؤامرة على الوحدة العربية”(7) وجميعها مشاريع سياسية عسكرية اقتصادية لإنقاذ بريطانيا من أزمة وجودها في المنطقة والعالم بعد تصاعد مد حركة التحرر الوطني العربية والعالمية.
فالاتحاد الفيدرالي، فبراير 1959م، جاء حلاً لأزمة بريطانيا، وليس لعدن والمحمية الغريبة، “يعني الاتحاد هو أمل بريطانيا بالنسبة للمستقبل” (8)، كونه يعني الاستقلال الشكلي، مع بقاء المضمون السياسي، والاقتصادي، والعسكري الاستعماري، كما هو” الذي يتيح لبريطانيا والقوى الداخلية المتعاونة معها السيطرة على توجيه الأمور في البلاد بالشكل والطريق اللذين يخدمان مصالحه (9).
المشاريع الفيدرالية البريطانية جميعها، كانت تعني البداية التدرجية لانهيار النظام الاستعماري البريطاني، وتصاعد مد حركة التحرر الوطني العربية واليمنية، وهي تنازلات وهمية يقابلها صعود وطني واقعي للثورة في جنوب اليمن ومن مفارقات السياسة والتاريخ، أن “إعلان اتحاد الإمارات 1959م، ضربة قاضية لما تبقى من رابطة أبناء الجنوب” (10)، باعتبار شعارات وأهداف الرابطة السياسة في عمومها صارت متضمنة في المشروع الفيدرالي البريطاني 1959م. كانت بريطانيا وكأنها تسابق المستحيل الوطني في جنوب اليمن لتعويق مسار الثورة، لذلك سارعت بريطانيا “بتعيين كنيدي تريفاسكس، قبل شهرين ونصف من اعلان قيام ثورة 14 أكتوبر لشعور المستعمر بخطورة الآتي في جنوب اليمن” (11)، وجاءت المؤتمرات الدستورية اللندنية، 63-64-1965م، محاولات لتعويق فعل تيار حركة الثورة في الجنوب، وجميعها فشلت (12) أمام صمود إرادة الفعل السياسي الوطني التحرري، والفعل المسلح في سياق المؤتمرات الدستورية – اللندية، مما أدى إلى انقسام جبهة التحالف القريبة من الاستعمار وحتى المتحالف معه، بخروج بعض السلاطين وانسحابهم من المؤتمر الأخير (13) ، انذاراً بعهد سياسي وطني تحرري جديد سياسي، ومسلح.
إن المؤتمرات الدستورية هي آخر ورقة سياسية “لضمان ولاء جميع القوى السياسية التي لم تشارك في الكفاح المسلح والمؤيدة للمفاوضات” (14)، وها هي تسقط تحت إرادة صعود تيار التحرير والاستقلال.
*- من حركة القوميين العرب (اليمن) إلى تأسيس الجبهة القومية لتحرير الجنوب اليمني المحتل:
من المهم في البداية الإشارة بالتأكيد إلى أن حركة القوميين العرب في جنوب اليمن، وبعدها الجبهة القومية لتحرير الجنوب اليمني المحتل، هما سليلا إرث الكفاح السياسي الوطني الديمقراطي في جنوب البلاد، وحصيلة تراكم تلك النضالات والخبرات. (الانتفاضات الفلاحية والقبلية المسلحة)، هما استمرار تطوري تقدمي في التاريخ ضمن شروط ذاتية وموضوعية جديدة (اتصال وتواصل)، وليس قطيعة عدمية، كما تحاول بعض الكتابات “المتياسرة”، إقامة فصل وعملية قطع بين العمل السياسي، والكفاح المسلح، لا صلة لها بالكفاح ضد بريطانيا.
وبقدر ما هي سليلة ذلك الارث الوطني، هي امتداد لذلك التراث الفكري والسياسي القومي العربي.
حركة القوميين اليمنية، هي امتداد لحركة القوميين العرب المركزية التي نشأت من حيث الأساس كرد فعل على النكبة الفلسطينية 1948م، وحسب تعبير / رأي قسطنطين زريق: “ليست هزيمة العرب في فلسطين بالنكسة البسيطة، أو بالشر الهين العابر وإنما هي نكبة بكل ما في هذه الكلمة من معنى ومحنة” (15). بعد ذلك بسنوات ظهر اسم “حركة القوميين العرب” كتسمية مفتوحة منذ 1950م حتى طيلة سنوات الخمسينيات، وفي العام 1959م، نشأت حركة القوميين العرب في جنوب اليمن، من خلال فيصل عبداللطيف الشعبي (16) (وليس هنا مجال التفصيل السياسي التنظيمي التاريخي في ذلك). وكان أول تعبير أيديولوجي / سياسي عنها في اليمن هو كتيب، “اتحاد الإمارات المزيف مؤامرة على الوحدة العربية”، طرحت فيه الحركة رؤية فكرية سياسية ثقافية وطنية للقضية اليمنية، وطرق حلها مؤكدة: أولاً، على ضرورة وجود القاعدة / الإقليم في شمال اليمن كنقطة انطلاق للثورة في الجنوب المحاصرة من البحر بالاستعمار، وبالإمامة من البر؛ وثانياً، التأكيد القاطع على خيار الكفاح المسلح. وبذلك تكون الحركة أول من تحدث وطرح بوضوح مبدأ الكفاح المسلح، في زمن هيمنة وسيطرة خطاب النضال السياسي السلمي “التفاوض”، الذي كان رأس حربته عبدالله الأصنج – وجماعته-(17).
نشأت حركة القوميين العرب في ظل وجود احزاب سياسية وطنية فاعلة ومؤثرة في الساحة، تجاوزت سقف “الجمعية العدنية” (18) تحديداً، والتقت وافترقت مع أحزاب اخرى مثل حزب البعث، و”حزب الشعب الاشتراكي” (19)، والتجمع اليساري الماركسي، و”المؤتمر العمالي” (20) وجميعهم اختلفت الجبهة القومية معهم حول خيار الكفاح المسلح ، والتقت وتوحدت معهم – بعضهم – في الموقف من الوحدة اليمنية، تمكنت خلالها “الحركة” (*) من كسب رصيد سياسي وجماهيري واسعين في فترة زمنية قصيرة.
كانت حركة القوميين اليمنية مشوشة فكرياً، إن لم أقل متخلفة (21)، وتتحرك وتتطور في خضم تحديات كبيرة، أمام أحزاب وقوى سياسية أسبق زمنياً، وتحمل رؤى متقدمة على الرؤية الأيديولوجية القومية الشوفينية، بغطاء ديني، وجدت “الحركة”، نفسها متسربلة به وعالقة في جسمه الأيديولوجي العصبوي ، الذي تخلصت منه تدريجياً وبصعوبة في سياق مرحلة الكفاح السياسي والمسلح طيلة سنوات 1959م، 1965م.
كان فكرة قيام الجبهة القومية الواسعة تسيطر على فكر وعقل وسلوك قادة الحركة في جنوب البلاد، ذلك أن خيار الكفاح المسلح الذي حددته خياراً استراتيجياً لها، لا يمكن تحققه وانجازه إلا عبر جبهة وطنية/ قومية واسعة، وهو ما كان، وخاصة بعد قيام ثورة 26 سبتمبر 1962م.
الملاحظ، أن حركة القوميين العرب/ اليمنية، ظلت مصرة على تسمية الجبهة بــ”القومية” وليس “الوطنية”، وهو التعبير والأسم الأسلم والصحيح فكرياً وسياسياً ووطنياً، ومفهومياً، من مفردة “القومية”، ويبدو أن ذلك تم تحت ضغط “أيديولوجية النكبة”، وحركة القوميين العرب، وثورة مصر الوطنية في طابعها القومي التحرري.
كان هاجس وحدة القوى والتنظيمات السياسية في جبهة واحدة على قاعدة العمل المسلح، يشغل قادة “الحركة”، ولذلك انسحب من الجبهة ممثل حزب الشعب الاشتراكي، عيدروس القاضي، بسبب الموقف من الكفاح المسلح (22)، وهذا الاختلاف السياسي، عوضاً عن أن يكون عامل تنوع نحو الوحدة والتكامل، صار عامل صراع سياسي غطى وجه العلاقة بين الأطراف السياسية في جنوب اليمن حتى الاستقلال.
“بدأت الحركة الثورية في اليمن الجنوبي المحتل تتشكل في النصف الثاني من عام 1963م، تأخذ الثورة منحى أكثر جدية وصرامة (23)، كل ذلك بفعل قيام ثورة 26 سبتمبر 1962م، وهو مطلب “الحركة” كما جاء في وثيقتهم 1959م، “اتحاد الإمارات المزيف …”، وهو ما سرع بتشكيل الجبهة (24).
إن فكرة الوحدة في جبهة هي من بناة أفكار “الحركة اليمنية”.
قبل تشكيل الجبهة القومية، عقد في صيف عام 1963م عدد من قادة الحركة اجتماعاً تشاورياً في قرية (حارات/ الأعبوس)، حضره: 1-قحطان الشعبي، 2-فيصل عبداللطيف، 3-سلطان أحمد عمر، 4-علي أحمد السلامي، 5-طه مقبل، 6-سالم زين محمد، 7-نورالدين قاسم، 8-عبدالباري قاسم، 9-عبدالله لخامري، 10- محمد صالح مطيع، 11-عبدالرحمن محمد عمر، استمر اللقاء يوماً، وخرجوا بقرار الاستمرار في العمل الجبهوي على قاعدة الكفاح المسلح (25). أما الأحزاب والتنظيمات التي حضرت اجتماع تشكيل الجبهة القومية فهي:
1-حركة القوميين العرب، 2- الجبهة الناصرية، 3-المنظمة الثورية لجنوب اليمن المحتل، 4-الجبهة الوطنية، 5- التشكيل السري للضباط الأحرار، 6-جميعة الاصلاح اليافعية، 7- تشكيل القبائل (…)، وحين أعلنت الجبهة أنها ليست تنظيمياً حزبياً وأنها مفتوحة لكل من يؤمن بالكفاح المسلح التحق بها ثلاثة تنظيمات، وهي :1- منظمة الطلائع الثورية في عدن 2-منظمة المهرة، 3-المنظمة الثورية لشباب الجنوب اليمني المحتل”(26) .
هنا ظهرت – تدريجياً – الجبهة القومية وبقوة من أنها الأكثر حضوراً في معظم مناطق البلاد، معلنة بداية الكفاح المسلح بصورة رسمية وعلنية .
تشكلت الجبهة على مرحلتين في صنعاء، الأولى: “في 24شباط / فبراير 1963م، في “دار السعادة”، حيث عقد مؤتمر حضره (100) ممثل (…)، وضع مسودة ميثاق مؤقت (…)، أثر الرأي على تسمية “جبهة تحرير الجنوب اليمني المحتل”، ضم المكتب السياسي (11 شخصاً) (27). المرحلة الثانية: “اجتماع 19 آب/ أغسطس 1963م، بدعم من مصر، من سبعة تنظيمات ثم انضم لها ثلاثة تنظيمات أخرى (28).
ومن هنا انطلقت “الجبهة القومية لتحرير الجنوب اليمني المحتل”, في ممارسة جميع أشكال النضال: النضال السياسي، والكفاح المسلح.
الهوامش:
(1)-أحمد حبيب : مجلة الثقافة الجديدة، وزارة الثقافة والسياحة / عدن، وفمبر – ديسمبر 1981م، لسنة العاشرة، 14.
(2)- برهان غليون: أزمة الدولة العربية، التراث والواقع، مجلة الثقافة الجديدة، وزارة الثقافة والسياحة / عدن، العدد (الثالث)، يونيو، 1992م، السنة الثانية والعشرين ، ص91.
(3)-أنظر دستور جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، حيث الدستور ينص على أن الحزب هو القائد “للدولة والمجتمع”، وقد حدد بيان الجبهة القومية دور ومكانة الجبهة: أنها “قائدة الثورة” و”السلطة العليا”، وعليه فإن الجبهة القومية، باعتبار نفسها جهاز السلطة المباشر، وقد وضعت علاقة مساواة بدرجة معينة بين التنظيم السياسي وسلطة الدولة، الأمر الذي كان له ما يبرره في تلك الظروف” فيتالي ناؤومكين: الجبهة القومية في الكفاح من أجل استقلال اليمن الجنوبية، والديمقراطية الوطنية، دار التقدم موسكو ، ت. سليم توما، 1984م، ص 214.
(4)-رابطة أبناء الجنوب العربي تشكلت عام1950م، وبعض المصادر 1951م، حاملة راية وحدة الجنوب تحت شعار “الجنوب العربي”، وكان من بين مؤسسي الرابطة إلى جانب الأسماء المعروفة، عبدالله باذيب. أنظر علي الصراف: (اليمن الجنوبي، الحياة السياسية من بريطانيا، إلى الوحدة)، رياض الريس للكتب والنشر – لندن- قبرص، ط(1)، 1992م، ص86، أنظر كذلك فتحي عبدالفتاح: تجربة الثورة في اليمن الديمقراطي، دار ابن خلدون / بيروت ، ص30-31، أنظر كذلك ناؤومكين: مرجع سابق، ص43، أنظر كذلك، سعيد الجناحي: ممهدات الثورة اليمنية، سبتمبر أكتوبر، وانطلاقتها، ط(2)، 2022م، مركز الأمل للبحوث والدراسات التاريخية والاجتماعية. ص448-449-450، حتى وصول الرابطة إلى تقديم مذكرة توافق فيها على بقاء القاعدة البريطانية في عدن بالإيجار” وقدم المذكرة شيخان الحبشي، أمين عام الرابطة بتاريخ 21/4/1964م”، أنظر فتحي عبدالفتاح : “مرجع سابق”، ص70، هامش رقم (1). إن رابطة أبناء الجنوب تشبه حزب الوفد المصري من بعض الوجوه: “لقد كان حزب الوفد في نشأته الأولى يضم الباشوات والأقطاعيين” فتحي عبدالفتاح: نفس المرجع”، ص32.
(5)-الجبهة القومية لتحرير الجنوب اليمني المحتل: (الميثاق الوطني)، ص7-6، دون تاريخ ، ومكان النشر.
(6)- محمود علي محسن السالمي: اتحاد الجنوب العربي: خلفية وأبعاد محاولة توحيد المحميات البريطانية في جنوب اليمن وأسباب فشلها- 1945-1967م، ط(1)، 2010م، رسالة دكتواره، دار الوفاق للدراسات والنشر / عدن، ص122-151.
(7)-حركة القوميين العرب : اتحاد الإمارات المزيف مؤامرة على الوحدة العربية: انظر ملاحق كتاب، محمد جمال باروت: حركة القوميين العرب، النشأة التطور المصائر، المركز العربي للدراسات الاستراتيجية، بإشراف الرئيس علي ناصر ناصر محمد، ط(1)، 1997م، دمشق، ص532-541.
(8)-أنظر حول ذلك: ثورة أكتوبر في الدراسات الأجنبية، ت، حامد جامع، عبدالكريم الحنكي)، سبتمبر 2003م. المركز العربي للدراسات الاستراتيجية/ العدد (13)، المركز، سوريا ص34.
(9)- فتحي عبدالفتاح: نفس المرجع، ص39.
(10)- فتحي عبدالفتاح: نفس المرجع، ص40.
(11)-أنظر حامد جامع- عبدالكريم الحنكي، مرجع سابق ص5-6.
(12)-حول المؤتمرات الدستورية ، أنظر قادري أحمد حيدر: الصراع السياسي في مجرى الثورة اليمنية وقضية بناء الدولة، 1962- 1963مـ إلى 1990م، مركز الدراسات والبحوث اليمني/ صنعاء، ط(1)، 2018م، ، ص235-239؛ أنظر كذلك إسماعيل قحطان: حركة القوميين العرب ودورها في ثورتي سبتمبر وأكتوبر في اليمن (1959-1967م)، ط(1)، 2020م، مؤسسة يسطرون للطباعة والنشر والتوزيع، ص174.
(13)-خروج السلطان أحمد الفضلي وزير الإعلام في الحكومة الإتحادية، من المؤتمر الدستوري “كان بمثابة قنبلة سياسية” غادر إلى القاهرة معلناً أنه أنضم إلى الكفاح المسلح” كرد فعل ، أنظر ناؤومكين: (مرجع سابق)، ص97.
(14)- إسماعيل قحطان : مرجع سابق، ص174.
(15)-قسطنطين زريق: معنى النكبة المجلد الأولى، الأعمال الكاملة العامة، مركز دراسات الوحدة العربية، مؤسسة عبدالحميد شومان، ط(3)، 2001م، ، ص11، وفي كتابه “الوعي القومي”، إشارة إلى هذا المعنى. أنظر كذلك هاني الهندي: حيث يناقش تيار الوعي العروبي القومي في صورة تحولاته في المنطقة العربية، (مصر، سوريا، فلسطين، لبنات، الأردن، العراق، حتى اليمن والخليج)، وصولاً إلى حركة القوميين العرب، كفكرة وتنظيم، بدأ تشكله من خلال جورج، حبش الذي ترأس “الهيئة العامة للعروة الوثقي” والذي تمكن من تجنيد العشرات من طلاب اليمن والسعودية والخليج، (…)، وكانت اليمن ساحة تنظيمية واحدة (شمال وجنوب)، دون أن يشير إلى تاريخ تشكل حركة القوميين العرب، ولا إلى تاريخ تشكل حركة القوميين العرب، في اليمن، أنظر هاني الهندي: الحركة القومية العربية في القرن العشرين، (دراسة سياسية)، ط(1)، فبراير 2021م، مركز دراسات الوحدة العربية/ بيروت ، ص434+480 إلى ص483، وكذلك باسل الكبيسي: لم يشر بالتحديد إلى تاريخ تأسيس حركة القوميين العرب المركزية، ولا إلى تاريخ نشأة حركة القوميين اليمنية، فهو في خلاصة كتابه يكتب التالي: كانت “حركة القوميين العرب” إحدى التيارات الرئيسية في الحركة العربية القومية (…) وقد جاء نشوء “الحركة” في أوائل الخمسينيات تجديداً لمفاهيم ومثل الجيل السابق”. باسل الكبيسي: حركة القوميين العرب، تعريب: نادرة الخضيري الكبيسي: ط(4)، مؤسسة الأبحاث العربية / بيروت، ص151.
(16)- محمد جمال باروت: مرجع سابق، ص355 ، وسلطان أحمد عمر هو مؤسس الحركة في الشمال ، أنظر. ناؤومكين: مرجع سابق، 82.
(17)كانت جميع الأحزاب السياسية: البعث، وحزب الشعب الأشتراكي، والرابطة والسلاطين من المعارضين لخيار الكفاح ، وكان عبدالله الأصنج الأمين العام للمؤتمر العمالي، وزعيم حزب الشعب الاشتراكي من أشد المعارضين لنهج الكفاح المسلح، ودون كتباً ومقالات في هذا الاتجاه.
(18)-“الجمعية العدنية”، هي ثاني تنظيم سياسي يوجد بعد “الجمعية الإسلامية” :تأسست عام 1949م، “وجدت الجمعية العدنية في مواجهة نشاط الجمعية الإسلامية”، ناؤومكين : مرجع سابق، ص.39
(19)- حزب الشعب الإشتراكي، وهو “أهم المنظمات لا في عدن، فحسب، بل في الجزيرة العربية بوجه عام محمد عمر الحبشي: اليمن الجنوبي، سياسيا واقتصادياً واجتماعياً منذ 1937م، وحتى قيام “جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية”، نوفمبر 1967م. رسالة دكتواره ، ت، د. خليل أحمد خليل، دار الطليعة للطباعة والنشر / بيروت ، ط(1)، 1968م، ص117، وهو تنظيم سياسي جماهيري وطني بهوية يمنية، تأسس في يونيو 1962م، “كرديف سياسي للحركة العمالية، وضد القوانين الاستعمارية الجائرة” ناؤومكين: مرجع سابق، ص57-58.
(*)نجمة: عوضا عن ايراد اسم حركة القوميين العرب اليمنية، للاختصار أوردها بــ”الحركة” أو “الحركة اليمنية”، لتعني “حركة القوميين العرب ” اليمنية.
(20)-المؤتمر العمالي، تأسس في 3مارس 1956م، “من أكثر من (20) نقابة برئاس..