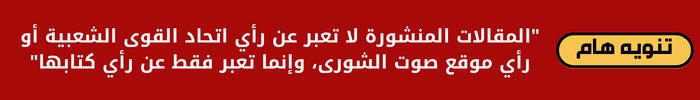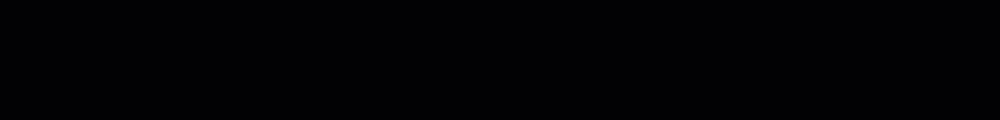الزيدية التي ألهمت علي الوردي: منهج العقل والثورة على الظلم
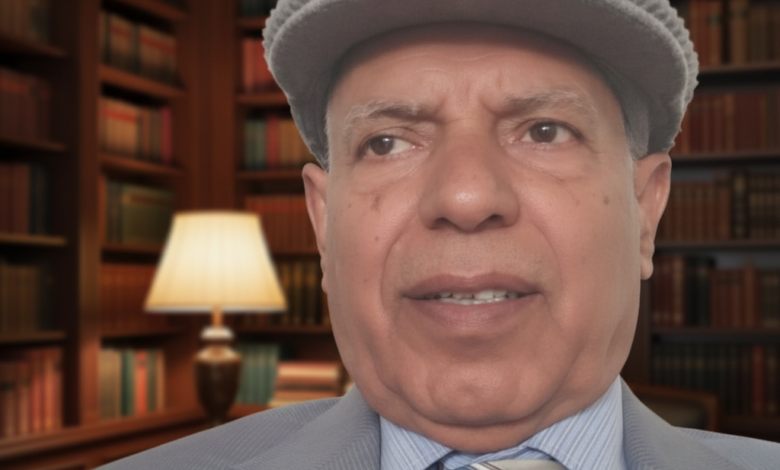
الزيدية التي ألهمت علي الوردي: منهج العقل والثورة على الظلم
- بقلم: حسن الدولة
السبت 11 أكتوبر 2025-
أعادني مقال للكاتب سليمان رشيد الهلالي، حمل عنوان «لماذا تحوّل علي الوردي إلى المذهب الزيدي؟»، والذي أعاد نشره السفير فيصل أمين أبوراس، إلى واحدة من أكثر المسائل الفكرية التي تستحق إعادة النظر، لا من باب الدفاع عن مذهب، ولا من باب الانتصار لطائفة، بل رغبةً في إحياء صورة الزيدية الأصل كما فهمها عالم الاجتماع العراقي “علي الوردي”، لا كما تُقدَّم اليوم في قوالب مشوَّهة حُجِبت فيها الروح العقلانية والثورية للمذهب.
فالزيدية، في أصلها الأصيل، ليست مذهبًا فقهيًا جامدا، بل مشروعا فكريا وأخلاقيا يقوم على ثلاثية كبرى: العقل، والعدل، والثورة على الظلم. ما جذب علي الوردي إليها لم يكن طقوسًا ولا شعائر، وإنما رؤية إنسانية تعلي من شأن الحرية، وترفض الاستبداد، وتجعل من الإمامة مسؤولية لا وراثة، وتكليفا لا تشريفا. لقد وجد الوردي في الزيدية صوتًا ينحاز للمظلوم، لا سلطة تحتمي بالنصوص من أجل تثبيت الحاكم.
لقد تبنّى الوردي زيدية العقل، تلك التي قال عنها الإمام القاسم بن إبراهيم: «لقد احتجّ الله على العباد بثلاث حجج: حجة العقل، وحجة الكتاب، وحجة الرسول»، مقدمًا العقل لأنه الباب الذي منه فُهم الكتاب والنبوة. فالعقل في الزيدية ليس تابعا، بل أصل يحتكم إليه عند الخلاف، والحجة التي تمنع الدين من أن يتحوّل إلى تقليد أعمى أو طاعة بلا ضمير.، فإذا كان العقل هو من زكى الشرع فأن الشرع المزكى -برفع الميم وفتح الكاف- يكون تابعا للمزكي له -بكسر الكاف- اي ان المزكي -الشرع- لا يرد المزكي له وهو العقل.
لم تربط الزيدية الإمامة بالنسب، ولا جعلتها حكرا على القرابة، بل اشترطت لها القدرة على مواجهة الظلم والوقوف مع المظلوم. فالإمام عندهم ليس ساكنا في قصر أو داخل سرداب، بل ثائرا في وجه الجور، مستعدا للتضحية في سبيل العدل. ولهذا وجد الوردي فيها مدرسة للعدالة الاجتماعية قبل أن تكون مذهبًا عقديًا، ومخرجًا من الطائفية التي مزّقت النسيج العراقي.
وقد اتخذت الزيدية موقفا فريدا من تاريخ الصحابة، فهي ترضى عن أبي بكر وعمر، وتسكت عن عثمان لما وقع في أواخر خلافته، لكنها تدين – دون مجاملة – من سفك دماء آل البيت، وعلى رأسهم يزيد بن معاوية قاتل الحسين بن علي، لا بدافع الحقد، بل بدافع الميزان الأخلاقي الذي لا يساوم في الدم والكرامة. هذه الوسطية هي ما جعل الوردي يرى في الزيدية جسرا بين الصحبة والقرابة، لا جدارا بينهما، كما قال الإمام زيد: «من فرّق بينهما فقد ضلّ».
أما في السياسة، فقد سبقت الزيدية غيرها حين وضعت أربعة عشر شرطًا للإمامة، يكفي منها شرطٌ واحدٌ لوحده ليجعلها مدرسة إنسانية استثنائية: أن لا يتميز الإمام عن الرعية في المأكل أو الملبس أو المسكن. فالحاكم في الفكر الزيدي ليس سيّدًا على الناس، بل واحدًا منهم، يخضع لما يخضعون له، ويُحاسَب كما يُحاسَبون. ولو كُتبت هذه الشروط اليوم لدُهش العالم، كيف سبق فكرٌ إسلامي قرونًا من التنظير السياسي المعاصر.
غير أن ما يُعرف اليوم بالزيدية اليوم فقد تحولوا بعكس تحول عالم الاجتماع “علي الوردي” اي ابتعدوا كثيرًا عن هذه المبادئ. لقد جرى «جعفرة الزيدية» وتذويب روحها العقلية والثورية، فتحوّلت إلى طقوس، وتخلّت عن الثورة، واستبدلت العقل بالنقل. وهذه الزيدية المُصنّعة لا تمتّ بصلة إلى تلك التي ألهمت الوردي، زيدية زيد الشهيد، زيدية الخروج على الظالم والتمرد على السلاطين.
لم يكن علي الوردي يبحث عن طائفة جديدة، بل عن منهجٍ يُنصف الإنسان، ويحرّر الدين من التعصب والانغلاق. رأى في الزيدية إمكانية لولادة مشروع إصلاحي يُعيد للإسلام ضميره الأخلاقي، ويجمع بين العقل والاجتهاد، بين النص والواقع، بين حب الصحابة ومودة أهل البيت، دون غلوّ أو لعن طائفي.
لذلك، فإن الحاجة اليوم ليست في استعادة اسم الزيدية، بل روحها. ليست في العودة إلى الماضي، بل في استلهام جوهر تلك المدرسة التي رفعت شعارًا خالدًا:
العقل قبل التقليد، العدل قبل الأشخاص، والثورة قبل الخضوع.
هذه هي الزيدية التي ألهمت علي الوردي، لا مذهبًا مغلقًا، بل ضميرًا حيًا، ودعوةً لإصلاح الإنسان والدولة، وإعادة الدين إلى ساحات العدل لا ميادين الصراع.
اقرأ أيضا للكاتب:بين تبعية الجغرافيا واستقلال القرار اليمني