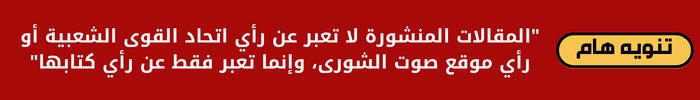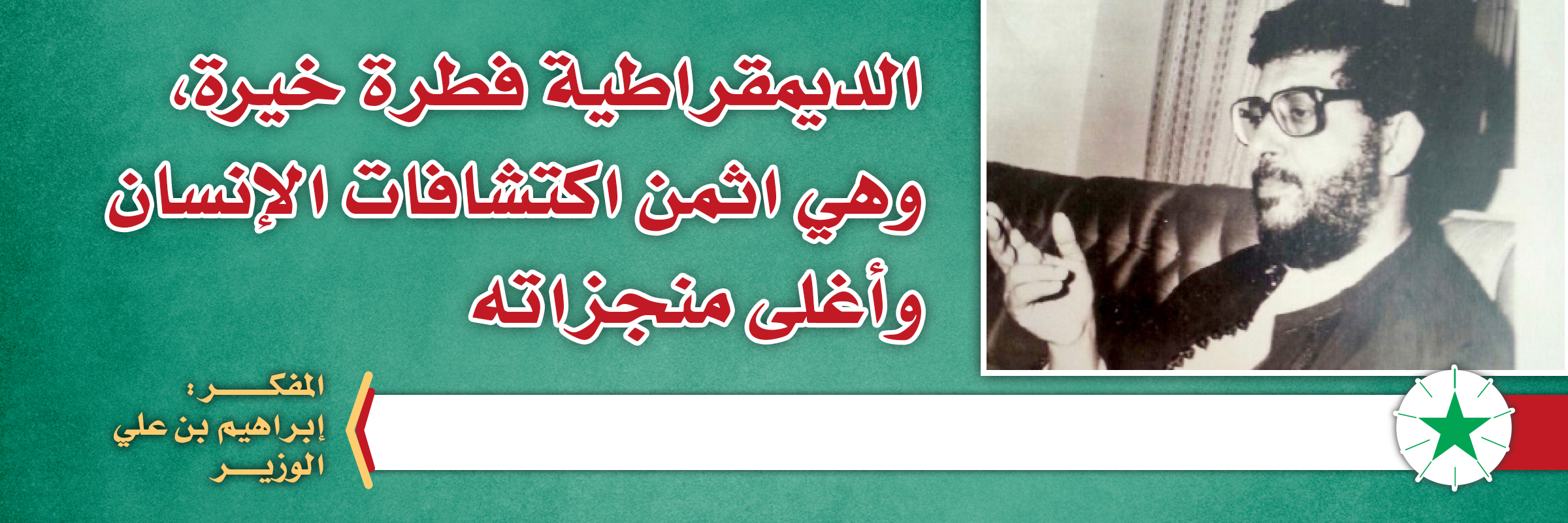حركة ٤٨ في ميزان التاريخ

حركة ٤٨ في ميزان التاريخ
- أمين الجبر
الثلاثاء 25 نوفمبر 2025-
تشكل حركة 1948 في اليمن نموذجاً دالاً على تعددية القراءات التاريخية وتنوعها، مما يدحض المقولة الشائعة بأن التاريخ يكتبه المنتصرون فحسب. فالحقيقة التاريخية تتجاوز هذا التبسيط المخل، لتؤكد أن التاريخ حصيلة تفاعل جماعي، تشكل ملامحه قوى متعددة، ليبرز في النهاية كمنتج مركب يحتمل تأويلات متباينة.
لقد تجلت هذه التعددية التأويلية بوضوح في الدراسات الأكاديمية التي تناولت حركة 1948، حيث تنوعت المقاربات تبعاً لتنوع الرؤى والمنطلقات الأيديولوجية. فمن القراءات الرسمية الحزبية إلى القراءات الأيديولوجية الملتزمة، مروراً بالقراءات الانطباعية والعاطفية المتحيزة، تبقى القراءة التاريخية الموضوعية شحيحة، إن لم تكن نادرة، جاءت في معظم الأحيان ضمن سياقات عارضة أو إشارات ضمنية.
وإذا كان التاريخ اليمني الرسمي في معظم مراحله الحديثة والمعاصرة قد صيغ بأقلام المنتصرين، فإنه يتسم في طابعه العام بالطابع المناسباتي المقدس، الذي يحيل الحدث التاريخي إلى معطى جهادي، أو يصوغه كنتاج لقدسية النص الديني، أو يحوله إلى مغالبة قيمية تفرضها سلطة حاكمة. وهكذا يتحول المنتصر في السرد الرسمي إلى بطل منزه أو كهنوت مقدس، بينما يتحول المهزوم إلى تجسيد للشر المطلق والباطل المحض.
وقد مارست السلطة الإمامية المنتصرة آنذاك هذا النمط من القراءات المنحازة، حيث قدمت حركة 1948 كمؤامرة خبيثة، ووصفت رجالها بالمجرمين والخونة، وجعلت انتصار الإمام أحمد عليها دليلاً على رعاية السماء ومشيئة القدر. وهذه القراءة تبقى أسيرة اللحظة التاريخية التي تشكلت فيها، وخاضعة لشروط زمانها ومكانها، مما يستدعي النقد والتمحيص قبل القبول بها.
في المقابل، تقدم القراءة غير الرسمية صورة مثالية للحركة، تتصف بالحماس العاطفي والنزوع الدرامي، فتصورها كنقطة فاصلة في التاريخ اليمني، أو فرصة تاريخية ضائعة كان يمكن أن تقلب واقع اليمن من الجحيم إلى الفردوس. وهذه القراءة رغم ما تحمله من مشروعية أخلاقية، تبقى مقصرة في مراعاة الواقع الموضوعي للحركة وظروفها التاريخية.
وبين هذين الطرفين، تبرز قراءة ثالثة تسعى إلى الموضوعية والحياد، لا تشيطن ولا تُمجّد، لا تقوّل ولا تدعي، بل تلتزم بالمنهجية الوصفية التحليلية وفق الإمكانات المتاحة. هذه القراءة تنطلق من حقيقة أن حركة 1948 كانت تمثل محصلة لتراكمات تاريخية وإرهاصات فكرية متعاقبة، حتى غدت حدثاً فارقاً في المسار التاريخي اليمني المعاصر.
لقد تشكلت الجذور الفكرية للحركة من خلال تفاعل عدة روافد، بدءاً من ظهور النخبة المثقفة (الانتلجنسيا) التي شكلت طليعة الإصلاح، مروراً بنشاط الجمعيات والمنتديات السرية كهيئة النضال وجمعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووصولاً إلى تأسيس الأحزاب والجمعيات كحزب الأحرار والجمعية اليمانية الكبرى.
ويمكن تتبع البدايات الفكرية للمعارضة إلى مرحلة مبكرة تعود إلى بيعة الإمام يحيى عام 1904، حيث برزت معارضة فقهية تستند إلى المذهب الهادوي في رفض مسألة التوريث، كما تمثلت الحركة امتداداً للمدرسة اليمنية الإصلاحية التي أسسها أعلام كابن الوزير وابن الأمير والشوكاني.
وتجلى المشروع الفكري الإصلاحي للأحرار من خلال عدة محطات مهمة، كان أبرزها:
· برنامج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
· البرنامج التعليمي الإصلاحي الذي تبناه أحمد المطاع
· إصدار مجلة “الحكمة” التي مثلت منبراً للإصلاح
· نشاط هيئة النضال ونادي الإصلاح الأدبي
· تأسيس حزب الأحرار والجمعية اليمانية الكبرى
وقد بلور الميثاق الوطني ومطالب الأحرار التي نشرتها صحيفة “صوت اليمن” الرؤية الفكرية والسياسية المتكاملة للحركة، التي تمحورت حول إقامة مملكة دستورية، وجعل الزكاة أمانة، وإصلاح النظام التعليمي، وتبني أفكار التحديث والاستنارة.
ويبقى الفشل في تحقيق هذه الأهداف محل اختلاف بين القراءات التاريخية، لكن يمكن إرجاعه -من وجهة نظر موضوعية- إلى تقدّم الأفكار الدستورية على الواقع المجتمعي التقليدي، وصعوبة استيعاب الثقافة السياسية السائدة آنذاك لمفاهيم الحكم الدستوري.
وتظل الكتابات التي صاغها رجال الحركة أنفسهم هي الأقرب إلى الموضوعية، كونها تمثل التعبير الأصيل عن رؤيتهم ومراميهم، وتكشف -بصدق- عن إنجازاتهم وإخفاقاتهم.
ختاماً، تبقى حركة 1948 حدثاً تأويلياً بامتياز، تتداخل فيه القراءات وتتعدد فيه الرؤى، مما يجعلها نموذجاً حياً لتعقيد الكتابة التاريخية وتشابكها مع الأيديولوجيا والسلطة والذاكرة الجمعية.