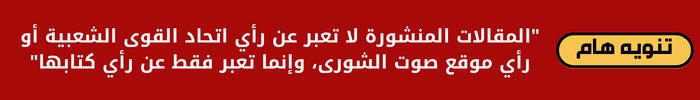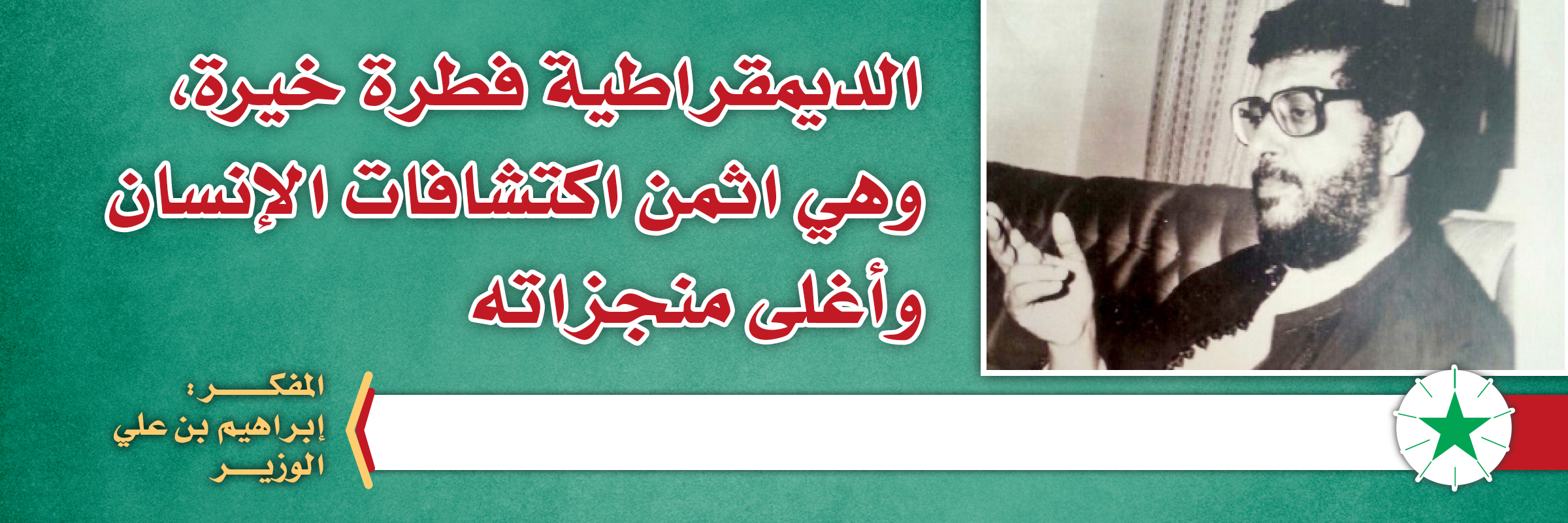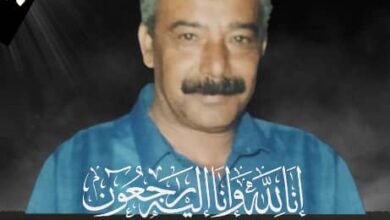اللامركزية في اليمن عبر التاريخ

اللامركزية في اليمن عبر التاريخ
- احمد سليم الوزير
الجمعة23مايو2024_
لم تكن اللامركزية في اليمن مجرد خيار إداري، بل كانت، في كثير من مراحل التاريخ، واقعًا اجتماعيًا وسياسيًا فرضه التكوين البنيوي للمجتمع اليمني. فاليمن بلدٌ قبلي بطبيعته، تقوم وحداته الاجتماعية الكبرى على القبيلة، التي تمتلك منظومة أعراف وقوانين خاصة بها، وتشكل كيانًا شبه مستقل في إدارة شؤونه الداخلية.
لكل قبيلة مواردها واحتياجاتها، وتُدار شؤونها عبر نظام العُرف القبلي، الذي يعادل في كثير من الأحيان سلطة الدولة، بل ويتجاوزها من حيث النفاذ والالتزام. وإلى جانب ذلك، يقوم نظام الغُرم، وهو نوع من التكافل القبلي، بدور محوري في مواجهة التحديات العامة كالدِّيات، الحروب، أو الكوارث، حيث يساهم أفراد القبيلة أو التحالف القبلي في تغطية التكاليف بشكل جماعي ومنظم.
ولم تكن القبيلة وحدة منعزلة، بل كانت جزءًا من بنية أكبر تُعرف بـ”الداعي”، وهو حلف يجمع عدداً من القبائل المتقاربة جغرافيًا أو سياسيًا، ويشكل نوعًا من الفيدرالية التقليدية، تتخذ قراراتها بالتوافق، وتُنفذ ضمن منظومة العُرف والمصالح المشتركة.
وإذا انتقلنا إلى مسألة الزكاة في الفقه الزيدي، الذي حكم معظم مناطق اليمن الشمالية، نجد أن الزكاة تُصرف في الأماكن التي جُبيت منها، على خلاف كثير من المذاهب التي ترى أن الزكاة تُجمع في المركز، ثم تُوزع وفق رؤية السلطة المركزية. وهذا يعكس روح اللامركزية حتى في إدارة الموارد الشرعية.
وقد تجلى هذا النهج في نماذج إدارية محلية ظهرت خلال فترات الحكم المركزي. ففي لواء تعز خلال العهد المتوكلي، طبق الأمير علي بن عبدالله الوزير نظامًا إداريًا سُمي آنذاك بـ”نظام الأمين”، بحيث ترشّح كل قرية أمينًا عنها يتولى شؤونها المحلية، كجمع الزكاة وتوزيعها، وحل النزاعات، ومخاطبة المركز بالتقارير اللازمة. وقد همّش هذا النظام دور المشايخ التقليديين، وكرّس نوعًا من الإدارة الذاتية المنظمة، مع احتفاظ المركز بدور إشرافي محدود.
هذا الواقع التاريخي أفرز نمطًا لامركزيًا مميزًا للحكم في اليمن، حتى في فترات وجود الدولة المركزية، كالدولة الزيدية أو المتوكلية أو في عهد الأئمة، حيث كانت الدولة كثيرًا ما تلجأ إلى التفاوض مع القوى القبلية، وتكتفي بهامش من السيادة الشكلية، مقابل احتفاظ القبائل بإدارة شؤونها الذاتية.
وانطلاقًا من هذا الإرث التاريخي، فإن النظام اللامركزي الحديث ليس غريبًا على المجتمع اليمني، بل يتناغم مع تركيبته الاجتماعية وموروثه السياسي. وفي حال مُنحت المديريات صلاحيات حقيقية في إطار حكم لا مركزي، فإن المواطنين سيساهمون في تطوير مناطقهم وتلبية احتياجاتهم، وستُنجز المعاملات بسهولة، وسيتراجع التكدس الإداري في المركز، مما يقلل من البيروقراطية والفساد.
وهكذا، فإن اللامركزية في اليمن ليست نظامًا مستوردًا، بل هي امتداد طبيعي لهوية سياسية واجتماعية راسخة، تجذّرت بفعل التضاريس الجغرافية، واستقلالية القبائل، وضعف تقاليد الحكم المركزي.
اقرأ أيضا للكاتب:ثبات الموقف وتوازن السياسة