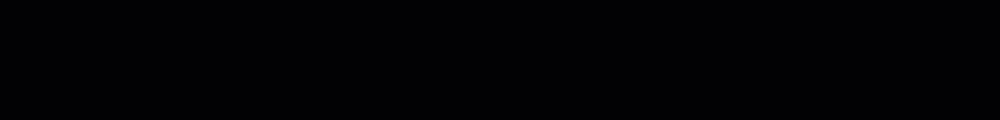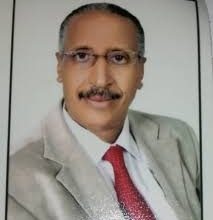مجرد تأمل.. العبيد لا يصنعون حرية.. والجهلاء لا يبنون مجدًا

مجرد تأمل.. العبيد لا يصنعون حرية.. والجهلاء لا يبنون مجدًا
- أمين الجبر
السبت26يوليو2025_
ثمة سؤال استهلالي طرحه الكثير من الفلاسفة والمفكرين على مر العصور مفاده: “لماذا تفشل بعض الثورات في تحقيق حريتها؟ ولماذا تنهار أمم كانت عظيمة؟”. لربما قد تكون الإجابة الموضوعية في هذه العبارة الجارحة التي تضع أصابعها على الجرح: العبيد لا يصنعون حرية، كما أن الجهلاء لا يبنون مجدًا. فهي ليست مجرد حكمة أو عبارة مزاجية/ إنطباعية طارئة، بل قانون تاريخي وفلسفي يربط بين حالة الذات الإنسانية وإمكانية البناء الحضاري. فكيف نفكك هذا الترابط بين العبودية الداخلية والجهل من جهة، وبين فشل المشاريع التحررية والحضارية من جهة أخرى؟.
الحرية ليست مجرد إزالة قيود خارجية، بل هي تحرير العقل أولًا من كل خرافة ووهم ميتافيزيقي كما رأى كانط. فالعبودية هنا قد تكون:
إما استلابًا نفسيًا: كالخوف الموروث، أو الاعتقاد بعدم الجدارة بالحرية، أو تطبيعًا مع القهر: كما يصفه ماركوزه في “الإنسان ذو البعد الواحد”، حيث يصبح المضطهدون شركاء في نظام اضطهادهم عبر قبوله كحتمية.
فإذا ما قام عبد (بالمعنى المجازي) بثورة، فغالبًا ما سيسقط في تناقضين:
إما أن يكرس نفس منطق القمع الذي ثار ضده (كما حدث في بعض الثورات التي تحوّلت إلى أنظمة استبدادية)، أو أن يحرّر الآخرين من سلطة بينما يبقيهم أسرى لسلطته هو.
يقول إريك فروم: “من لم يختبر الحرية داخله، لا يستطيع منحها للعالم.”
المجد الحضاري لا يبنى بالقوة المادية فقط، بل بالمعرفة والإرادة الواعية، وهذا ما تدركه فلسفة التاريخ من ابن خلدون إلى توينبي؛ حيث تقول: إن الجهل يفرغ البناء من مضمونه حتى لو ظهرت الأمم عسكريًا أو اقتصاديًا، فغياب المعرفة يجعلها عملاقًا على قدمين من طين (كما في سقوط الإمبراطوريات التي أهملت التعليم)، كما أن الجهل بالتاريخ يكرر أخطاءه؛ إذ المجد الحقيقي يحتاج إلى وعي بالذات وبقوانين التقدم، وإلا يصبح البناء هشًا كقصور الرمال.
ما أنجزته أوروبا الحديثة لم يكن بفضل القوة فقط، بل بفضل ثورة فكرية (ديكارت، كانط، روسو، الخ.) سبقت الثورة الصناعية. بينما مجتمعات أخرى حاولت تقليد النموذج الأوروبي دون أسسه الفكرية ففشلت.
هنا يبرز سؤال فلسفي عميق: أيهما شرط للآخر: الحرية أم المعرفة؟ ، حيث المعرفة طريق إلى الحرية (كما في مقولة سقراط: “الفضيلة معرفة”)، والحرية شرط لاكتساب المعرفة (فلا ابتكار دون حرية فكر).
لكن العبارة الأصلية تظهر أن الاثنين متلازمان، وأن انهيار أحدهما يؤدي إلى انهيار الآخر، وهو ما يفسر فشل العديد من المشاريع الإصلاحية.
على أية حال العبارة ليست تشاؤمية، بل تحمل بذرة الأمل؛ فإذا ما أردنا حرية حقيقية، فلنبدأ بتحرير أنفسنا من عبودية الخوف والجهل. وإذا أردنا مجدًا، فلنعلّم العقول قبل أن نرفع الجدران. فهذا هو الدرس الأكبر الذي تقدمه الفلسفة لا يبنى العالم الخارجي إلا بإعادة بناء العالم الداخلي أولا..
فيا ترى هل يمكن لمجتمع أن يتحرر بقيادة أحرار منفردين؟ ، وكيف لنا أن نُحدّد الجهل في عصر المعلومات حيث المعرفة متاحة لكن الحكمة غائبة؟ .
هذه الأسئلة، من وجهة نظرنا، تُبقي النقاش مفتوحًا، لأن العبارة الآنفة الذكر— ككل فكرة فلسفية عميقة — ليست إجابة بل منطلقًا للتأمل.