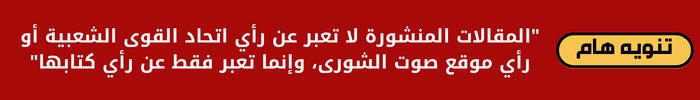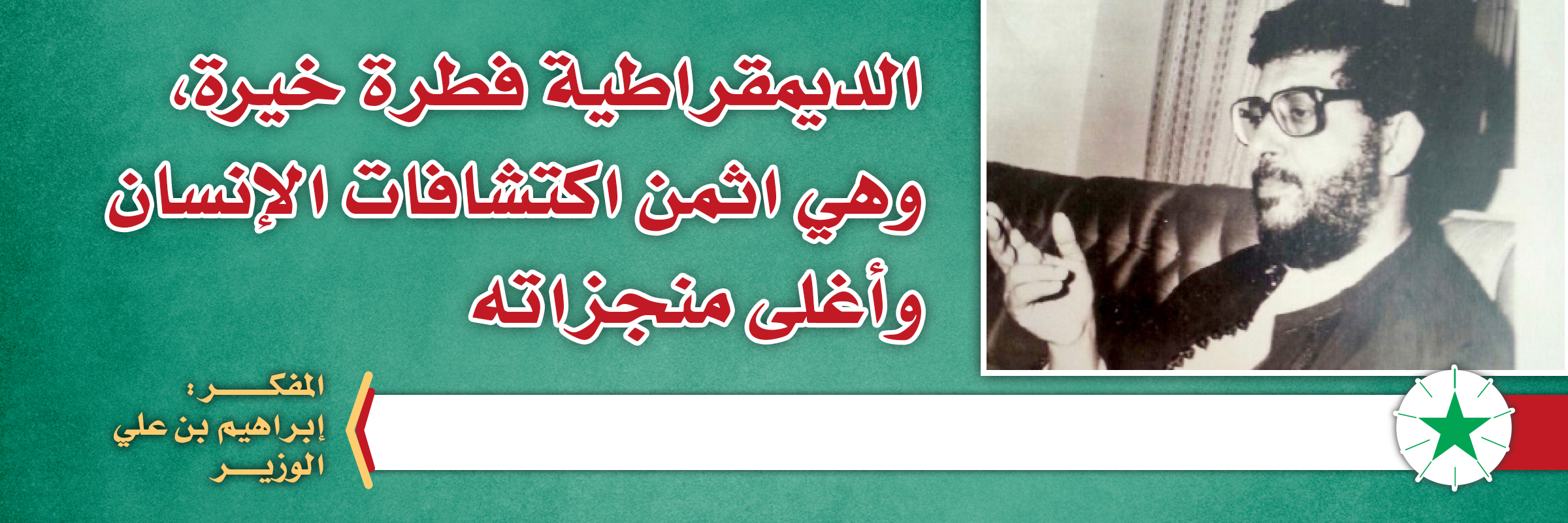العلمانية: جسر التعايش بين الدين والسياسة
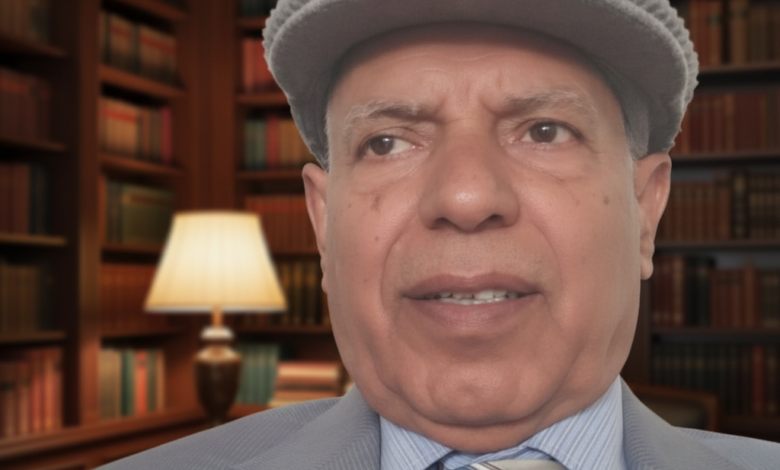
العلمانية: جسر التعايش بين الدين والسياسة
- حسن الدولة
الأحد 26 أكتوبر 2025-
يُعدّ مفهوم العلمانية من أكثر المفاهيم التي أسيء فهمها في الثقافة العربية والإسلامية الحديثة، إذ غالباً ما يُقدَّم على أنه مرادف للإلحاد أو خصومة مع الدين، في حين أن جوهره يقوم على مبدأ التعايش والتنظيم لا الإقصاء أو النفي. فالعلمانية ليست ديناً جديداً لتنافس الأديان، وليست أيديولوجية لتزاحم الأيديولوجيات، وإنما هي عقد اجتماعي، بالمعنى الذي أشار إليه جان جاك روسو في نظريته عن العقد الاجتماعي (1762)، يرسم حدود العلاقة بين الدولة والمجتمع، وينظم حقوق الأفراد وواجباتهم ضمن إطار قانوني يضمن المساواة والعدالة.
العلمانية، بهذا المعنى، لا تستهدف إلغاء الدين أو تهميشه، بل تحرص على حماية حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية دون وصاية أو تمييز، وعلى صون الدولة من توظيف الدين لتحقيق مصالح سياسية أو فئوية. وكما يؤكد جون لوك في رسالته عن التسامح (1789 لوك)، فإن الإيمان شأنٌ شخصيّ لا سلطان لأحد عليه، ولا يتحقق إلا بحرية الضمير. ومن هذا المنطلق، لا تشكّل العلمانية عداءً للمقدّس، بل حماية له من الابتذال السياسي وتحويله إلى أداة للصراع.
تُظهر التجارب الدولية أن العلمانية ليست نموذجاً واحداً جامداً، بل منظومة مرنة تتكيّف مع طبيعة كل مجتمع وثقافته. ففي فرنسا، التي تُعدّ من أكثر الدول التزاماً بمبدأ الفصل بين الدين والدولة، تحظر الدولة استغلال الرموز الدينية في مؤسساتها الرسمية، لكنها في المقابل تكفل حرية الاعتقاد وتدعم صيانة الكنائس والمساجد ودور العبادة باعتبارها جزءاً من التراث الوطني المشترك. أما في بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة، فنجد نموذجاً علمانياً أكثر توازناً، حيث تُعتبر الأديان مكوّناً أساسياً من الهوية الوطنية، وتُصان حقوق المؤمنين ضمن إطار قانوني يضمن المساواة بين جميع المواطنين.
وفي الهند، وهي من أكثر دول العالم تنوعاً دينياً، تحوّل مفهوم العلمانية إلى ركيزة للتعايش بين عشرات الطوائف والمعتقدات. فالدولة لا تكتفي بحماية الأديان، بل تقدم الدعم المالي لممارسة الشعائر، وتمنح المسلمين منحة مالية لأداء فريضة الحج إلى مكة المكرمة مرة واحدة في العمر، في دلالة رمزية على أن الدولة العلمانية يمكن أن تكون راعية للدين لا خصماً له. هذه التجارب تؤكد أن العلمانية لا تهدف إلى فصل الإنسان عن إيمانه، بل إلى بناء فضاء عام محايد يتيح لجميع الأديان ممارسة حرياتها في ظل دولة القانون والمواطنة.
من المنظور الإسلامي، لا نجد في التراث ما يتناقض مع هذا الفهم المدني للسلطة، إذ إن الإسلام في جوهره يرفض الكهنوت والسلطة الدينية المطلقة. فالعلاقة بين الإنسان وربه علاقة مباشرة لا تحتاج إلى وسطاء، كما أن التاريخ الإسلامي قدّم نماذج عملية لفصل الشأنين الديني والإداري دون إخلال بالمقدّس. فقد استقدم الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه نظام الدواوين الفارسية لتنظيم إدارة الدولة، في خطوة تعكس وعياً مبكراً بأهمية التخصص المؤسسي وفصل المهام الإدارية عن المرجعية الدينية (ابن سعد، الطبقات الكبرى).
إن قراءة متأنية لمفهوم العلمانية تكشف أنها لا تمثل نقيضاً للدين، بل ضمانة لبقائه نقياً من التوظيف السياسي. فهي ليست مشروعاً أيديولوجياً يسعى إلى فرض رؤية فكرية بعينها، وإنما إطار تنظيمي يحقق التوازن بين الإيمان والمواطنة، ويضمن وحدة الدولة في ظل التعدد الديني والفكري. وكما أشار عبد الله العروي (1973) ومحمد عابد الجابري (1990)، فإن جوهر التحدي في المجتمعات العربية لا يكمن في قبول العلمانية كفكرة، بل في تجاوز القراءة المشوهة لها التي تحولها إلى ساحة صدام بدل أن تكون جسراً للتعايش.
العلمانية، إذن، ليست فصلاً بين الدين والسياسة، بل تنظيماً لعلاقتهما بما يخدم المصلحة العامة ويحقق العدل والمساواة. إنها جسر التلاقي بين الإيمان والعقل، بين الروح والمؤسسة، بين الفرد والدولة. وفي تبنيها، لا تضيع هوية الأمة، بل تُصان، لأنها تحرّر الدين من الاستغلال وتعيد السياسة إلى مجالها الطبيعي في خدمة الإنسان والمجتمع.
إنها، في النهاية، ليست فصلاً بين الدين والإنسان، بل وصلاً بين المواطنين جميعاً في ظل دولةٍ تحكم بالعدل، وتحترم الإيمان، وتُرسي أسس التعايش والسلام.
اقرأ أيضا: ما وراء عسكرة جزر البحر الأحمر