الأستاذ قادري أحمد حيدر يكتب عن ثنائية الشعر والفكر للأستاذ القاسم بن علي الوزير

الأستاذ قادري أحمد حيدر يكتب عن ثنائية الشعر والفكر للأستاذ القاسم بن علي الوزير
الاربعاء25سبتبمر2024_ كتب الأستاذ قادري احمد حيدر مدير تحرير مجلة دراسات يمنية، عن ثنائية الشعر والفكر للأستاذ والمفكر الكبير القاسم بن علي الوزير ، وذلك لمجلة المسار العدد الـ74 الصادرة عن مركز التراث والبحوث اليمني، تحدث في هذه القراءة بعمق الباحث والمفكر عن شعر ومحاضرات الأستاذ القاسم ، وأيضا عن كتاباته ومحاضراته والتي جمع عدد منها في كتاب حرث في حقول المعرفة ، هذا الكتاب الذي يجب أن يكون في رفوف المكتبات العامة والجامعات ، بل وأن يكون من ابرز كتب الباحثين والمهتمين بقضايا الفكر والمعرفة ،باعتباره كتاب فكري نقدي بصياغات أدبية من شاعر متقد حيوية وإنسانية،حسب رأي الأستاذ قادري.

كما غاص قادري في قراءته خلال الأسطر القادمة في الفكر النهضوي المستنير، والقومي العربي التحرري، القريب في الفكر العام من اليساري التقدمي، للأستاذ والمفكر الكبير القاسم بن علي الوزير .
ولأهمية القراءة التي قدمها الأستاذ قادري احمد حيدر عن استأذنا الكبير القاسم في مجلة المسار العدد 74 قامت “صوت الشورى بإعادة نشر هذه القراءة ..
قاسم بن علي الوزير.. في ثنائية الشعر والفكر
أ.قادري أحمد حيدر
لم أتعرف شخصياً على الأستاذ قاسم بن علي الوزير، كما أنه لم يسعدني الحظ بقراءته شعرياً وفكرياً قبل رحيله. كنت أسمع عن اسمه من بعيد دون معرفة وإلمام بحيثياته الشعرية والفكرية، أي كشاعر وباحث. ومن خلال رسالة معايدة من الأستاذ زيد بن علي الوزير إليَّ، هذا نصها: “نبارك لكم أخي قادري بحلول عيد الفطر المبارك جعله خاتمة عهد حزين وفاتحة عهد سعيد يسوده الإخاء ويتم الانتصار على معتدٍ أثيم. ولكم بالذات الصحة والنجاح الموصول. وأرجو دعاءكم لأخي قاسم”.
10 أبريل 2024م
ومن هذه المعايدة بدأت بصورة ذاتية وشخصية أقترب من الاسم، وعرفت مدى سوء الوضع الصحي لشقيقه الأستاذ قاسم، ومدى محبته لأخيه في توسل أو رجاء الدعاء له بالصحة والشفاء. وبعدها بعث إليَّ برسالة تحية، هذا نصها: “أهديك كتاب أخي قاسم شفاه الله، لمزيد من المعرفة به، مع تحياته وتحياتي، وإذا تكرمت بالكتابة عنه أكون من الشاكرين”. وللأسف، وصلت الرسالة متوافقة مع أيام وفاة خالد ياسين السقاف، الأخ الأكبر لزوجتي، وبعدها مباشرة فقدان أحباء من الأسرة، ودخولي في متاهة الموت وتداعياته الذاتية. وإلا ما كنت تأخرت في استلام أجمل هدية، وهي كتاب الأستاذ قاسم بن علي الوزير، ومن هنا القراءة المتأخرة للكتاب بعد أن سبقني الموت إليه، فالموت “نقاد يختار منا الجياد”.
ومن هنا، هذه التحية المتأخرة، فقد حرمني الموت من تقديم تحيتي له كشاعر ومثقف وباحث يستحق منا الكثير. وأسفي وحزني عظيم أنني لم أتمكن من الكتابة عنه وهو بيننا يصارع تعب الجسد، الذي يتضح من كلمات وعبارات أخيه الأستاذ زيد من أن حالة المرض كانت محنة ذاتية وإنسانية قاسية على جميع أفراد أسرته. وبعد الرحيل الفاجع واتصال الصديق الأستاذ حسن الدولة، بأن هناك عدداً من أعداد مجلة “المسار” سيخصص للكتابة عن الفقيد، ومن هذه الخلفية سألت مكتبة مركز الدراسات والبحوث عن أعمال للفقيد، ولم أجد سوى مجموعة أعماله الشعرية مجموعة في ديوان اسمه “مجموعات شعرية”، حتى وافاني الصديق الأستاذ الباحث حسن الدولة بالعمل البحثي والفكري الوحيد المجموع له رغماً عنه تحت عنوان “حرث في حقول المعرفة”. ومن هنا كانت بداية هذه القراءة والكتابة.
لقد قضيت مع قاسم بن علي الوزير وقتاً مقتطعاً أو مختطفاً من الزمن، كان يمكن أن يكون زمناً ضائعاً أو مستهلكاً في اللامعنى من الوقت.. وقتاً أضاف إلى معرفتي معرفة بالشخص والإنسان، مع أنني لم ألتقه شخصياً.. وقتاً أثمر معرفة أعمق بالشاعر والناثر والإنسان، تلكم هي ألفة وصداقة المعرفة، فقد خرجت من رحلة البحث والقراءة رابحاً معرفياً وشخصياً وإنسانياً.
الذات والصفة:
لن أتحدث عن خلفيته الأسرية بروحية المؤرخ أو المهتم بالتاريخ، فذلك حديث يطول وسينقلنا إلى مجال بحث مختلف عن مناسبة الرحيل وتكريم شخصية ثقافية وإنسانية، أسهم هو في جعل اسمه بعيداً عن الأضواء (عن الإعلام وعن النشر)، وعن حق المجتمع في معرفته عن قرب كشاعر وباحث من خلال شعره الذي يضعه في قامة شعراء كبار في اليمن والمنطقة العربية، وقامة بحثية وثقافية وفكرية لها إسهامها الطيب والمميز والنوعي على مستوى الإنتاج المعرفي والفكري والثقافي، وهو ما اطلعت عليه بعد رحيله من خلال كتابه الذي أجده قيمة معرفية وثقافية مضافة، والذي جمعه أخوه الأستاذ زيد رغم ممانعته لذلك، فكان بحق هدية ثمينة للمكتبة اليمنية والعربية، وإن بقي الكتاب -كذلك- حتى اللحظة محدود التداول إلا في وسط نخبة فكرية وثقافية محدودة. ومن هذه المناسبة التكريمية فإنني أدعو جميع المهتمين بالمعرفة؛ الشعر والفكر والثقافة، إلى اقتناء مجموعاته الشعرية وإلى الحصول على كتابه “حرث في حقول المعرفة”، وهو كتاب ثمين جدير بالاقتناء ويستحق القراءة في زمن ساد فيه الغث من القول والفكر.
قاسم بن علي الوزير شخصية تجمع في ذاتها واسمها بين صورة الشاعر، والمثقف والباحث والمفكر، هو في ذاته خلاصة لهذه المسميات والصفات ولن تجانب الصواب إذا تحدثت عنه بصفته الشاعر المهجوس بالشعر، والممتلك لأدواته الشعرية، أو بصفته المثقف، أو بصفته الباحث المجيد المقتدر، أو باسم المفكر. هو هوية ذاتية إنسانية عالمة، حاضر وفاعل ومنتج في كل هذه المسميات والصفات. مرة سألت د. عبد العزيز المقالح أين تجد نفسك في الشاعر، أو الناقد؟ فأجاب دون تردد: في الشاعر، مع أنه الشاعر والمثقف والباحث والناقد، ومن يحوزون ويحملون هذه الصفات والمعاني بجدارة هم القلة القليلة، والأستاذ الفقيد قاسم الوزير هو من هذه الكوكبة القليلة.
وواضح أن الأستاذ الفقيد، قاسم بن علي الوزير، بقدر ما كان معتزاً باسمه ومكانته وبكرامته الشخصية، والوطنية والإنسانية، كان -كذلك- شديد البساطة والتواضع، إلى جانب عقل إبداعي اجتهادي متقد، يكره أو لا يحب الأضواء، ولا النجومية الإعلامية، وهو ما سمعته عنه بعد وفاته من بعض مجايليه وأصدقائه الذين كانوا على تواصل إنساني معه، ومنهم الصديق الأستاذ حسن الدولة، بعد أن أهداني نسخة مطبوعة من كتابه “حرث في حقول المعرفة” الذي حزنت كثيراً أنني لم أطلع عليه في حياته وفي حضوره، لأهديه تحية قرائية لكتابه، هي قطعاً تحية ناقصة تعجز عن سبر أغوار الأفكار المثيرة والمنيرة التي أثارها كتابه في صورة ذلك “الحرث المعرفي”، والذي وجدته بعد القراءة، اسماً على مسمى، هو -حقاً- حرث في القضايا الإشكالية التي اقترب منها وتناولها بعمق الباحث المقتدر في صورة أبحاث ودراسات ومحاضرات، فيها بعض خلاصة فكره، وروحه الإبداعية النقدية، وهو ما ضاعف حزني من عدم الاطلاع على الكتاب وتقديم التحية له وهو حاضر بيننا.
وهو كتاب -كما سبقت الإشارة- يستحق القراءة، وهي دعوة لأن يكون مكانه في رفوف المكتبات الجامعية والمكتبات العامة والخاصة للمهتمين بالفكر عموماً، والفكر الإصلاحي والتنويري والنهضوي في اليمن، والمنطقة العربية خصوصاً، كتاب فكري نقدي بصياغات أدبية من شاعر متقد حيوية وإنسانية، وهو كما وصفه أحدهم “الشاعر الذي توارى وراء تواضعه المعتاد” . على قدرته الخلاقة لأن يجمع ويجسد في ذاته حالة ثنائية الشاعر والناثر.
الشاعر والإنسان
يبدو أن ذات وروح الشاعر، عميقة الصلة بالشعر، وعلى درجة عالية من الحساسية الإنسانية بالوجود من حوله، وهو ما ترك ندوباً جارحة على نفسيته، بخاصة من رحلته الطويلة والقاسية مع السجن، الذي عرفه وعاش مراراته هو وإخوته، فقد وجد نفسه وهو في بداية عمر المراهقة ومطالع الشباب الأولى، سجيناً في واقع بئيس “قروسطي” ومكبل بالقيود المادية، والمعنوية التي لا صلة لها بأي معنى إنساني. رحلة قاسية عرفها وعاشها جميع إخوته، وأفراد أسرته بعد فشل حركة 1948م الدستورية، وهي النكبة التي تركت آثارها الفكرية والسياسية والاجتماعية والنفسية على كل البلاد، على أن وقعها النفسي والفكري والاجتماعي على روح الشاعر المتطلع للحياة كانت هي -كما أتصور- الأقسى والأعنف.
نكبة وكارثة، حمل قاسم بن علي الوزير مراراتها وتداعياتها السلبية على روحه الشاعرة حتى لحظة رحيله، وتعلم منها كيف يتمسك أكثر بالقيم الإنسانية، وهو ما نراه في شعره “مجموعات شعرية”، وفي كتابه الوحيد المجموع رغماً عنه “حرث في حقول المعرفة”.
أي أن حصيلة تعب السجن لم تكن مرارات ذاتية، بل كانت أيضاً قيماً إيجابية تعلمها، وأصر على التمسك بها والتعبير عنها معرفياً وفكرياً، فكتاب “حرث في حقول المعرفة” يقول هذا المعنى بجدارة كما يقولها الشعر الرفيع والبليغ في عمقه الإنساني الذي تحتويه “مجموعات شعرية”.
إن طبيعته الذاتية المفتوحة على الآخر، وروحه الشعرية في طابعها الإنساني هي التي أهلته ليكون بتلك الهيئة الذاتية الفكرية الصارمة، وبتلك الروح الشعرية المشحونة بكم هائل من الحزن ومن الحب ومن الوفاء لمن حوله، وهو ما نجده مبثوثاً ومنشوراً في قصائد حزن عظيمة.. حزن على ما مر به من بعض متاعب الذات في رحلة طويلة مع الألم والأمل، في صورة حزن على الذات، وعلى الوطن وحزن على الأصدقاء الذين يرحلون مع تعبهم دون وداع.
وحول هذا الشجن والهم الإنساني الباكي والحزين، يقول:
حزين؟ نعم والحزن بعض مواهبي
فلا تسألي عني سلي عني مصائبي
تجرّعتها طفلاً صغيراً ويافعاً
وكهلاً لقد أتعبت حتى متاعبي
(2)
هو مقطع شعري يذكرك ببلاغة وجزالة وفنية عمود الشعر عند الشعراء العرب الكبار من المتنبي إلى الجواهري، إلى عبد الله البردوني، بقدر ما يذكرك بروح التحدي والمقاومة.. مقطع شعري يكتنز مرارة حزن غائر في أعماق الروح (حزن ذاتي وتاريخي)، على أنه مقدم ومسبوك في صياغة شعرية فيها من جمال البلاغة، ومن فنية الشعر، ومن عمق الرؤية والفكرية في تصوير متاعب الذات وهي تقول بعض تباريح النفس.
وأتصور أننا مع رحلة قاسم الوزير مع الشعر نجد أنفسنا أمام ومع سردية حزن، أخذت بعداً ذاتياً وتاريخياً وإنسانياً بسبب التحولات الدراماتيكية للمسار السياسي اليمني الصعب والمعقد، المسار الذي مايزال مستمراً حتى لحظة رحيله. وحول قاسم الوزير والحزن كتب راشد المبارك:
“لعل أول ما يستوقف القارئ لشعر الأستاذ قاسم هو طابع الحزن الذي يسربله لأنه إلى الحزن صار ومن الحزن انبعث” .
ويظهر وبتجلٍّ شفاف أمامنا صورة ومعنى وجدانه الشعري العميق، في إحساسه بمن حوله، ووفائه لأصدقائه في العديد من قصائده العامرة بالمحبة والوفاء والرثاء، وما أكثرها في قصائده التي وصلت إلينا عبر “مجموعات شعرية”.
حزن حمله من طفولة المراهقة، إلى يفاعة الشباب، إلى الكهولة.. حزن توحد بالحب، فكان جمال الشعر، وصرامة الفكر. وفي مقام الحديث عن الشعر والحزن، والوفاء من المهم التفريق بين حالتي الحزن والوفاء، فالحزن حالة إنسانية عامة تخص وتعم، أما الوفاء فهو كينونة ذاتية إنسانية خاصة، وهي حالة فردية مرتبطة بهذا الفرد دون ذاك، بهذا الأخ دون الآخر، وقد جمع الفقيد والإنسان قاسم بن علي الوزير في ذاته الشعرية والحياتية بين حالتي الحزن والوفاء.
وهو ما تحكيه سرديته الشعرية في طابعها الدراماتيكي والتراجيدي معاً. وهنا، هو -كذلك- يذكرني بالصديق النبيل د. عبد العزيز المقالح، الذي خصص ديواناً للأصدقاء “كتاب الأصدقاء”، وإذا ما جمعت قصائد قاسم الوزير للأصدقاء والوفاء لهم فهي تعدل ديواناً شعرياً، فهما -أي المقالح وقاسم الوزير- من جيل وعمر واحد.. المقالح دخل السجن رهينة مع والده، وقاسم الوزير دخل السجن عقاباً وانتقاماً لاشتراك والده وعمه في قيادة انقلاب أو حركة 1948م الدستورية العظيمة.
كان من سوء حظي -كما سبقت الإشارة- أنني لم أتعرف شخصياً على الأستاذ قاسم الوزير، ولكن دلتني عليه وقادتني إليه قصائده في “مجموعات شعرية”، وفكره الصارم والمستنير في إبداعه الفكري الذي حواه كتابه “حرث في حقول المعرفة”، وبذلك عوضت المعرفة الحسية الحياتية بالشخص بالمعرفة الأعمق والأجمل، حينما وجدت نفسي منهمكاً في مطالعته ومعايشته ومرافقته والسهر معه أياماً طويلة أحاوره وأتبادل معه أطراف الحديث حول جملة من المفاهيم والقضايا الحياتية والهموم التي اشتغل عليها معرفياً، من خلال الشعر وعبر الفكر المستنير.
قاسم الوزير المثقف والإنسان، شاعر مخلص للشعر، قصائده تدلنا على إنسان جميل ونبيل، والوفاء إحدى صفاته، ومن تنطبق عليه صفة الوفاء لا يمكن إلا أن يكون جميلاً وكبيراً.
هو كبير، ليس لأنه شاعر وباحث ومفكر، بل لأنه قبل كل شيء إنسان، وأضاف الحزن الإنساني العميق والوفاء لمن حوله، عمقاً أشمل لمعنى إنسانيته، وهو ما يُرينا رحابة أفقه الروحي في تمثلاته الصوفية، وبُعداً أشمل لمعنى إنسانية الحزن فيه.
فهو يكتب شعراً قائلاً:
دفنت بنفسي بعض نفسي فأصبحت لنفسي منها دافن ودفين
وهي مقاطع تجمع بين الحزن والوفاء والتضحية والفداء.وهو القائل شعراً عن حزنه:
أخفي الجراح بنفسي وهي قاتلة وأمنحُ الناس مني الوجه جذلانا
فليشرب الناس من كأسي مشعشعة
وأحتسي دون خلق الله نيرانا
يا من يرى الوردة الحمراء باسمة
دمي جرى في عروق الورد ألوانا
وفي بعض قصائده التي أسمعه يرددها وهو في ذروة لحظات تعب الجسد الذي يقربه في كل لحظة من شهقة الموت، فتجده يحاور الموت، في صورة ذهنية شعرية رائعة ودون خوف، جملة شعرية تعكس روح العقل المستوعب جدلية الحياة والموت، فنراه يقول:
يجادل فيك الموت معنى حدوثه وفيك رأى معنى الخلود المصاحب
حوار وجدال المؤمن الذي يعشق الحياة، ويرى في الموت لحظة خلود توحده بقدر الله، ولا تخيفه منه، ما يجعله أبداً متوحداً بالمعنى الكلي والإنساني للموت والحياة. إنه عقل المؤمن المحتسب.
شاعر ممتلئ بالحزن وبالوفاء لمن حوله، حزن طافح بالحب تجده وتطالعه حتى في خطابه الثوري، نقرأ التحدي ممزوجاً ببعد الحزن، وكأنه الحزن الثائر والمتمرد، وليس حزن الاستكانة والصمت، وبذلك نرى الثورة، بل حتى فكرة التغيير عنده محاصرة بحزن أكبر من طاقة وقدرة الكلمات على تحويله إلى واقع. تبقى الثورة رغبة وأملا وحلما في حدود الـ”نستالوجيا”، حنينا طاغيا وعاصفا، وشوقا بلا حدود للإصلاح والتغيير في واقع مايزال طعم مراراته البعيدة والقريبة تلاحقه، حتى وهو في الغربة عن الوطن، حنينا تختصره كلمات شاعرة مدججة بهم الإصلاح والتغيير للذات وللواقع، كما هي ممتلئة بالحزن النبيل، وكأننا أمام إصلاح أو تغيير “ثورة” ممنوعة من الصرف على الصعيدين الوطني، والقومي العربي.. إصلاح وتغيير واقعين بين المتاح المنتظر، والممكن البعيد، حتى لا أقول المستحيل، ولذلك حضر الحزن بتلك الصورة الطاغية على “مجموعات شعرية”، وغاب التغيير للواقع، كما حلم به الشاعر منذ سنوات طويلة، وقاده إلى السجن يافعاً ومراهقاً، حلم يتناسل ويتواصل في داخله شعراً وفكراً.
قاسم بن علي الوزير إنسان شديد الإحساس بالناس، والحساسية المعرفية والإنسانية بالوجود، ولذلك هو عميق الارتباط بالواقع اليمني، رغم غربته الطويلة الجغرافية عنه، بقي الوطن هماً وقضية وحلماً يسكنه حيثما سكن وارتحل. إنسان نبيل وصادق مع نفسه ومع الآخرين، لم يتبقَّ منه بعد قرابة أكثر من ستين عاماً من الحلم ومن الحزن، ومن الشعر، سوى سورة وسيرة التعب، وسوى الاعتصام برثاء الأصدقاء والوفاء لهم شعراً، بعد أن صار الموت عادةً وحالة ذاتية يومية، نطالعه مع كل قصيدة رثاء ووفاء لرفيق عمر، كما في قصيدته لصديقه أمين محمد هاشم، وغيره كثر.
حتى كان أو كاد الموت يكون له عادةً.وهو القائل شعراً:
أنا لا أعيشُ بغير عاصفة
تُعربدُ في حياتي
لو كنت أعرف أن موت
إذًا أجرِّبه مماتي
وأعلّم الموتى جُنوني
… ثورتي… قَلقَ الرُّفاةِ
لقد صار الحزن أنيسه، والشعر رفيقه، وبلاغة القول عدته الوفية في حماية النفس من قهر سلطات الخارج الذي يحيط به، من جميع جهات الحصار.. جميع جهات الحزن، ومع ذلك لم يستسلم قاسم الوزير للحزن، ولم يبقَ أسيراً له، بل وظفه وتوسله أداة مقاومة، وهو ما تقوله قصائده الموزعة على “مجموعات شعرية”.
وفي تقديري أن أعماله الشعرية في عناوينها المختلفة، هي أداة مقاومة، ووسائل دفاع عن الذات وعن الأصدقاء وعن الوطن، كما حلم به. هي أعمال شعرية لم تدرس من المهتمين والاختصاصيين بالنقد الأدبي بعد. فكما كتب للأصدقاء والوفاء لهم، فقد غنى للثورة المصرية 1952م شعراً، وعمره لم يتجاوز السابعة عشرة، وهو دليل انحياز واصطفاف لصف الثورة ولفكرة الثورة.
وما يلفت الانتباه أكثر في هذا الاتجاه نحو الشعر وكتابة الشعر، أنه كتب ومبكراً قصيدة التفعيلة، بل والقصيدة “المدورة” حين كان عمود الشعر هو الطاغي والسائد في الكتابة الشعرية اليمنية والعربية، وهو القادم من اليمن الإمامي المغلق على نفسه، في عزلة تاريخية، ودلالة الكتابة الشعرية في صورة القصيدة “المدورة” إنما هي دليل حي على أن قاسم الوزير خرج من دائرة العصبية الأيديولوجية للشعر العربي القديم، وهو ما لا يمكن أن يكون دون أن يكون ابن الوزير تلمس طريقه إلى فكر الاستنارة والتنوير، والحداثة الشعرية العربية المعاصرة تحديداً في ذلك الزمن المبكر، من العمر، ومن التاريخ، حين كان الشعر هو “ديوان العرب الأول” ومخزنهم الأدبي والثقافي واللغوي.
والقصيدة المرسلة عنوانها “عودة النّائي”، وفي مطلعها يقول:
صنعاء
ها أنذا أعودُ إليكِ
يا حلم الخيال
ويا صلاة الفنَّ
في محرابه السامِي
في هذا الوجود
***
هذا أنا
هل تسمعين نداء محرورِ الفؤاد
وقفت أمانيه ببابك وهْوَ
ينوءُ بالسورِ القديم
قد أُبْتُ
لكن فانظري..
هل تعرفين..؟
***
هل تعرفين فتاكِ؟
أم أنكرتِه؟
قُولي…
فقد بعُد الزمان بنا
وغيَّب في دُجى المجهولِ
أشباح اللقاء…
ونأيت عنك..
وطال بي النأيُ المُبَّرحُ..
لا رضاكِ.. ولا رضايَ..
فيهِ
وما ليَ من يدَيْن..
.. لو تعلمين
جميع من كتب عنه وعن شعره تحديداً، كما في الدراسات النقدية لنتاجه الشعري الذي جمعه الأخ الأكبر الأستاذ إبراهيم الوزير، يشيرون إلى بساطته وتواضعه الجم، واهتمامه بالأصدقاء، ويؤكدون على عدم اهتمامه بنشر أعماله، وعلى عدم جمع ما كتبه شعراً وفكراً، ومن أن مجموع أعماله الشعرية والفكرية تمت رغماً عنه من خلال أخويه الأستاذين إبراهيم، وزيد، وبدعوة من محبيه الذين يدركون القيمة الإبداعية لشعره، والمعرفية والفكرية لما كتب. ومع أن البساطة والتواضع أمران محمودان، ويعكسان عمقاً اجتماعياً إنسانياً راقياً، على أن غير المحمود وغير الطيب هو دفن ذلك التراث الأدبي/ الشعري، والنتاج المعرفي الفكري الرصين، عن أن يكون في متناول المهتمين والباحثين المختصين بقضايا الأدب والفكر، وحسناً فعل الأستاذان إبراهيم، وزيد أخواه، على إخراج تلك النتاجات لتكون في متناول الجميع، وإن كانت ماتزال محصورة في الحدود النخبوية الضيقة.
باحثاً ومفكراً:
“هو في كل من الشعر والنثر يهدف إلى إيقاظ الفكر من غفوته، وتصحيح السياسي من انحرافه، وإخراج المجتمع من جموده” .
هكذا كتب عنه ورَآه أخوه الأستاذ زيد، في تقديمه للكتاب الفكري الذي جمعه له من بعض مجموع أعماله الموزعة في الصحف، والمجلات المختلفة، وهو -في تقديري في الصياغة التي وردت- رأي أو حكم فيه الكثير من العاطفة، كما فيه قدر معقول من الواقع ومن الحقيقة الفكرية التي كانها الأستاذ قاسم، في كل ما كتبه من “حرث” في اتجاهات المعرفة والفكر، بعد التخفف قليلاً من حالة الإطلاقية في الحكم، كما وردت في إشارة زيد السالفة.
ما يهمني في هذه الفقرة هو محاولة التركيز لالتقاط بعد الاستقلالية الذاتية في التفكير، وفي الفكر، الذي كانه الباحث، والذي وجدته يتخلل ويحضر في الكثير من الفقرات والمعاني الواردة في كتابه أو في حرثه المعرفي، في صورة سعيه الحثيث لتأكيد استقلاليته في الفكر وفي التفكير عما هو سائد في الوسط الفكري والثقافي اليمني، والعربي خصوصاً، بل وفي تأكيده إظهار أو إعلان استقلاليته -حتى- عن بعض المفاهيم الفلسفية الكبرى للمدارس الفلسفية العالمية، في صورة المدرسة الفلسفية المثالية، والمدرسة الفلسفية المادية، اللتين قدم ملاحظاته الفكرية عنهما وحولهما، فهو يقول: “في إطار البحث عن الطريق تقدم الفلسفة بعض أجوبتها: الفلسفة المثالية تقوم على أن “الواقع” الخارجي هو انعكاس للفكر. وعليه؛ فإن الأفكار التي تشكل الوقائع أو صورتها في الخارج، أي في الواقع، فإذا ما أخذنا بهذا فإن التغيير يجب أن يبدأ من “الفكر” أو العقل أو سمه ما شئت.. لكن الفلسفة المادية ترى العكس؛ فهي ترى الفكر انعكاساً للواقع. وعليه فإن مفردات هذا الواقع هي التي تشكل الأفكار والمعتقدات؛ فإذا ما أخذنا بهذا فإن التغيير يجب أو يتحتم أن يبدأ من تغيير الواقع (بالتطور أو بالثورة مثلاً كما هي لدى الماركسية)، على أن كلا وجهتي الفلسفة هذه تفتقر إلى إدراك حقيقة العامل الذي يكمن وراء الفكر ووراء الواقع معاً، ويجعل من كليهما موضوعاً قابلاً للفعل والتأثر والتأثير. ونعني بذلك “روح” الإنسان الذي يستخدم الفكر والعقل، ويشكل الواقع أياً كان، انعكاس أحدهما على الآخر.. فالإنسان كما هو جسد.. وعقل، هو روح أو نفس. وهذا هو الذي يصير به الإنسان إنساناً. وعليه فإن “التغيير” يبدأ من تحرير “روح” الإنسان من سيطرة الخرافة، في أي من أشكالها، وسيطرة الجهل بكل صنوفه، وسيطرة الخوف بكل أنواعه، وسيطرة الظلم والاستبداد بكل أشكالهما. وبهذا يصبح الإنسان الحر وسيلة التغيير، وهو هدفه” .
اضطررت لإيراد الفقرة/ الرؤية كاملة التي أوردها الأستاذ قاسم، على طولها، لأشير وأؤكد أولاً، على أمانته العلمية والفكرية في الاقتباس والنقل لمعاني النصوص التي يختلف معها، نقلها كما هي في أصولها أو معانيها الكلية، بل حتى دلالاتها المقصودة دون زيادة ولا نقصان، على عكس ما نطالعه في بعض الكتابات الفكرية والسياسية، تحديداً الكتابات من موقع الرؤية “الإسلاموية” التي نجدها تشوه ما تنقل عنه، أو تبتسره، بخاصة في من تراهم كفاراً أو علمانيين، وتقديم حكمها مسبقاً، بالقفز على المعنى والفكر المطلوب بحثه ونقده، هذا أولاً، وثانياً كان إيراد الاقتباس كاملاً لأشير إلى أن الباحث قاسم الوزير قدم في معارضته صورة وروح وعقل الباحث المعرفي، على الأيديولوجي والسياسي، وثالثاً للقول إننا أمام باحث مطلع ومقتدر وأمين في عرضه لفكر الآخر، باحث يحاجج عن معرفة بأصول وفكر الآخر، بصرف النظر عن رؤيته وتأويله الفكري، وقراءته الثقافية لفلسفة ورؤية الآخر، وكيف هو فهم وقرأ رؤية الآخر، والجميل هنا هو أنه يسعى للحوار مع الرؤى الأخرى من موقع رؤية يراها البديل، أو هي الأكثر واقعية وصدقية وموضوعية وعقلانية. ومع كل التقدير والإجلال للرؤية النقدية التي أوردها الباحث في متن رؤيته/ محاضرته -وهي في جزء منها صحيحة- وهذا حقه، كما يحسب له المحاججة على قاعدة المعرفة، والحق في الاختلاف والنقد، على أن الباحث قاسم، لا يرى أن الرؤى الفلسفية تناقش قضايا وإشكالات فلسفية ومعرفية حول علاقة الوعي، والوجود، علاقة الوعي/ الفكر، بالواقع، أي علاقة الوعي الاجتماعي، بالوجود الاجتماعي، وليس فحسب أيهما أسبق، أو الأكثر قدرة على التأثير، الوعي أم الوجود، فهذه إشكالية معرفية فلسفية ستظل قائمة وقيد البحث باستمرار من زوايا مختلفة، وفي أزمان معرفية مختلفة، وحين قدمت الماركسية -وهذا ليس دفاعاً عنها- الواقع أو الوجود الاجتماعي نسبياً على الوعي/ الفكر، فإنها لم تنكر العلاقة التفاعلية الإبداعية في ما بينهما، وليس الانعكاس الميكانيكي “الفوتوغرافي” للفكر في الواقع، الفهم الانعكاسي غير الجدلي، والبعيد عن روح المادية الجدلية والتاريخية، الذي يجعل -عند البعض- من الفكر تابعاً وملحقاً أبداً بالواقع وصورة جامدة له، كما ذهبت إليه بعض اتجاهات القراءة الفكرية الماركسية السلطوية في طبعاتها التبسيطية السطحية، بجعل الفكر ملحقاً وتابعاً للواقع في كل الأحوال، انطلاقاً من النزعة “الاقتصادية” وليس المادية الجدلية التاريخية، وهي قضية ومسألة نوقشت وبحثت في أصول الفلسفة الماركسية كثيراً، وقدمت حولها قراءات نقدية معمقة ليس مجال بحثها هذه التحية والتكريم لاسم علم فكري بارز في الثقافة اليمنية المعاصرة. علماً أن الفلسفة المثالية، بشقيها “الذاتي”، و”الموضوعي” تحديداً كما هي عند “هيجل” وتلاميذه، وكذا الفلسفة المادية الجدلية والتاريخية، وضعتا الإنسان في القراءة الفلسفية في مكانة الصدارة والفعل في التاريخ قياساً إلى ما كان في صورة الإنسان الذهنية والفكرية في الكتابات السابقة، علماً أن الماركسية في أصولها الفلسفية، ومن خلال بعض رموزها النقدية قد قدموا مساهمات نقدية للطابع الاستبدادي للسلطة الشمولية الكلية، “دولة البروليتاريا”، وفي إهمال وتغييب أو تغريب لدور الإنسان، كما هو الحال مع البعض، ومنهم مساهمة المفكر “هربرت ماركيوز” -كمثال- في كتابه “الإنسان ذو البعد الواحد”، والذي يتضمن نقداً عميقاً للتجربة الماركسية في صورة بعض التمظهرات السلبية/ الاستبدادية في دولة الاتحاد السوفيتي. وبهذا المعنى تصدق ملاحظة الأستاذ قاسم الوزير -جزئياً- حين يتصل الأمر بالجانب السياسي والتنفيذي، وتحديداً في جانب الموقف من الديمقراطية ومن الحريات التي رافقت التجربة الاشتراكية في أخطاء الممارسة القاتلة، وليس في أصل البحث الفلسفي، حول علاقة الوعي الاجتماعي بالوجود الاجتماعي، أو علاقة الفكر بالواقع.
ما يعنيني ويهمني من هذا الحوار الذي قدمه وخاض فيه الباحث ابن الوزير، هو التأكيد على النزوع المعرفي والفكري الواعي لتأكيد معنى استقلاليته الذاتية في التفكير عن المعطى المعرفي والفكري والسياسي السائد، ليس فقط للرؤيتين المثالية والمادية، الرأسمالية، والاشتراكية، ومحاججته لهما من موقع العارف والعالم، بل ونزعته الاستقلالية في التفكير وفي التأسيس لرؤية فكرية خاصة به، ليست مفصولة بالمطلق عما قبله، بل تطوير لها أو استمرار معاصر لما يراه يجب أن يكون، جرياً أو تطويراً لما كان عند رواد فكر النهضة العربية في منتصف القرن التاسع عشر، وتتجلى ظاهرة الاستقلالية في التفكير في جملة من الرؤى والطروحات التي حضرت في “حرثه” المعرفي، ومنها على سبيل المثال: رؤيته للإصلاح والتغيير، فرواد النهضة العربية طرحوا فعلاً سؤال النهضة عبر فكرة الإصلاح، ولكنهم لم يشيروا إلى كيف يكون وبأية طرائق؟ وما هي الوسائل لذلك؟ بقي سؤال النهضة مجرداً ومعلقاً في سماء حدوده المعرفية الفكرية، “القولية”، بعيداً عن سؤال السياسة والسلطة، اللتين بدونهما لا يتم ولن يتحقق الإصلاح.
ولذلك يؤكد قاسم بن علي الوزير محقاً على دور الإنسان، وعلى دور “الثقافة” الفاعلة في التغيير، بعد تحريره من الجهل ومن الخوف ومن الاستبداد، وجعل المعرفة مرتبطة بالواقع المطلوب إصلاحه أو تغييره، وهو ما نجده منتشراً ومبثوثاً في سطور “حرث في حقول المعرفة”.
إن المسألة أو القضية في رؤية قاسم الوزير “هي في فهم القوانين و”العمل” بمقتضى تلك السنن.. وهذا وحده هو طريق الخروج” .
أي أنه في ومن خلال ذلك الفهم والوعي والأدوات، يكون وصولنا إلى بر الأمان، في الانتقال من مرحلة إلى مرحلة، من تاريخ إلى تاريخ، والأهم والعملي في الانتقال من المشكلة/ الأزمة إلى الدخول إلى فضاءات واقع جديد، بعد تقديمنا الحلول العملية لتلك المشكلة/ المشاكل المتراكمة، ذلك وحده -كما يرى- هو طريق الخروج، ومعه كل الحق، لأننا خلال المراحل الماضية بقينا ندور عند بحث المشكلة، ونعيد مراكمة إنتاجها، بدلاً من العودة إلى جذر سؤال الأزمة، أي إلى الأسباب المنتجة للمشكلة/ الأزمة، وهذا المعنى من الفهم والقراءة ستجده يغطي معظم صفحات كتابه/ محاضراته، وهو تفكير -مع الأسف- مانزال قابعين داخله ونحن نفكر في الحاضر وفي المستقبل، ولذلك -كما يرى قاسم الوزير- لم نتجاوز أسئلة وإشكالات الماضي، ومانزال نجيب على أسئلة الراهن/ الحاضر بذات الإجابات القديمة، ولذلك لا يمكننا من خلال هكذا منطق من التفكير أن ننطلق إلى المستقبل.
فهو يكتب حول ذلك قائلاً: “إن بقاء أية مشكلة بدون حل لا يعني توقفها عند كونها مشكلة فحسب؛ بل إنها -من حيث الكم- تتوالد، وبذلك تزداد تعدداً، وهي -من حيث الكيف- تتعقد، وبذلك تزداد تنوعاً. إن المشكلة الواحدة إذا ما تركت تصبح مشاكل شتى متعددة الأشكال والألوان تتوغل في مختلف مجالات حياتنا، وتتحكم في أوجه نشاطنا، وكل استمرار في هذا الاتجاه يعني ابتعاداً متواصلاً عن مواجهة المشكلة الأم، أي ابتعاداً عن الرحم التي تتناسل منها جميع المشاكل. وبسبب ذلك تتجه جهودنا إلى متفرعات المشكلة، وتشتبك مع بنياتها في معركة خاسرة عوضاً عن مواجهة المشكلة ذاتها (…)، إنها تظل “خميرة” تفسد حتى “تفكيرنا”، ومن ثم تحبط جميع جهودنا وأعمالنا” .
ومع مثل هذا المنطق من الفكر والتفكير والخطاب الموضوعي العقلاني النقدي، نجد أنفسنا أمام باحث يمتلك منهجا وبصيرة واقعية في فهم طرائقه للإصلاح والتغيير، بعيداً عن العصبية، والفكر الاتكالي/ التواكلي، الذي يراكم المشاكل، ويعجز عن حلها إلا من خلال “التفكير بالتمني” الذي قادنا إلى جحيم الفشل المتكرر، والعجز المستدام عن حل مشاكل الواقع، بعيداً عن الأوهام الذاتية الأيديولوجية، القومية الرومانسية، واليسارية الثورية، والإسلاموية، التي انفصلت -جميعاً- عن الواقع، ولم تتمكن سوى من مراكمة المشاكل، وبالنتيجة استقدام الخارج الاستعماري إلى داخلنا، “فالطغاة في التاريخ هم من يستقدمون الغزاة”، وهو ما نعيش بعض تفاصيله الملموسة في أكثر من منطقة عربية اليوم.
ومن هنا تأتي رؤية قاسم الوزير للإصلاح مرتبطة أو منوطة بالإصلاح الشامل، والإصلاح عنده غير ممكن بدون التغيير، من خلال تساؤله: “هل ممكن الإصلاح بدون تغيير؟”، مع أن معنى وقيمة التغيير عنده، أي ضمن رؤيته الخاصة لمفهومي الإصلاح والتغيير، هو أن التغيير أدنى مرتبة ومكانة من الإصلاح، الإصلاح هو الأساس للتغيير، هكذا هي منظومة تفكيره في علاقة الإصلاح بالتغيير.
على أن الجميل في رؤيته لسؤال النهضة، هو أنه وضع الحصان في مقدمة العربة، لتتمكن الفكرة من الحركة والمرور، وبذلك أعاد الاعتبار العملي/ السياسي للسؤال في صورته الناقصة كما تبدى عند رواد النهضة الذين بقوا وظلوا عند دائرة السؤال المعرفي، دون البحث في طرائق الخروج من المشكلة والأزمة، أي دون ربط المعرفة والفكر والثقافة بشرطه السياسي السلطوي. وعلى الرغم من أن قاسم الوزير يرى حالة الارتباط بين الإصلاح والتغيير على أنه -كما سبقت الإشارة- يعطي للإصلاح مكانة أكبر وأعلى من التغيير الذي يعني هنا الثورة، فهو يرى أن “من الضرورة هنا، أن نميز بين مفهوم أو مدلول الإصلاح، ومفهوم أو مدلول التغيير. الإصلاح -من حيث الجوهر- ومن هنا رؤيته الذاتية الخاصة لمفهوم الإصلاح والتغيير، والفارق بينهما في واقع الممارسة العملية، عملية تصحيح لأخطاء وتقويم لمعوجِّ هو تسديد وتشييد، وهو تصويب وضعٍ.. لمجتمع ما أو حالة ما (…)، أما التغيير فيعني إزالة عوائق وتوفير وسائل وتهيئة مناخ. الإصلاح هدف يكون دائماً متجهاً إلى الأفضل.. إلى الأمام، والتغيير وسيلة قد تكون إلى الأحسن، وقد تكون إلى الأسوأ” .
فهو هنا يعطي للإصلاح مكانة أكبر وأعلى وأرفع من التغيير، فكأن التغيير وجد ليخدم فكرة وقضية الإصلاح، وحسب رأيه “فليس مطلوباً أي تغيير لا يحقق أو لا يمهد للإصلاح” .
وكأن مهمة التغيير إزالة العوائق من أمام الإصلاح فقط، أي كأن عملية التغيير تابعة لعملية الإصلاح، بعيداً عن خطاب الثورة والتغيير، وكأنني أراه يربط التغيير بالثورة وبالعنف السياسي والاجتماعي، التي شهدتها المنطقة العربية وبعض دول العالم النامي المتحرر، ووقفت بالثورة أو بعملية التغيير في منتصف الطريق، فلا هي استكملت خلالها الثورة شروطها، ولا تحقق الحد المطلوب من الإصلاح المرتجى، وواضح هنا أن الباحث الأستاذ قاسم الوزير، له رؤية معرفية فكرية وثقافية وسياسية خاصة به، وليس عفواً واعتباطاً، بل هو تأكيد للمنزع الاستقلالي الذاتي في التفكير، كما رسخ وتأسس في ذهنه وتفكيره، وليس نقد الرؤيتين الفلسفيتين المثالية البرجوازية، والمادية الماركسية، سوى أحد ملامح وأبعاد هذا التفكير الاستقلالي الذي يضع أو يموضع قاسم الوزير على عكس من آخرين ضمن منظومة معرفية فكرية خاصة به، ومن يشابهونه ويلتقون معه في منطق التفكير، وهو موقف وتفكير شجاع وجريء يعكس روح ومنزع الاستقلالية الذاتية في منطق تفكيره، بصرف النظر عن الاتفاق أو الاختلاف في مبنى ومعنى رؤيته التي لها كل التقدير، على الأقل أنه اجتهد معرفياً في تأكيد نزوعه الذاتي الاستقلالي في الرؤية والتفكير، وهذا يحسب له، وفي هذا المسعى والسياق نجده يقدم تعارضه ومفاهيمه ومصطلحاته الخاصة حول جملة من المفاهيم والقضايا على سبيل المثال:
فتعريفه للجهل: تعريف معرفي: “أنه مشكلة ترتبط بقضية التخلف والقضاء عليه، مشكلة ترتبط بقضية التقدم.. (…)، وإذن لكي تقضي -مثلاً- على الجهل، فلا بد أن تكون منطلقاً من “واقع فكري” مختلف نوعاً عن ذلك الواقع الذي أنتجه الجهل أو أنتج هو الجهل، وإلا فهو العجز أو الانتقال من ضرب إلى آخر من ضروب الجهل دون تجاوزه، أي بمعنى آخر أن الجهل هو مشكلة تخلف، وبديله مشكلة تقدم” .
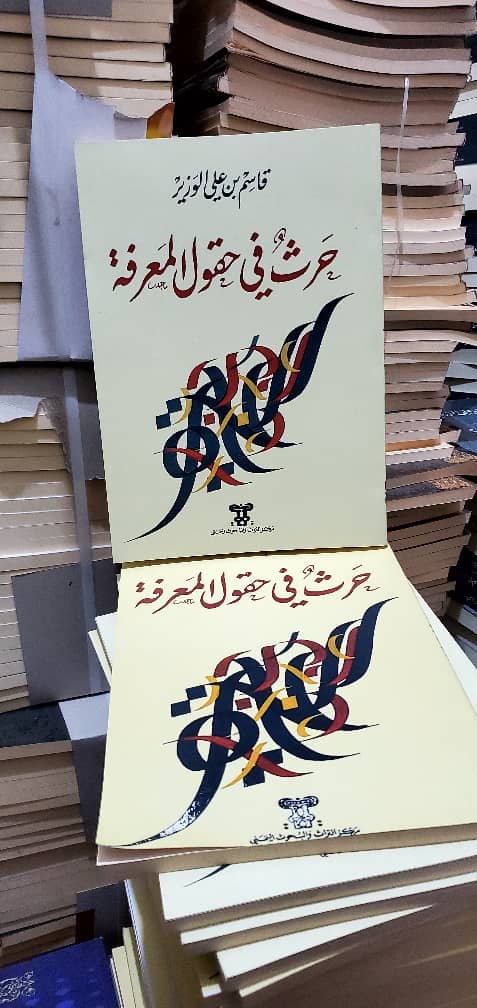
وكأنه ضمناً يقول إن الجهل صناعة سياسية اجتماعية، وتجاوزه لا يكون إلا بمشروع فكري سياسي بديل، أو حسب تعبيره “واقع فكري” مختلف ينقض حالة التخلف المنتجة للجهل. وسواء اتفقت أو اختلفت مع رؤية الأستاذ قاسم الوزير، في تفاصيل رؤيته وفي منهج بحثه “المستقل”، فإنك تجد نفسك متفقاً معه كلية في تركيزه على دور الإنسان، وضرورة استعادته لمكانته وماهيته كفاعل إنساني، وبدونه -أي الإنسان- لا حرية ولا كرامة إنسانية للفرد وللمجتمع.. وبدونه لا إصلاح ولا تغيير ولا تنمية، فالإنسان وحده هو أداة التغيير وغايته، وهو ما تهدف إليه ضمناً ومباشرة وقولاً جميع الفلسفات بصرف النظر عن تجليات ذلك في واقع الممارسة العملية السياسية، وهو ما يشير إليه ابن الوزير قاسم في ثنايا قراءاته/ محاضراته .
فهو يكتب قائلاً: “إن التجربة البشرية المتنوعة تمدنا بأمثلة شتى على ذلك، في طليعتها الرسالات السماوية التي بدأت كلها بشخص أو كلمة.. ثم عم نورها الأرجاء.. وكذلك هي الحركات الكبرى في التاريخ، بصرف النظر عن بواعثها: الأفكار أو وسائل الإنتاج إنما تبدأ بفكرة من شخص.. ثم تنتشر فتصبح حركة في التاريخ. فمؤسس “الماركسية” -كما يقول- شخص عبر عن فكرته ودعا إليها مع زميل له، فانتشرت وأوجدت لها مؤمنين حولوها إلى دعوة وإلى حزب، ثم إلى حركة أثرت بشكل أو بآخر على العالم المعاصر.. وليس هنا ما هو أكثر خطأ وأبعد عن معايير الصواب والصحة وأوغل في الضلال البعيد من الصهيونية” .
إن ما أرغب في تأكيده في ختام هذه التناولة، أن الباحث الفقيد قاسم الوزير، وهو في سياق تأكيده لدور الإنسان، ومن أنه أداة فعل، وغاية في الوقت نفسه، فإننا نجده يعطي “الثقافة” و”الفكر” دوراً وتأثيراً أكبر وأهم من دور وتأثير ومكانة الوجود الاجتماعي في العلاقة بين الفكر والواقع. ويمكنكم العودة إلى متن البحث/ المحاضرات، وهو هنا يلتقي مع الرؤية المثالية الموضوعية ضمن الرؤية الفلسفية العامة لها، وهو حقه في الانحياز المعرفي والفلسفي، حيث لا يمكنك في القراءة/ الرؤية الفلسفية، للذات وللفكر وللوجود وللحياة عامة، سوى أن تكون إما مع الفلسفة المثالية بتعبيراتها المختلفة (ذاتية/ موضوعية)، أو مع الفلسفة المادية (الاقتصادية/ أو المادية الجدلية التاريخية)، من أي موقف أو موقع فكري/ أيديولوجي، انطلقت: وطني، قومي إسلامي، ليبرالي، يساري.
وهناك العديد من المفاهيم والأفكار التي بحثها قاسم الوزير، بعقل الباحث المستنير العقلاني النقدي، والتي تؤكد منزعه أو نزوعه المعرفي والفكري الاستقلالي في الرؤية للذات، وللواقع، وللآخر، لا يتسع لها هذا المقام والمقال. وفي ختام فقرة الاستقلالية في التفكير، من المهم التأكيد أن حالة الاستقلالية في الفكر وفي المعرفة عموماً هي استقلالية نسبية، فحركة وعملية التفاعل الذاتي، والإنساني للفرد والجماعة على مستوى المعرفة والفكر، والحضارة، هي حالة مستمرة في التفاعل والتلاقح والتكامل، وتبقى حدود الاستقلالية في حدود الظاهرة أو الحالة النسبية، ذلك أن قاسم الوزير نجد تفاعله المعرفي، والفكري مع رواد النهضة العربية المعاصرة، ومع غيرهم من التيارات والاتجاهات المعرفية والنظرية والفكرية، مايزال قائماً ومستمراً وإن بصورة فكرية وإبداعية تعكس المرحلة التطورية والحضارية التي تعيشها اليمن والمنطقة العربية والعالم، فهو لم يقف عند أسئلة النهضة كقضايا معرفية، بل هو ربطها -كما سبقت الإشارة- بشروطها وقوانينها وسننها، كما سماها ابن الوزير، والتي أخذ بها ودعا للأخذ بها، وهذا بحد ذاته شكل من أشكال الاستقلالية في التفكير.
رؤيته للآخر المعرفي والفكري والسياسي
من يتمعن في الفقرة السالفة حول قاسم الوزير والاستقلالية في التفكير، سيجدها ملتحمة أو مرتبطة بفقرة الموقف من الآخر المعرفي والفكري والسياسي، فالاستقلالية في التفكير وفي الفكر، لا تعني القطيعة، أو العدمية والانفصال المطلق عن الآخر على أي مستوى كان ذلك الآخر.. الآخر الذات (الشخص) أو الآخر المجتمع (الواقع) أو الآخر الفكرة. وفي الحقيقة إن ما استدعاني لتقديم أو مقاربة هاتين الفقرتين أو العنوانين، إنما هو مطالعتي لشعر قاسم الوزير، وتحديد اطلاعي لفكره ورؤيته الموزعة على محاضراته التي قدم معظمها في “مركز الحوار العربي”، وفي غيره من المنتديات الفكرية، وللباحث قاسم الوزير يعود الفضل في أنه فتح ذهني على مقاربته، وأن أبحثه من خلال هذين العنوانين/ المبحثين، اللذين أجد معناهما حاضراً في متن وسطور كتاباته/ محاضراته.
في تقديري أن قاسم الوزير ذو بصيرة نافذة تنظر للبعيد، له تجربة حياتية وتجربة معرفية عميقة وواسعة، هو -حقاً- باحث يمتلك أدوات البحث، إلى جانب لغة أدبية وفكرية رصينة وسلسة، يطوعها في الإنتاج البحثي والفكري الذي يريد، دون إنكاره انحيازه وتوافقه مع رؤى بعينها يجد نفسه فيها، أو قريباً منها، ويسعى جاهداً لتقديمها وتعميم نشرها بصورة جديدة تستوعب قضايا العصر الراهن في صورة أعمال رموز النهضة العربية في صورة المفكر العربي الإسلامي/ القومي (القومية الإسلامية)، جمال الدين الأفغاني، والإمام المجتهد الإصلاحي محمد عبده، والمفكر المعاصر/ التنويري بامتياز “مالك بن نبي”، الذي نجده حاضراً في العديد من صفحات كتاب “حرث في حقول المعرفة”، فقد استوعبه إبداعياً، وعرض أفكاره وتبناها بصورة خلاقة، مضيفاً إليها ما عنده وما يمتلكه من رؤى خاصة به، ولذلك أكرر القول: إننا مع قاسم الوزير، نجد أنفسنا أمام شخصية معرفية وفكرية وسياسية متميزة، قرأ واستوعب الرؤى الأخرى الفلسفية المثالية والمادية، وغيرها من الرؤى والنظريات، استوعبها وهضمها وتمثلها إبداعياً في معظم ما كتب، وهذا يعكس المنحى الإبداعي النقدي في عقله، الذي يستوعب ويتمثل ويفهم الآخر المعرفي والفكري والسياسي، بل ويتفهمه، ولا يصطنع قطيعة عدمية مع كل ذلك الآخر، وبخاصة الآخر على المستوى الوطني اليمني والعربي، بل حتى من لا يتفق معهم فلسفيا وفكريا ومذهبياً ودينياً.
وقد مررنا في عرض سريع كيف تعاطى وفهم الفلسفات الأخرى، وقدم خلاصة اجتهاده وفهمه لها بعيداً عن الأفكار الحدية والقطعية، والأحكام الإطلاقية القاتلة.. يختلف وينقد من موقع الاعتراف بالآخر، وبحقه في أن يكون ما يريد، بل وبحقه في الخطأ، وهو بحد ذاته موقف فلسفي، ومعرفي وحياتي متقدم إنسانياً على الكثيرين ممن يدعون الحداثة والتقدمية والثورية.
والسبب في ذلك -كما أتصور- يعود لجملة عوامل ذاتية وفكرية واجتماعية وتاريخية.
إن الموقف المفتوح والمتسامح مع الآخر، والقبول بالتعدد والتنوع والاختلاف، بدأ مبكراً في تفكير بيت الوزير (الأبناء) في صورة الأساتذة: إبراهيم الوزير، وزيد الوزير، وقاسم الوزير، وعباس الوزير، الذين برزوا وظهروا في المشهد الفكري والثقافي والسياسي، وجميعهم كانوا على صلة حية وعميقة بالفكر الزيدي الاجتهادي -بهذه الصورة أو تلك- وكان لتجربة حركة 1948م الدستورية وما صاحبها من فشل ومن إعدامات وسجون ومرارات عاش الإخوة من أبناء الوزير -كما غيرهم- قسوتها وبشاعتها في سجون “قروسطية”، هي الوجه العملي لمعنى الموت في الحياة.
إن هذه التجربة على عنفها ومراراتها، أكسبتهم خبرة معرفية وحياتية بالناس، وبالأفكار.. تعلموا منها الكثير، ولم يأتِ تشكيلهم لحزب “اتحاد القوى الشعبية”، 1961م، في صيغته الوسطية، والذي جمع في داخل بناه التنظيمية، أطيافاً متعددة من القوى الاجتماعية والسياسية والطبقية، ومن الاتجاهات الفكرية المختلفة من الوسط المعتدل، ومن وسط اليمين الفكري والسياسي، ومن الأسماء القومية، ومن اليسار -دون ذكر أسماء- وكان ذلك بعد خروجهم من السجن ووصولهم إلى عدن وإلى مصر، وبعد ذلك إلى أمريكا وبريطانيا، ووقوفهم كتنظيم “اتحاد القوى الشعبية” في حالة وسط بين الجمهورية والملكية (الدولة الإسلامية)، فلا هم مع الجمهورية القائمة إلى النهاية بسبب ملاحظاتهم على عنف الثورة كما يقول البعض، ولا هم مع عودة الإمامة التي فقدت صلاحيتها وشرعيتها التاريخية على الصُّعدِ كافة.
ويمكنني القول إن قاسم الوزير، عليه رحمة الله، هو الأكثر اشتغالاً بالفكر التنويري الحداثي المعاصر في اليمن، وفي المنطقة العربية، وكذلك الأستاذ زيد الوزير، كما يمكنني رد تلك الحالة من القبول بالآخر والمغاير بين أبناء الوزير -كذلك- إلى أنهم كأسرة وأبناء جاؤوا من خليط اجتماعي أسري يعكس المشترك الوطني والاجتماعي اليمني، من أب من أسرة علوية “هاشمية” لها مقامها الاجتماعي والسياسي الكبير في هذا الوسط، ومن أم قحطانية ومن أسرة قبلية (آل أبو رأس) لها مكانتها، ودورها في الوسط القبلي والاجتماعي والوطني العام، وهذه الخلطة الاجتماعية الوطنية قطعاً تركت أثرها فيهم، وشكلت عاملاً مساعداً إضافياً في تحررهم من ضغوط أيديولوجية “الهاشمية السياسية”، وهو ما يقوله كل مسار حركتهم الفكرية والسياسية -اللاحق- حتى تأسيسهم لصحيفة “الشورى” التي يمكنني القول إنها شكلت علامة فكرية وسياسية وإعلامية مضيئة في الحياة الصحافية اليمنية المعاصرة، صحيفة، وحزب استوعبا في إطارهما الرموز الفكرية والسياسية والإعلامية من كل اتجاهات الوطن، وهو أمر وتوجه نبيل يحسب لهم (الأسرة/ الأبناء)، والأهم أنه يؤكد بالفعل وليس بالقول انحيازهم الفكري والسياسي والعملي لخيار التعددية والقبول بالآخر في واقع الممارسة، والوقوف مع وفي صف المدنية والمواطنة والحداثة والتحديث، وهو المنحى أو البعد الذي أجده عندهم جميعاً بدون استثناء، ويمكن أن تكون اشتغالات الفقيد قاسم الوزير بقضايا وإشكالات الفكر المعاصر، والنهوض العربي خصوصاً، هي التي قد تعطي انطباعاً غير دقيق من أنه الأكثر قبولاً بالآخر، وبالحداثة، على أن الشيء الأكيد أنه الأكثر تماساً وتمثلاً لفكر الحداثة على الأقل في نتاجه البسيط أو المحدود الذي وصل إلينا مما تم جمعه ونشره.
تقديري أن حالة القبول بالآخر، والتسامح هي حالة يتوحد ويلتقي عندها الجميع؛ أقصد الإخوة/ الأبناء، وما يؤكد هذا المعنى هو اشتغالهم جميعاً بالإنتاج المعرفي والفكري والثقافي والسياسي الإصلاحي والتنويري، الذي يؤكد هذا المعنى الذي نذهب إليه، وقاسم الوزير في طليعتهم. وجدت نفسي مضطراً أو أمام طريق إجباري وأنا أكتب عن موقف الأستاذ قاسم بن علي الوزير من الآخر، في الفكر، وفي السياسة، أن أبسط هذه المقدمة أو الخلفية الذاتية والتاريخية لإجلاء الصورة أكثر حول الموقف المفتوح والتعددي في موقف قاسم الوزير -وجميع إخوته- من الآخر ومن المغاير في الوطن وفي خارجه، أي الآخر في الذات وفي الواقع وفي الفكر.
وقد وجدت هذا الموقف جلياً وواضحاً في صفحات كتاب “حرث في حقول المعرفة”، وكنت أتمنى لو يتم جمع كل مساهمات الأستاذ قاسم الوزير في هذا المضمار؛ حتى يتمكن المهتمون والاختصاصيون من الاطلاع عليها، وتقديم ملاحظاتهم أو قراءاتهم حولها، على أنني أجد في الكتاب المشار إليه ما يفي بالغرض، ويقدم صورة واضحة عن منطق ومنهج تفكيره حول موقفه المتميز والمستنير من الآخر في الفكر، والآخر في الواقع وفي الحضارة التي يسهم الجميع في بنائها كلٌ من موقعه وموقفه، حيث هو يقف ويفكر.
وهنا أجد لزاماً عليّ لتوضيح موقف قاسم الوزير من الآخر في الفكر وفي السياسة وفي الواقع، أن أعود إلى ما دوَّنه من محاورات ومحاضرات حول ذلك، وكلها مرتبطة ومنطلقة من سؤال النهضة العربية في تجلياتها المعاصرة.
إن تتبع أو متابعة كل تفاصيل موقف الباحث قاسم الوزير من الآخر بمستويات هذا الآخر المتعددة والمختلفة، كما وردت أو كما احتواها كتابه “حرث في حقول المعرفة”، قد لا يكون متاحاً أو ممكناً في مثل هذه القراءة الاستعراضية، لأن ذلك قد يستغرق كتاباً موازياً، على أنني سأحاول أن أركز وأقف عند بعض ما يشير ويدل على ذلك في رؤيته وفي منطق تفكيره، باختيار بعض القضايا المعرفية، والفكرية ذات الطابع الإشكالي التي تناولها بعقل إبداعي نقدي مفتوح، والتي تقول لنا فصل الخطاب في موقفه من الآخر المعرفي والديني والحضاري.
وما أثار انتباهي وإعجابي معاً في معالجاته النظرية وفي منهج تفكيره، هو موقفه من الحضارة الغربية، وهو المثقف والباحث الذي وجدته أو رأيت فيه أنه يجمع بين الوطني اليمني، والإسلامي النهضوي المستنير، والقومي العربي التحرري، القريب في الفكر العام من اليساري التقدمي -بهذه
الصورة أو تلك- وذلك حقيقة هو ما خرجت به من اطلاعي على كل ما كتبه في الشعر والنثر (الفكر)، وهذه الخلطة السحرية الجامعة بين الوطني والقومي اليساري والإسلامي المتنور والأممي الإنساني، هي -في تصوري- ما يفسر ويشرح سعة أفقه المعرفي والفكري في النظرة للذات وللآخر وللواقع.
وأتصور أن قاسم الوزير اليوم، في ما أنتجه من معرفة وفكر، هو من الأسماء النادرة يمنياً وعربياً في هذا الاتجاه، بعد أن أصبح التعصب والانحيازات الأيديولوجية الحدية، في الفكر والسياسة، عنواناً للمرحلة، وواقعاً قائماً في بلادنا، بخاصة بعد عودة المذهبية والطائفية والإمامية، والقبلية والجهوية والمناطقية في صيغتها المليشياوية متسيدة ومهيمنة على المشهد الفكري والثقافي والسياسي، ليس في بلادنا فحسب، بل وفي كل المنطقة العربية -بدرجات متفاوتة- وهنا في تقديري تكمن قيمة موقف قاسم الوزير من الآخر، الذي سنأتي على بعض معانيه المعرفية، ذلك أن البحث عن الآخر، في الموقف المعرفي والفكري والثقافي والسياسي، هو خلاصة الخلاصة لقراءة الذاتية الإنسانية في رحلة بحثها عن نفسها، وفي موقفها من الآخر، عند هذا الباحث أو ذاك، ومن هذا المنظور والخلفية سأحاول تقديم مقاربة -موجزة ومكثفة- معرفية/ فكرية للأستاذ قاسم الوزير في موقفه المعرفي والفكري من الآخر -كما سبقت الإشارة- من خلال بعض المفاهيم والأفكار والقضايا الإشكالية التي تناولها في كتابه.
قاسم بن علي الوزير، لحظة متحولة ومتطورة، جامعة -كما سبقت الإشارة- بين الوطني والقومي والإسلامي المتنور، يرى الإسلام في خلفيته الثقافية والحضارية ضمن رؤية ومنطق لكل مسلم، ولكل إنسان (دينه الخاص)، والقومية “العروبة”، في خلفيتها الحضارية الإسلامية، تجمع كل العرب، في نطاقها/ نطاقهم الوطني/ القومي الحضاري الشامل (الحضارة الإسلامية)، وهو منطق تفكير نقدي وتقدمي في حركته التاريخية، نجد تمظهره الأكمل مع مالك بن نبي، كما نجده عند غيره من رموز النهضة القومية العربية الأوائل، من المسيحيين العرب -وهم كُثر- الذين حملوا لواء نشر فكرة وقضية النهضة القومية العربية بعيداً عن العصبوية الإسلاموية (الإخوانية/ والسلفية الدينية).
وبهذا المعنى أجد الباحث قاسم بن علي الوزير، يدخل ويندرج ضمن هذه الأسماء وهذا الرعيل من الباحثين -بهذه الدرجة أو تلك- ومن هنا رفضه وكراهته للتعصب المذهبي والديني والقومي والقبلي من باب أولى، بقي يفكر ويتحرك ضمن منطقة جامعة من الفكر ومن الحركة.
وفي هذا السياق نجده يكرم ويعظم دور “مكرم عبيد” القبطي المسيحي، أحد أهم أقطاب (حزب الوفد) في مصر، الذي دعا رئيسه، ورئيس وزراء مصر، في حينه، مصطفى النحاس، إلى ضرورة تأسيس “الجامعة العربية”، من الدول المستقلة في ذلك الحين، وقبل إعلان قيام الجامعة العربية بعام من ذلك التاريخ، أي في عام 1944م، وهو الحزب المصري، الذي جمع بين الوطنية المصرية “البرجوازية”، والقومية العربية، والذي أكد على أن “الدين لله والوطن للجميع”، ضمن شعار “الهلال مع الصليب”، في قلب الثورة المصرية التحررية 1919م.
وفي هذا السياق، يورد الأستاذ قاسم الوزير، بعض ما قاله مكرم عبيد: “أنا قبطي -مسيحي- حضارتي -حضارته- الإسلام”، أي أنه احتفظ بهويته الدينية الخاصة، في إطار خلفيته الثقافية والحضارية الإسلامية.
وفي هذا السياق يرى قاسم الوزير أن سقوط أو فشل قضية الوحدة العربية، أنها ارتبطت بالأوهام الأيديولوجية، وبدون مشروع ملموس لبناء الدولة، وبهذا المعنى هو لا يدين الوحدة العربية في ذاتها ولذاتها، بل المدعين بالوحدة بدون رؤية ولا مشروع لقيام دولة الوحدة، ودليله على ذلك تجربة دولة الاستقلال الوطنية والقومية، التي تحولت إلى استبداد، ولم تقطع علاقات التبعية بالغرب الاستعماري وحضارته الاستبدادية التي تقاطع معها في أكثر من مكان طيلة القرون الستة الماضية وحتى اللحظة.
ومن هنا قراءته النقدية المعرفية للحضارة الغربية، ورؤيته الخاصة للحضارة العالمية الإنسانية الواحدة المنشودة، ونظرته لها ليس باعتبارها آخر ونقيضا لنا كعرب وإسلام، كما نطالع ذلك في بعض كتابات الإسلام السياسي المعاصر باتجاهاته المختلفة (الإخوانية، والسلفية، والجهادية التكفيرية)، وكما نجد ذلك في نظرة بعض القوميين العصبويين (الشوفينيين) أو نظرة الأيديولوجية اليسارية المتطرفة.
فهو لا يقيم في قراءته المعرفية/ الفكرية سوراً لا إنسانياً (جغرافياً أو عرقياً أو أيديولوجياً) بين الشرق والغرب، بين الإسلام والمسيحية تحديداً، ولا مع أي دين، ومن أنهما -أي الشرق والغرب- لا يلتقيان كما هي عند بعض الفلاسفة والمفكرين العنصريين الغربيين، المعادين جملة للآخر بما فيه الآخر الإسلامي، وإنتاج البعض لأيديولوجية “الإسلاموفوبيا”.
ومن خلال قراءتي المعرفية والفكرية أراه يقف منفتحاً ومتسامحاً مع الآخر، الآخر في الداخل الوطني اليمني، والآخر القومي، والديني (الأجنبي)، دون تعصب ولا انحيازات أيديولوجية مسبقة، ومن هنا رؤيته المتميزة لمفهوم الآخر في صورة المسيحية واليهودية كأديان، وكذا موقفه المتفتح من الغرب، وتحديداً من الحضارة الغربية، فرؤيته المعرفية والفكرية والسياسية تفرق بين الحضارة الغربية كحضارة، وبين “المركزية الغربية الاستعمارية”، فهو كما يكتب ويعلن ذلك، من أنه ضد الاستعمار، وليس ضد الحضارة الغربية، ولكم أن تعودوا حول ذلك إلى كتاباته/ محاضراته التي ألقاها في “مركز الحوار العربي” في واشنطن/ أمريكا.
بالنسبة لابن الوزير، من المهم، عنده، بل يجب التفريق بين النظام الرأسمالي، وبين الحضارة الغربية.
فعلى سبيل المثال، هو يتساءل: “عن أي غرب نتحدث؟”، أن أوروبا شرق بالنسبة لأمريكا واليابان غرب بالنسبة لأمريكا، ولكنها شرق بالنسبة لأوروبا، والعالم الإسلامي شرق هنا وغرب هناك. ومادامت الأرض كروية فإن الغرب والشرق جغرافياً هما أمر نسبي تبعاً لمطلع الشمس ومغربها (…)، فهناك إذن في الواقع أكثر من شرق وأكثر من غرب، ويتساءل ما هو المقصود بالحضارة الغربية؟ ويقول: لا يمكن أن نعثر على إجابة صحيحة إذا حصرنا البحث في مكان جغرافي منعزل، أيَّا كانت تسميته، أو جنس معين أيَّا كانت دعواه.. وإنما تصدق الإجابة حين نبحث عنها، إما في “المجال الحيوي” مع “توينبي”، أو ما نسميه “حقل الدراسة”، أو مع “بن نبي” على مستوى حضارة، ضمن نظريته في “النشاط المشترك” المولد للحضارة في إطار مفهوم الدورة التاريخية لها عنده أو في منطقة “فكر” كما عند “ماسيس” Massis الذي نختار هنا تعريفه للغرب، إذ يقول: “إنَّ الغرب فكرة تعني شيئاً تشير إليه” .
ويوضح ذلك أكثر من تقديمه لتعريف روجيه جارودي حول مفهومه للغرب: “الغرب إذن ليس تعريفاً جغرافياً، ولكنه بتلك المجموعة من القيم والقوى والثقافات والماديات التي تميزه كحضارة متقدمة في الوقت الراهن” ، أي أن صفة التقدم في الحضارة -أية حضارة- مرتبطة بالدور وبالقيم، أي بالإنجاز الحضاري الإنساني، وليس صفة مطلقة بهذه الحضارة أو تلك، اليوم البعد والعمق الاستعماري في الغرب الرأسمالي -النيوليبرالي- يحاول أن يوظف منجزات الحضارة/ العلم لصالح إعادة إنتاج وتنمية الظاهرة الاستعمارية، في صورة فرض استمرار هيمنة النظام الأحادي القطبية.
أي أن الحضارة الغربية في عقل وفكر قاسم الوزير، ليست هي جغرافية ولا عرقا ولا هي دينا “المسيحية”.. الحضارة الغربية عنده بقدر ما هي موضوعياً واقتصادياً نتاج بنية رأسمالية متطورة، فإنه من الصعب اختصارها أو اختزالها في الصيغة المسيحية، كما هي عند بعض المفكرين، هي باختصار -كذلك- خلاصة إنسانية للحضارات العالمية وللإنتاج المعرفي والمادي الإنساني المشترك للبشرية جمعاء على طريق إنتاج وصناعة حضارة عالمية إنسانية واحدة، وهو ما ألمح إليه بوضوح معرفي وفكري قاسم الوزير، قائلاً: “علينا أن ندرك أن هذا الميلاد -أي للحضارة- ليس انبثاقاً من العدم، وإنما هو سلالة من رحم حضارة سابقة أدركتها الشيخوخة فأسلمت ميراثها -ويمكن القول بعض جيناتها أيضاً- إلى حضارة جديدة عبر اطّراد تاريخي يتضمن جملة الشروط والظروف في مجتمع معين هو بحكم ذلك -على وجه الدقة- حاضنة هذه الحضارة الوليدة التي تنتسب إليه.
إن الحضارة ليست دوائر مغلقة، ولا كل حضارة جزيرة مستقلة بذاتها عن الحضارات الأخرى السابقة أو اللاحقة، إن الحضارة تفاعل مستمر وتواصل متداخل “تأثراً وتأثيراً” وامتداد من سابق للاحق على أكثر من وجه، وليست الحضارة الغربية بدعاً بين الحضارات، بل هي واحدة من هذه السلالة التاريخية التي أبدعها الإنسان” .
إن هذا الوعي والإدراك والفهم المعرفي والفكري الحضاري في عقل قاسم بن الوزير، هو الذي يقول لنا بوضوح مدى سعة، وعمق رؤيته وتفكيره المفتوح على الآخر: الآخر الذات (الإنسان)، الآخر الواقع (المجتمع)، والآخر الفكرة.
لم تتشكل هذه الرؤية المعرفية والفكرية والواقعية المتقدمة من الآخر عند قاسم الوزير صدفة أو فجأة، بل من خلال اطلاع واسع وعميق، أولاً بالتراث الفكري والفقهي، وبالتاريخ السياسي والاجتماعي العربي الإسلامي، وصولاً إلى استيعابه فكر رواد النهضة العربية وأسئلتهم الحائرة، فضلاً عن اطلاعه على نتاج رواد الفكر التنويري العالمي، حول قضية وقصة الحضارة كما هي عند “ويل ديورانت” و”توينبي” و”اشبنجلر”، وقبلهم جميعاً بقرون طويلة رؤية ابن خلدون الاجتماعية والتاريخية حول فلسفة التاريخ .
إن قاسم الوزير يدعونا في كل ما كتبه وفي محاضراته، على قلة ما وصل إلينا من نتاجه، إلى أهمية وضرورة الاقتراب من الآخر، معرفته وفهمه وتمثله واستيعابه نقديًا، كذات وواقع وحضارة، بعيدًا عن الذوبان فيه، وبعيدًا كذلك عن إنكار وجوده من خلال رفضه العدمي (السلبي) دون معرفته، وهو ما أنتج عند البعض حالة أو ظاهرة “الخصوصية” الفارغة من المعنى.
أو ما يسميه البعض “الأصالة والمعاصرة” ضمن منطق تفكير تابع وملحق بالآخر الاستعماري، لم ينتج في الواقع “أصالة” ولا “معاصرة”، بل تكريس التبعية أكثر فأكثر، وهو ما نعيشه حتى اللحظة. ولذلك نجد أنفسنا نكرر لوك كلام عن “الخصوصية” و”الأصالة والمعاصرة” في واقع قبول بالاستعمار وتبعية اقتصادية وسياسية له، وهو ما يسميه قاسم الوزير “عقدة الخوف” و”عقدة النقص”، داعيًا العرب إلى “المشاركة الإيجابية في إنجازات الحضارة العالمية العامة القائمة” . وهذا المعنى ذاته هو ما يطلق عليه مالك بن نبي “القابلية للاستعمار”، وضرورة الانتقال للمشاركة الفاعلة في صناعة الإنجاز الحضاري العالمي، من موقع الند، وليس التابع.
وفي هذا السياق، يرى قاسم الوزير أن سقوط الوحدة العربية كسياسة ونظام حكم ودولة، يرتبط بتلك التبعية والتقليد للآخر، ومن أننا لم نمتلك رؤية ولا مشروعا، وبالنتيجة لم نمتلك الأدوات العملية لإنجاز الوحدة. وحدة ارتبطت بالأوهام، والأسوأ العمل ضدها، أي ضد الوحدة، في واقع الممارسة. وبهذا المعنى، فإن قاسم الوزير في رؤيته ومحاضراته لا يدين الوحدة، بل المدعين زورًا بالوحدة. ولذلك كان يكتب حتى لحظة رحيله أن مشكلتنا ليست مع الغرب ولا مع الحضارة الغربية (كحضارة)، بل “ضد الاستعمار وفلسفته المنحلة اللا أخلاقية” .
ومن هنا تأكيده على القطيعة مع الاستعمار، ورفض هيمنته في واقع الممارسة. نقبل بالحضارة نعم، على أن الأهم أن نتحول إلى مشاركين فاعلين في إنجازاتها، وذلك لن يكون إلا بالعودة الواعية للذات، والاندماج بمصالح مجتمعاتنا على طريق بناء الدولة المدنية الديمقراطية التي تتسع للجميع على قاعدة المواطنة، من خلال مشروع نهضوي وطني/ قومي بآفاق تقدمية إنسانية.
ذلك أن رؤيته “لتصفية الاستعمار” “لا تعني تصفية وجوده العسكري ومؤسساته فقط، ولكن بشكل أهم تصفية ثقافته وفلسفته ومنطقه، ليس في البلدان التي نكبت به فحسب، وإنما في عقر داره أيضًا (…)، تصفية الفكر الاستعماري (الاستعلائي العدواني) لدى المستعمر، وتصفية الشعور الانهزامي (الدوني الاستسلامي) والانتقامي لدى المُستعمر، ولكل من الأمرين شروطه وأسلوبه بحيث ينشأ عالم جديد” .
وهي دعوة فكرية وسياسية وعملية لميلاد نظام عالمي جديد متعدد القطبية، وهو ما نراه ونطالعه أمامنا اليوم في صورة الطوفان الفلسطيني/ غزة، وحرب الإبادة، وفي صورة الحراك الطلابي العالمي، واصطفاف العالم كله مع غزة، باعتبارها مقاومة للاحتلال والاستعمار. وقاسم الوزير بموقفه ذلك يؤكد أنه لا يرفض الحضارة، بل يرفض الاستعمار وهيمنته.
ومن هنا تأكيدي في أكثر من موضع على أن الفقيد قاسم الوزير لحظة متطورة جامعة بين الإسلامي التنويري النهضوي والقومي التحرري واليساري التقدمي، على طريق ميلاد حضارة عالمية إنسانية واحدة، تجمع الشرق والغرب، الشمال والجنوب، على كل التناقضات الموضوعية والاقتصادية والطبقية التي تبرز في سياق صناعة وإنتاج هذه الحضارة في طابعها الإنساني الواحد، على قاعدة التعدد والتنوع، والقبول بالآخر المغاير، الوحدة في إطار المغايرة، أي القبول بالآخر المختلف كما هو.
ولا أجد الشاعر والمثقف والباحث، قاسم الوزير، إلا داعيًا لهذا التوجه بعيدًا عن التعصب المذهبي/ الديني والطائفي وبعيدًا عن الشوفينية القومية والقبلية والجهوية والمناطقية.
ويبقى موقفه المقاوم ضد الصهيونية وضد التطبيع واضحًا ومعلنًا بعيدًا عن شعار “الموت للغرب ولأمريكا وإسرائيل”، مؤكدًا على معنى المقاومة، ورافضًا المساومة والاستسلام باسم “السلام”، بعد وضع البعض “المفاوضات” ضد “المقاومة” وفي مواجهتها.
هذه باختصار هي تحيتي وقراءتي للفقيد قاسم بن علي الوزير، شاعرًا وناثرًا (مفكرًا)، وهي لا تصل إلى مستوى القراءة البحثية المعمقة لما كتبه، ولما يستحقه، شعرًا ونثرًا، على أنها جهد المحب للمعرفة والفكر، ولمن ساهموا في إثراء حياتنا بالجديد والمثمر والمفيد.
هي قراءة أكدت على معنى الاتفاق مع الكثير مما كتبه الفقيد، وتبقى هناك بعض التفاصيل الصغيرة المختلف حول معناها ومبناها، وهذا أمر طبيعي في الحوار بين الأفكار، وإلا تحولنا إلى نسخة وطبعة “دوجما”، مكررة من بعضنا البعض تتوقف معها المعرفة الإبداعية عن الإنتاج.
كان قاسم الوزير ينتظر شروق الشمس من عتمة طال ليلها، على أنني أتصور أنه ودع اللحظات الأخيرة من تعب الجسد بفرح العظمة الأسطورية الصاعدة من غزة/ فلسطين، باتجاه صناعة وصياغة ميلاد عالم جديد متعدد القطبية، يوسع من نطاق مساحة الاعتراف بالآخر، على قاعدة حضارة عالمية إنسانية واحدة يشترك الجميع في صناعتها.
- قادري أحمد حيدر
- مدير تحرير مجلة “دراسات يمنية”، صادرة عن مركز الدراسات والبحوث اليمني/ صنعاء






