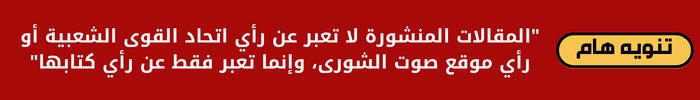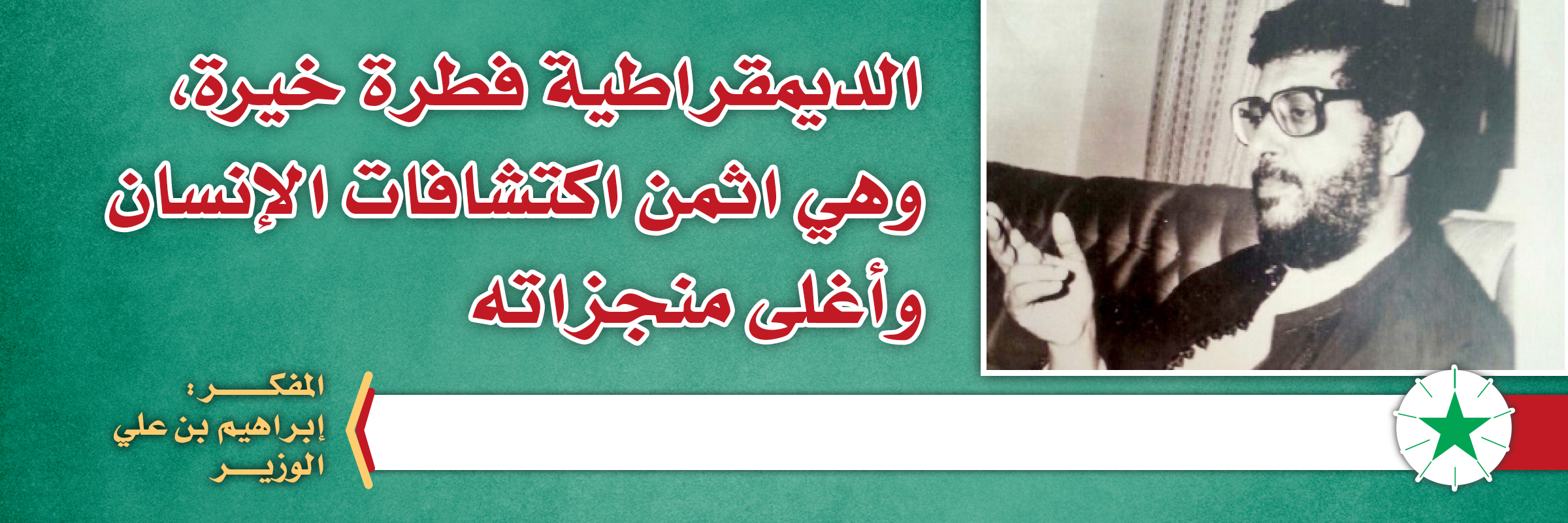في أفق المجاز والتأويل نطالب بإعادة قراءة النص الديني (القرآن)

في أفق المجاز والتأويل نطالب بإعادة قراءة النص الديني (القرآن)
- بقلم: حسن الدولة
الاحد13يوليو2025_
في زمن تتصاعد فيه تحديات الفهم الديني وتتسع فيه الهوة بين ظاهر النصوص ومقاصدها الباطنية، تبرز الحاجة المُلحّة لإعادة قراءة النصوص الدينية قراءةً تأويلية، تحيي المعنى، وتستنطق السياق، دون أن تسقط في فخ التفكيك العدمي أو التقديس غير المبرر.
كنتُ قد نشرتُ في مثل هذا اليوم الموافق 13 يوليو 2016م تأملا موجزا في صفحتي الشخصية بشأن ضرورة إعادة قراءة النصوص الدينية من خلال منهج الشك اليقيني، لا بقصد الطعن أو الهدم، بل من أجل تقوية الدين نفسه، عبر إسناده إلى مرجعية العقل بوصفه الأداة التي بها يعرف صدق النبوة، وتفهم دلالات الوحي. وقد قال حجة الإسلام “أبو حامد الغزالي” رضوان الله عليه، وهو الحجة الذي لم يبلغ احد شأنه في العلم وفهم الفلسفة فهو عالم جليل ظن الناس انه واد الفلسفة بكتابه الموسوم “تهافت الفلاسفة” بينما لم يدركوا أن نقده كان منصبا على أسماء محددين من الفلاسفة وناقشهم في عشرين مسألة وافقهم في17 مسألة واختلف معهم في ثلاث مسائل في قولهم أن البعث روحي ، وان الله لا يعلم بالجزئيات وفي أزلية العالم- قدمه – وناقشهم لا بكره هو كما أكد ذلك في كل مقدمات الكتاب التي بلغت أكثر من خمس مقدمات، أي بفكر خصوم الفلاسفة وهم المعتزلة والإشاعرة وهو الذي أعلا من شأن العقل بقوله: “العقل هو من زكّى الشرع، ولا يصح الشك في المزكّى – بكسر الكاف- بالمزكّى – بفتحها”. عبارة تفتح بابا واسعا للفهم التأويلي، لأنها تقلب الاتجاه المعتاد: لا الشرع يبرهن على العقل، بل العقل هو من أعطى للشرع حجيته.
الغزالي نفسه لم يكن على وفاق تام مع ما يكتبه لعامة الناس، فقد كان يفرّق بين “علوم القشور” و”علوم اللباب”، كما أشار في مقدمة كتابه “إحياء علوم الدين”. وقال أن علم اللباب ليس موضوعه هذا الكتاب يقصد ” الأحياء “هذا التمييز يشي بأن للمعرفة الدينية مراتب، وأن خطابه كان فيها يتفاوت حسب المتلقي.فقول يقوله قالها على قدر فهم السائل والمسترشد، وقول يدافع به عن عقائد العوام وأما الحقيقة
فيحتفظ بها لنفسه، ولا يصرح بها إلا لمن يشاركه فيها الاعتقاد. بل وذهب إلى أن من يشك في معتقده بفعل قراءة جديدة فذلك نفع في ذاته، لأن من لم يشك لم ينظر، ومن لم ينظر بقي في العامية والضلال. ولهذا استشهد ببيت المتنبي الذي يقول: “خذ ما تراه ودع شيئًا سمعت به / في طلعة الشمس ما يغنيك عن زُحل”. فليس كل ما يُقال مقدسًا لمجرد وروده، إنما يُفهم بمقدار ما ينكشف في ضوء العقل والبرهان.
ومثل هذه الرؤية لا تقتصر على الغزالي وحده. الإمام القاسم بن إبراهيم – من أئمة الزيدية في القرن الثالث الهجري – قدّم حجة العقل على الكتاب والرسول، لأنهما لا يُعرفان إلا بالعقل. ورتب مصادر التشريع على النحو التالي: حجة العقل أولًا، ثم إجماع العقلاء لمعرفة الحسن والقبح العقليين، ثم العودة إلى كتاب الله لاستنباط حكم الشرع في ضوء تلك المقدمات. وهذا ترتيب مقلق لمن اعتاد أن ينظر إلى النصوص بوصفها منبتّة عن التجربة والوعي العقلي، لكنه ترتيب يعيد الاعتبار للعقل بوصفه مصدرًا أوليًّا للمعنى.
في سياقٍ مختلف وزمنٍ أقرب، يأتي الدكتور نصر حامد أبو زيد كمجدد معاصر في فهم النصوص من خلال مقاربة هرمينوطيقية تقوم على “فهم الفهم” أو “تأويل المؤول”. وقد أوضح في إحدى المقابلات التي أُجريت معه عام 2008 أن الأزمة ليست في النص الديني، بل في الإطار النظري الذي صاغ طرائق فهمه. وبيّن أنه في تدريس الدراسات الإسلامية اعتمد منهج سقراط في طرح الأسئلة بدلاً من التلقين، لتحفيز تفكير الطلاب ودفعهم إلى النقد الذاتي، رغم ما واجهه من رفض وريبة. كان حريصًا على أن يتعرف الطالب بنفسه على مساحات مجهولة من التراث، لا بهدف نقضه، بل من أجل إعادة بنائه من داخل بنيته.
أبو زيد اعتبر أن إعادة قراءة النص تعني بالضرورة إعادة تأويله في ضوء متغيرات العالم. ولفت إلى أن الفقهاء الكلاسيكيين نجحوا في بعض القضايا، كالتعامل مع إلغاء الرق أو إسقاط الجزية، وفشلوا في أخرى، مثل حقوق المرأة، حيث خضعوا للواقع الذكوري وخانوا أفق المساواة الذي يتضمنه النص نفسه. هذا الفارق بين عالم النص وعالم المفسر هو ما يجعل التأويل ضرورة لا ترفًا، وتجديد الفهم حاجة لا موضة فكرية.
كان أحد الأصدقاء قد علّق على منشوري بقوله إن النصوص الدينية ثابتة، وهو محق، غير أن الثابت لا يعني الجمود، فبين النص والمقاصد أفقٌ يتسع للعقل والاجتهاد. والقرآن، كما هو معلوم، ليس كتابًا في الفيزياء ولا الكيمياء، لكنه يوقظ العقول ويحث على النظر، وفيه من الأوامر ما يفتح أبوابًا لا تُغلق في العلم والفكر والمعرفة. إن القراءة التأويلية لا تتعالى على النص، بل تسعى لفهمه في ضوء ما يتجدد من أدوات الفهم ووسائط الإدراك. والغاية ليست تجاوز الشريعة، بل إعادة وصلها بروحها الأولى التي ما انقطعت، وإن خبت أحيانًا تحت ركام القراءات المغلقة.
ليست الدعوة إلى إعادة القراءة إلغاءً للتراث، بل رغبة في استعادة حيويته. وليست خصومة مع العقيدة، بل بحث عن جوهرها. ومن لم يشك، لم ينظر. ومن لم ينظر، لم يعرف.
اقرأ أيضا للكاتب:القرار الأهم .. تحقيق السلام وإعادة اللحمة في اليمن
اقرأ أيضا:ناجي العلي .. الوطن والفن في الممارسة السياسية (٢ ـ ٣)