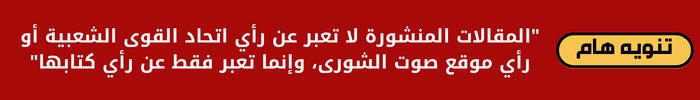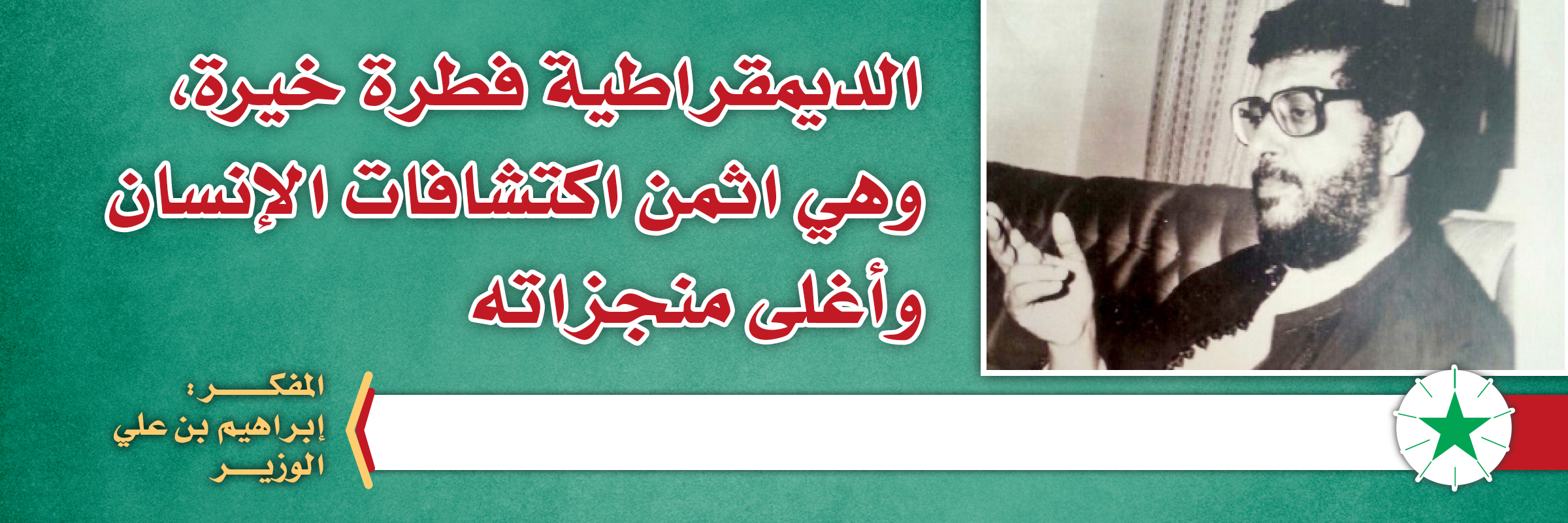الإسلام السياسي وحدود القطيعة مع الحداثة
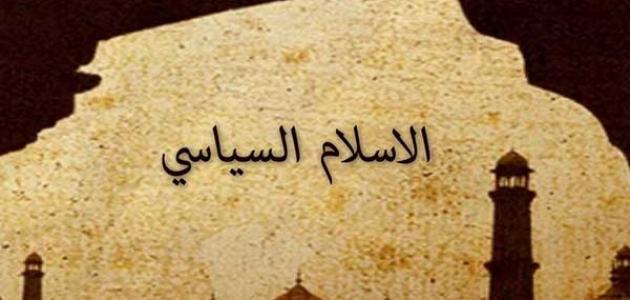
الإسلام السياسي وحدود القطيعة مع الحداثة
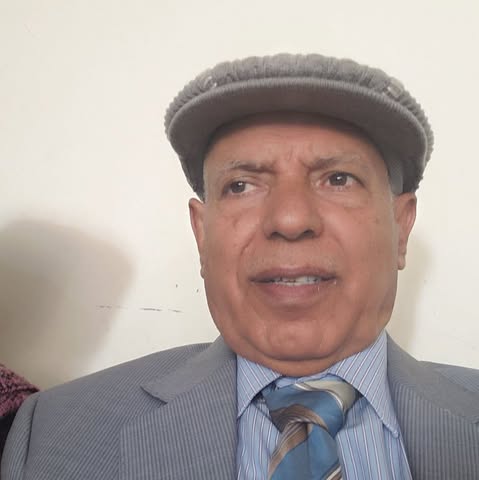
الإسلام السياسي وحدود القطيعة مع الحداثة
- حسن الدولة
السبت 6 سبتمبر 2025-
أعاد طاقم الفيسبوك لي مقالا كتبته في 4 سبتمبر 2020م تحت عنوان: (الإسلام السياسي وقيم الحداثة)، وهو عنوان ملتبس قد يوحي بوجود توافق بين الإسلام السياسي وقيم الحداثة، بينما الواقع والسياق الفكري لا يدعمان هذا الفهم بالضرورة، لذا اقتضت الضرورة إعادة صياغة المقال وتوضيح هذه الجزئية الجوهرية، من خلال قراءة نقدية معمقة، تأخذ بعين الاعتبار الأسس الفكرية للحداثة، وموقع الإسلام السياسي منها، في ضوء أطروحات فلسفية كبرى مثل نظرية “نهاية التاريخ” لفرانسيس فوكوياما، ومواقف فلاسفة التنوير، وصولاً إلى ما بعد الحداثة ونقدها للمركزية الليبرالية.
لقد أصبح من المسلمات في الفكر السياسي المعاصر أن الديمقراطية الليبرالية تمثل النموذج الأعلى لتنظيم المجتمعات السياسية، وذروة ما بلغه التاريخ من تطور مؤسسي وفكري، وهو ما أشار إليه فرانسيس فوكوياما في كتابه الشهير نهاية التاريخ والإنسان الأخير، عندما اعتبر أن الليبرالية هي “محطة الوصول الأخيرة في مسار تطور الأنظمة السياسية”، بعدما تفوقت على أبرز منافساتها الإيديولوجية: الفاشية والشيوعية. ورغم الإخفاقات التطبيقية التي منيت بها الليبرالية في عدد من المناطق الجغرافية، إلا أنها—بحسب فوكوياما—أضحت المرجع السياسي الأكثر شرعية، والنموذج الذي لا يمتلك أي بديل أيديولوجي قادر على منافسته بشكل عالمي ومنهجي، فهي بذلك تمثل، حسب تعبير هيغل، “نهاية السيرورة التاريخية للعقل”، وتحقيقًا لفكرة الحرية في أرقى صورها. وينطلق فوكوياما في تحليله من منطق جدلي يستمد جذوره من التصور الهيغلي للتاريخ، والذي يرى أن التاريخ البشري هو صيرورة عقلانية تهدف إلى تحقيق الحرية، وقد تأثر فوكوياما بأفكار كانط حول السلام الدائم، وبنظرة ماركس الجدلية للصراع التاريخي، ليصل إلى استنتاج مفاده أن الليبرالية، كنظام سياسي واقتصادي وثقافي، استطاعت أن تتجاوز التناقضات البنيوية التي عانت منها المجتمعات الغربية، مما يجعلها مرشحة لقيادة “الدولة العالمية” المستقبلية. وبهذا المعنى، يقر فوكوياما بأننا نعيش في ما أسماه “زمن ما بعد التاريخ”، حيث تم استنفاد الأسئلة الكبرى المتعلقة بمصير الإنسان، ولم تعد هناك قضايا جوهرية تستوجب ثورة أو تحولا جذريًا في بنية النظام القائم، ويشير إلى أن زمن الثورات قد انتهى، ولن نحتاج إلى السياسيين ولا إلى العسكر، بل إلى التكنوقراط والإداريين الذين يشرفون على تسيير الاقتصاد وإدارة الشأن العام.
إن صعود الدولة الليبرالية لم يكن وليد اللحظة، بل هو امتداد طبيعي لقيم الحداثة التي تبلورت منذ عصر الأنوار، حيث أسس مفكرو التنوير مثل جون لوك، فولتير، مونتسكيو، وجان جاك روسو لأفكار مركزية مثل العقلانية، التي تقوم على الإيمان بقدرة العقل البشري على فهم العالم وتغييره، والحرية الفردية باعتبارها حقًا طبيعيًا سابقًا على الدولة، كما أكد لوك، والتسامح الديني والفكري الذي دافع عنه فولتير بقوله: “قد أختلف معك في الرأي، لكني على استعداد لأن أموت دفاعًا عن حقك في التعبير عنه”، وفصل السلطات عند مونتسكيو باعتباره ضمانًا لتوازن القوى، والعدالة الاجتماعية والتعاقد الاجتماعي كما نظّر لها روسو، الذي اعتبر أن السيادة للشعب لا للحاكم المطلق. وقد تجسدت هذه القيم لاحقًا في منظومة الديمقراطية الليبرالية، التي تجمع بين التعددية السياسية واقتصاد السوق والحقوق الفردية وسيادة القانون.
لكن السؤال الجوهري يبقى مطروحًا: هل فعلاً انتهت البدائل الفكرية والسياسية التي يمكنها أن تنافس الليبرالية؟ يرى فوكوياما أن التهديدات المتبقية مثل الأصوليات الدينية والقوميات المتطرفة لا تمتلك قابلية التعميم الكوني، ولا عمقًا فلسفيًا أو سياسيًا يخولها منافسة المنظومة الليبرالية عالميًا، ويخص بالذكر الإسلام السياسي، معتبرًا أنه المشروع الوحيد الذي يقدم تصورًا شموليًا بديلًا، لكن في إطار جغرافي وثقافي ضيق، فالإسلام السياسي في نظره لا يطرح بديلاً عقلانيًا بقدر ما يمثل رفضًا للمؤسسات الحداثية، مثل الدولة الوطنية، والعقد الاجتماعي، وحقوق الإنسان، وحرية المرأة، والديمقراطية التعددية. ويقول فوكوياما ما معناه: “لا توجد أمة في العالم الإسلامي استطاعت أن تنتقل من وضع الدولة الفاشلة إلى دولة متقدمة في ظل نظام إسلامي… الإسلام يمثل الاستثناء الحضاري الوحيد الذي يقف موقفاً عدائيًا من الحداثة”. ومع ذلك، فإن هذا الطرح لا يخلو من نظرة استشراقية اختزالية، كما انتقدها إدوارد سعيد في كتابه الاستشراق، إذ يتم التعامل مع الإسلام ككتلة واحدة متجانسة، دون التمييز بين تياراته المتعددة، ولا أخذ بعين الاعتبار الظروف السياسية والاقتصادية التي أدت إلى فشل تجربة الحداثة في العالم العربي والإسلامي.
ومن جهة أخرى، ظهرت في الغرب نفسه تيارات ما بعد الحداثة التي انتقدت العقل الأداتي والمؤسسات الليبرالية، واتهمتها بأنها تخفي هيمنة رأس المال والشركات العابرة للقارات تحت ستار الحرية والديمقراطية، وقد كتب ميشيل فوكو، وجان بودريار، وليوتار عن فراغ المعنى، وانهيار السرديات الكبرى، وتحول الإنسان إلى مستهلك أكثر منه فاعلًا سياسيًا. وهذا النقد يفتح المجال أمام إعادة التفكير في النماذج السياسية، بما في ذلك إمكانية تحديث إسلامي لا يكون مضادًا للحداثة، بل مسايرًا لها، على قاعدة الجمع بين قيم التوحيد والحرية والعدالة والعقلانية، كما نادى بذلك مفكرون مسلمون مثل محمد إقبال، الطه عبد الرحمن، ومحمد عابد الجابري.
وهكذا، فإن الإسلام السياسي وإن فشل في تقديم بديل مؤسسي شامل يحظى بالقبول العالمي، إلا أنه في المقابل يعبر عن رفض مشروع للتغريب القيمي والثقافي، وعن رغبة في التحديث دون الانسلاخ عن الهوية. وإذا كانت الليبرالية قد فرضت نفسها كنموذج عالمي، فإن حق نقدها مشروع وضروري، إذ كما قال كانط: “الأنوار هي خروج الإنسان من القصور الذي ارتكبه في حق نفسه”، وهذا لا يكون إلا بالنقد الذاتي، والعودة إلى النفس اللوامة التي أقسم الله بها لرفعة مكانتها، إذ لا قيام لأمة تمزقها التفرقة الطائفية والمذهبية والتنابذ بين السنة والشيعة، والرافضة والنواصب، فكما قال الله تعالى: “إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا لستَ منهم في شيء”، فلا يمكن لأي مشروع نهضوي أن ينجح في ظل التناحر والانقسام. وفي نهاية المطاف، لن يكون مستقبل الإسلام في معاداة الحداثة، بل في تحديث ذاته من داخل منظومته القيمية، مستلهما العقل، والحرية، والعدالة، كقيم إنسانية كونية، لا تتعارض مع روح الدين، بل تتناغم معها، فالنقد الذاتي والوعي الفلسفي هما الضمانة الوحيدة لمواجهة تحديات العصر دون ذوبان في الآخر، ولا انغلاق يعطل الفعل الحضاري.
اقرأ أيضا:عبدالباري طاهر ومأزق حزب المؤتمر الشعبي العام