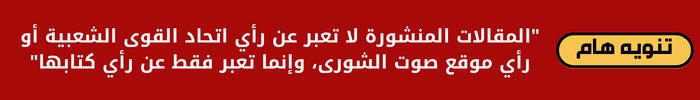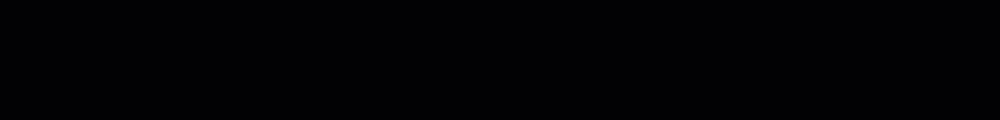هل الحزبية ظاهرة سياسية صحية أم تجسيد لعصبويات بديلة؟

هل الحزبية ظاهرة سياسية صحية أم تجسيد لعصبويات بديلة؟
أمين الجبر
الاثنين 18اغسطس2025_
هذا السؤال الاشكالي يتربع على عرش المشهد السياسي كأحد أعقد الإشكالات التي تثير الاستفهام والقلق معاً، فهو لا يكتفي بإحداث شرخ في الوعي الجمعي، بل يشكل نقطة ارتكاز تأملية في فهم آليات التحول السياسي والاجتماعي. أمام غياب الإجابات الحاسمة يظل الجمهور محولا بين الريبة والتوجس، بين قبول مرفوض ورفض غير معلن، في تعامله مع مفهوم الحزبية ومثاقفها، في حين تتاجر النخبة السياسية، بتناقضاتها البرجماتية والطوباوية، في هذه الظاهرة التي لا تترك ساحة صافية في سبيلها.
في الجانب الأول، تقف الفئة التي تؤمن نظرياً بالحزبية كبديل حضاري عن التكوينات القبلية، إلا أن هذا الإيمان لا يغفر لهم رؤية الحزبية إلا كإطار جديد للوجاهة والتسلط، مزين بثوب المدنية الزائف. إنهم ينظرون إليها بوصفها آلية للاستمرار في استبداد القديم، لكن ضمن مظاهر حديثة تضفي شرعية مزعومة على سلطانهم.
أما الفئة الثانية، فهي العين التي ترى في الحزبية ومنظماتها التعبير الحقيقي للحداثة والتجديد، باعتبارها القطيعة الابستمولوجية مع طقوس القبيلة وموروثاتها الثقافية، بل وترى فيها الحاضنة الأساسية للثقافة السياسية البديلة. هنا، يعيش الفكر الحزبي في أوج تأملاته، كأداة تشكل النموذج الحديث للمجتمع المدني، وطليعة الانتقال من الثنائية القبلية إلى الأمّة المدنية، قاطرةً نحو التحرر والتمدن.
ونحن أمام هاتين الرؤيتين، يبرز نضج قلائل، يتعاملون بمنطق الصرامة والوعي التنظيمي، ليس فقط باعتبار الحزبية مرحلة من مراحل التطور الاجتماعي، بل كخطوة نوعية نحو عملية التحديث والمسارات الواعية لتجليات المدنية. هؤلاء يرون في الحزبية شرطاً موضوعياً تقينياً يسهم في تحقيق مناخ السلم والتعايش الاجتماعي، إذ لا بد من استثمارها كعنصر تحوّلي يستدعي القبول الوقتي والتمرحل الثقافي، مؤمنين بأن هذا المسار هو بوابة حتمية للوصول إلى حالة تمدنية متقدمة تتجاوز تراتبية المجتمعات التقليدية.
أما الشريحة الأكبر من المواطنين، فهي تعالج الحزبية بسطحية وانعدام نضج فكري، تتراوح مواقفهم بين اللامبالاة والمسايرة المجردة من أي التزام مبدئي، فتتبدى مواقفهم كأوراق متقلبة يتلونون وفق التيارات السائدة، وغالباً ما يكون وعيهم محدوداً بموجب الانتماءات القبلية أو الجهوية التي تعبث بجوهرهم السياسي، فتتجه بمواقفهم نحو نكوص اجتماعي كلما اقتربوا من الخطوط الحمراء، فينكشف الزيف وتنكشف الأقنعة، وتنكشف تماماً هشاشة الإيديولوجيا المتبناة والزيف السياسي المفتعل.
وفي هذا المشهد الضبابي، يمكن النظر إلى الحزبية على نحو جدلي وشامل: إذ إذا ما استنزفت من روحها الإصلاحية والحداثية، وحيدوة الرؤية والتنظيم الهادئ، فإنها تتحول إلى شبح يماثل عصبيات بديلة متنكرة تحت قناع السياسة، تشحن مجتمعها بثارات متجددة، وتعيد إنتاج تشظيات واتحادات إقصائية.
لكن عندما تصطبغ الحزبية بنكهة وعي العمل السياسي الناضج، والالتزام التنظيمي، فإنها تصبح ظاهرة صحية ومنبع استقرار سياسي واجتماعي. إذ تلعب دوراً محوريّاً في تهدئة الاحتقانات، ومنع تفجر النزاعات القبلية والمناطقية، ودرء الحروب الطائفية، لتتخذ بذلك موقعها الحقيقي كضامن للسلم والتعايش.
في النتيجة، لا يمكن قراءة الحزبية في سياقها المعاصر إلا بتجرد فاحص لمنطق التاريخ وحركة الواقع. هي إما نواة التحديث والتنوير، وإما قناع يعيد إنتاج العنف القديم بصيغ مبتورة. والاختيار بين هاتين الوجهتين هو امتحان حقيقي لشروط التطور السياسي ومدى نضج مجتمعاتنا في السير إلى ما وراء حدود العصبويات البدائية نحو آفاق العقلانية والتداول المدني.هل الحزبية ظاهرة سياسية صحية، أم أنها تجسيد لعصبويات بديلة؟.
هذا السؤال الاشكالي يتربع على عرش المشهد السياسي كأحد أعقد الإشكالات التي تثير الاستفهام والقلق معاً، فهو لا يكتفي بإحداث شرخ في الوعي الجمعي، بل يشكل نقطة ارتكاز تأملية في فهم آليات التحول السياسي والاجتماعي. أمام غياب الإجابات الحاسمة يظل الجمهور محولا بين الريبة والتوجس، بين قبول مرفوض ورفض غير معلن، في تعامله مع مفهوم الحزبية ومثاقفها، في حين تتاجر النخبة السياسية، بتناقضاتها البرجماتية والطوباوية، في هذه الظاهرة التي لا تترك ساحة صافية في سبيلها.
في الجانب الأول، تقف الفئة التي تؤمن نظرياً بالحزبية كبديل حضاري عن التكوينات القبلية، إلا أن هذا الإيمان لا يغفر لهم رؤية الحزبية إلا كإطار جديد للوجاهة والتسلط، مزين بثوب المدنية الزائف. إنهم ينظرون إليها بوصفها آلية للاستمرار في استبداد القديم، لكن ضمن مظاهر حديثة تضفي شرعية مزعومة على سلطانهم.
أما الفئة الثانية، فهي العين التي ترى في الحزبية ومنظماتها التعبير الحقيقي للحداثة والتجديد، باعتبارها القطيعة الابستمولوجية مع طقوس القبيلة وموروثاتها الثقافية، بل وترى فيها الحاضنة الأساسية للثقافة السياسية البديلة. هنا، يعيش الفكر الحزبي في أوج تأملاته، كأداة تشكل النموذج الحديث للمجتمع المدني، وطليعة الانتقال من الثنائية القبلية إلى الأمّة المدينية، قاطرةً نحو التحرر والتمدن.
ونحن أمام هاتين الرؤيتين، يبرز نضج قلائل، يتعاملون بمنطق الصرامة والوعي التنظيمي، ليس فقط باعتبار الحزبية مرحلة من مراحل التطور الاجتماعي، بل كخطوة نوعية نحو عملية التحديث والمسارات الواعية لتجليات المدنية. هؤلاء يرون في الحزبية شرطاً موضوعياً تقينياً يسهم في تحقيق مناخ السلم والتعايش الاجتماعي، إذ لا بد من استثمارها كعنصر تحوّلي يستدعي القبول الوقتي والتمرحل الثقافي، مؤمنين بأن هذا المسار هو بوابة حتمية للوصول إلى حالة تمدنية متقدمة تتجاوز تراتبية المجتمعات التقليدية.
أما الشريحة الأكبر من المواطنين، فهي تعالج الحزبية بسطحية وانعدام نضج فكري، تتراوح مواقفهم بين اللامبالاة والمسايرة المجردة من أي التزام مبدئي، فتتبدى مواقفهم كأوراق متقلبة يتلونون وفق التيارات السائدة، وغالباً ما يكون وعيهم محدوداً بموجب الانتماءات القبلية أو الجهوية التي تعبث بجوهرهم السياسي، فتتجه بمواقفهم نحو نكوص اجتماعي كلما اقتربوا من الخطوط الحمراء، فينكشف الزيف وتنكشف الأقنعة، وتنكشف تماماً هشاشة الإيديولوجيا المتبناة والزيف السياسي المفتعل.
وفي هذا المشهد الضبابي، يمكن النظر إلى الحزبية على نحو جدلي وشامل: إذ إذا ما استنزفت من روحها الإصلاحية والحداثية، وحيدوة الرؤية والتنظيم الهادئ، فإنها تتحول إلى شبح يماثل عصبيات بديلة متنكرة تحت قناع السياسة، تشحن مجتمعها بثارات متجددة، وتعيد إنتاج تشظيات واتحادات إقصائية.
لكن عندما تصطبغ الحزبية بنكهة وعي العمل السياسي الناضج، والالتزام التنظيمي، فإنها تصبح ظاهرة صحية ومنبع استقرار سياسي واجتماعي. إذ تلعب دوراً محوريّاً في تهدئة الاحتقانات، ومنع تفجر النزاعات القبلية والمناطقية، ودرء الحروب الطائفية، لتتخذ بذلك موقعها الحقيقي كضامن للسلم والتعايش.
في النتيجة، لا يمكن قراءة الحزبية في سياقها المعاصر إلا بتجرد فاحص لمنطق التاريخ وحركة الواقع. هي إما نواة التحديث والتنوير، وإما قناع يعيد إنتاج العنف القديم بصيغ مبتورة. والاختيار بين هاتين الوجهتين هو امتحان حقيقي لشروط التطور السياسي ومدى نضج مجتمعاتنا في السير إلى ما وراء حدود العصبويات البدائية نحو آفاق العقلانية والتداول المدني.
اقرأ أيضا:صنعاء وعدن بين معادلة الصمود والتبعية: قراءة تحليلية في الواقع اليمني الراهن