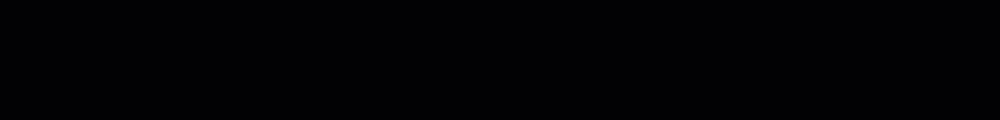من بائع الماء إلى قائد وصانع للوعي .. ملحمة عيسى محمد سيف
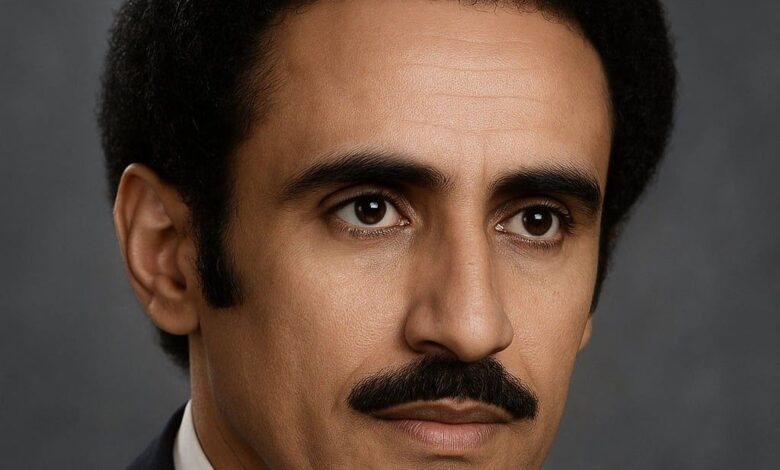
من بائع الماء إلى قائد وصانع للوعي .. ملحمة عيسى محمد سيف
- بقلم: حسن الدولة
الاثنين 13 أكتوبر 2025-
إهداء إلى نجل الشهيد حمدان، وإلى رفاقه الأوفياء الذين ظلوا أوفياء للدرب والفكرة؛ إلى الأستاذ المستشار المحامي القدير عبدالمجيد ياسين نعمان المقطري، والأستاذ أحمد عبده سيف، والبروفيسور محمود جمال، واللواء حاتم أبو حاتم، والمحقق لتراث الصوفية الأستاذ عبدالعزيز سلطان المنصوب، والأستاذ ياسين عبدالرزاق، والأستاذ سامي غالب، والأستاذ علي عبدالله الضالعي… وليعذرني الآخرون لعدم ذكرهم، فالمساحة تضيق والأسماء أكبر من الحروف.
مقدمة: لماذا نكتب عن عيسى اليوم؟ في زمنٍ تتراجع فيه القيم وتضيع فيه البوصلة الوطنية، تظل سير القادة الحقيقيين بمثابة نجوم تهدي الطريق. نكتب عن عيسى محمد سيف ليس لأنه مجرد شهيد، بل لأنه مشروع وعي، وقضية دولة، ورمز لجيلٍ آمن بأن الحرية مسؤولية وأن الكلمة موقف. رحل عيسى جسدًا، لكنه ترك ما هو أبقى من الجسد: ترك الفكرة التي لا تموت.
وُلِد عيسى في بيئة قاسية ماديًا، لكنه حوّل الفقر إلى عزيمة، وبداياته إلى معراج نحو الوعي. كان فتىً بسيطًا يبيع الماء في شوارع تعز، يحمل قربة الماء وقلبه يحمل أسئلة الوطن. لم تمنعه الحاجة من أن يحلم، ولم تمنعه الفاقة من أن يقرأ. تحت شمس الأسواق، تعلم معنى الكرامة، وهناك بدأ الدرس الأول: أن الوطن لا يُبنى إلا بأكتاف المتعبين.
حين التحق بالتعليم، لم يحمل معه سوى عناده الجميل وإصراره على أن المعرفة ليست ترفًا، بل خلاصًا. كان يحضر الدروس بعينين جائعتين للمعرفة، ويخرج ليبيع الماء ويموّل كتبه وأحلامه. من تلك اللحظة، وُلد القائد الذي لا يشبه غيره: قائد يعرف قيمة كل قطرة ماء، وكل فكرة حرة.
كبر عيسى، وكبر معه السؤال: ما الوطن؟ وما العدالة؟ لم يكن باحثًا عن مجد شخصي، بل عن معنى جديد للجمهورية التي سرقها الطغاة بعد الثورة. دخل الجامعة، لا ليكتفي بالشهادة، بل ليحوّل قاعاتها إلى ورش تفكير. لم يكن طالبًا عاديًا، بل كان معلمًا بين الطلبة، يبث فيهم فكرة أن الحرية لا تُمنح بل تُنتزع.
في تلك المرحلة، بدأ عيسى يتشكّل كزعيم فكري. لم يكن حزبياً ضيقًا، ولا منغلقًا أيدولوجيًا، بل كان جمهوريًا متفتحًا، يقرأ للعالم ويفكر لليمن. أسس مع رفاقه مشروعًا لحركة وطنية جديدة، تنادي بالعدالة الاجتماعية والكرامة، وتواجه فساد السلطة وبقايا الامامة.
لم يكن الصراع مع السلطة مجرد مواجهة سياسية، بل مواجهة أخلاقية بين من يريدون وطنًا ومن يريدون مزرعة. كتب، وناقش، ونظم، وأيقظ في الشباب حلم الدولة. حتى جاءت اللحظة الفاصلة: لحظة الاصطدام.
اعتُقل عيسى، لا لأنه حمل سلاحًا، بل لأنه حمل فكرة. قادوه إلى المحكمة مقيدًا، لكن فكره كان طليقًا. وعندما وقف القاضي ينطق بحكم الإعدام، لم يرفع عيسى يده للاحتجاج، بل صفق. صفق للموت كما يصفق الأبطال للحياة، كأنه يقول: اقتلوا الجسد، فالفكرة لا تُعدم.
يحكي القاضي: «لم أرَ في حياتي رجلًا يواجه الإعدام بتلك الطمأنينة. لم يكن متحديًا فقط، بل كان شامخًا كأنه هو من يحاكمنا». ويقول عبدالباري طاهر: «كان عيسى مشروع دولة، لا مجرد مناضل. كان يحلم بيمن لا يسود فيه أحد على أحد». ويؤكد النعمان: «لم يكن قائدًا حزبيًا، بل كان ضمير جيل بأكمله».
رحل عيسى، لكن حضوره لم يرحل. ظل في ذاكرة الناس، في وجدان الرفاق، في عيون كل من حلم بوطن ممكن. هذا هو الغياب الحاضر: أن يموت الجسد ويظل الاسم حيًا، يمشي بين الأجيال مثل نشيدٍ سريّ. لم يكن رحيله نهاية، بل بداية لسؤال كبير عن مصير الأوطان التي تُعدم قادتها وتترك مقاعدهم فارغة. فكلما مر اسمُه في وجدان من عرفوه، عادوا يتساءلون: كيف يكون الإنسان أكبر من الخوف، وكيف تصير الفكرة أقوى من الرصاصة.
كان عيسى يؤمن أن الوطن ليس حدودًا وجغرافيا، بل عدالة وكرامة ومساواة. كان يحلم بيمنٍ لا يُقصى فيه أحد، ولا تُستباح فيه الحرية باسم السلطة أو الثأر. ولذلك، لم يكن صوته مجرد معارضة، بل كان ضميرًا يدعو إلى دولة مدنية تحترم الإنسان، وتنحاز للفقراء الذين جاء منهم وإليهم يعود. لم يساوم يومًا، ولم ينحنِ لغير الحق، وظل حتى لحظته الأخيرة وفيًا للعهد الذي قطعه على نفسه: أن يكون شاهدًا لا شريكًا في الزيف.
وحين غاب، لم تغب الأسئلة التي تركها. بقيت القاعات الجامعية التي شهدت نقاشاته تحمل صداه، وبقيت وجوه الرفاق القديمة، حين تتذكره، تلمع دمعة ويعلو فخر. كان بعضهم يقول: «لو عاش عيسى، لكان لليمن طريق آخر». لكن الحقيقة أن أمثاله لا يُقاسون بما لو عاشوا، بل بما زرعوه قبل الرحيل.
لقد علّمنا عيسى محمد سيف أن البطولة ليست في أن تموت، بل في أن تعيش حاملاً لراية لا يجرؤ الآخرون على لمسها. أن تكتب وأنت تعلم أن كلماتك ستُقرأ في محاضر التحقيق، وأن تقول «لا» وأنت تدرك أن ثمنها المقصلة. لذلك، حين صفق للموت، كان يصفق للحياة التي سيحياها اسمه بعده.
اليوم، وبين ركام الخراب وتعب الحروب، نعود إلى سيرته لا لنؤدي طقس الذاكرة، بل لنبحث عن الطريق. فما تركه لنا ليس كتابًا ولا خطابًا، بل وصية صامتة تقول: ابنوا الدولة التي لا تُعدم أبناءها. لم يكن عليه أن يصرخ بهذه العبارة، فقد قالها حين وقف ينظر في عيون جلاديه دون خوف.
ليس من العدل أن يبقى هذا الاسم حبيس الرفوف أو ذاكرة جيل واحد. فقصته ليست حكاية الماضي، بل امتحان الحاضر. وإذا كانت الأمم العظيمة تُخلد قادتها في تماثيل وشوارع، فاليمن بحاجة إلى أن تُشيّد لهذا الرجل تمثالًا في ضميرها، لأنه لم يمت ليُنسى، بل مات ليُتذكر.
وهكذا، تبقى ملحمة عيسى محمد سيف مفتوحة، لا تنتهي عند رصاص الإعدام، بل تبدأ مع كل شابٍ يبحث عن معنى النقاء في زمن التلوث. وبينما تُطوى صفحات التاريخ المزيّف، تبقى صفحته عصية على الطمس، لأنه كتبها بالحبر الذي لا يُمحى: حبر الشرف.
ولعل أعظم تكريم له، أن نواصل ما بدأه، لا أن نبكي رحيله. فالأبطال الحقيقيون لا يُرثون، بل يُتبعون.
خاتمة فكرية / وطنية إنَّ الحديث عن عيسى محمد سيف ليس استعادةً لذكرى بقدر ما هو استحضار لفكرة، تلك الفكرة التي أراد لها أن تكون جسراً بين الوعي والعدالة، بين الوطن الممكن والوطن المرهون. فلم يكن عيسى قائداً سياسياً فحسب، بل كان مشروعاً لإنقاذ الإنسان من الخوف، وإعادة تعريف الحرية باعتبارها حقاً لا منحة، ومسؤولية لا شعاراً.
لقد رحل عيسى جسداً، لكنه ترك في كل من عرف فكرته بذرة سؤال: ماذا يعني أن تكون مواطناً في وطنٍ لم يكتمل بعد؟ لذلك، فإن الغياب الذي يتركه أمثال عيسى لا يُقاس بالفراغ، بل يُقاس بما يوقظه من ضمير، وما يفتحه من دروب نحو بناء الدولة التي حلم بها؛ دولة القانون، لا دولة الامتيازات، دولة الإنسان، لا دولة العائلة أو السلالة.
إن ملحمة عيسى محمد سيف تعلّمنا أن المشاريع العظمى لا تُنجز في حياة أصحابها دائماً، وأن الأفكار التي تُروى بالدم تبقى أكثر حياةً من أولئك الذين يطمرونها بالخوف أو بالسلاح. من هنا، تكمن مسؤولية الأجيال الجديدة ليس في التأبين، بل في المتابعة، ليس في التغنّي بالأسماء، بل في حمل الرسالة والنظر إلى الوطن بعين الواجب لا بعين الميراث.
فلتكن العودة إلى ذكرى عيسى ليست عودة إلى الحزن، بل إلى التصميم؛ ليست بحثاً عن ماضٍ مفقود، بل عن مستقبل يستحق أن نكون جديرين به. فالشهداء لا ينتظرون دموعنا، بل انتظارهم الوحيد أن نكون استمراراً لما بدأوه، لا نهايةً لما كانوا.
هكذا تبقى الفكرة، وتبقى الملحمة مفتوحة على الغد.
اقرأ أيضا للكاتب: في الذكرى الـ 62 لثورة 14 أكتوبر… ذاكرة تحرر في ظل سلطات بلا شرعية