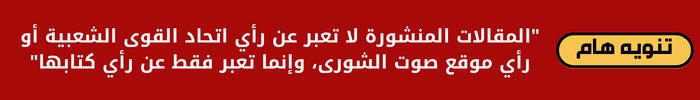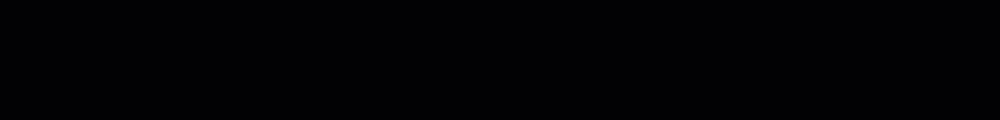ثورة 26 سبتمبر والصراع الجيوسياسي

ثورة 26 سبتمبر والصراع الجيوسياسي
ثورة 26 سبتمبر والصراع الجيوسياسي
- أمين الجبر
الخميس 25 سبتمبر 2025-
مثَّلت ثورة 26 سبتمبر 1962 في اليمن لحظة مفصلية لم تكن مجرد تحول داخلي، بل كانت تجسيداً لحقل صراع جيوسياسي إقليمي ودولي. لقد تفاعلت التناقضات الداخلية البنيوية – الموروثة عن نظام الإمامة – مع الديناميكيات الإقليمية الناشئة في حقبة المد القومي والتحولات ما بعد الاستعمارية، لتحويل اليمن إلى ساحة حاسمة لتوازنات القوى.
لم يكن المشهد اليمني منقسماً بشكل ثنائي بدائي بين جمهوريين وملكيين، بل كان فسيفساء معقدة من القوى المتصارعة التي شكلت بيئة خصبة للاستقطاب الخارجي يمكن إيجازها على النحو الآتي:
. الجمهوريون: تحالف غير عضوي بين النخبة العسكرية الحديثة (ضباط أحرار) وقوى حضرية (تجار، مثقفون)، اتسم بالهشاشة والخلافات التكتيكية والأيديولوجية منذ الولادة.
. الملكيون: تحالف تقليدي يجمع بين بقايا النظام الإمامي وقبائل ذات مصالح، مثّل الوجه التقليدي للمقاومة ضد الحداثة السياسية.
. الدستوريون (القوة الثالثة): محاولة نخبة ثقافية لإيجاد صيغة توافقية (دولة اليمن الإسلامية)، تعكس رغبة في إصلاح النظام دون اقتلاعه جذرياً، مما جعل موقعها هامشياً في معادلة الصراع العنيف.
. القبائل: العامل الحاسم المتقلب، لم تكن كتلة أيديولوجية بل فاعلاً براغماتياً تحركه المصالح المادية والضغوط الآنية، مجسدةً مفهوم أشبه بالمرتزقة السياسيين في حرب أهلية.
هذا التشظي لم يكن انعكاساً لصراع هويات فحسب، بل كان تعبيراً عن أزمة انتقال من نظام ثيوقراطي تقليدي إلى نموذج الدولة الوطنية الحديثة، في غياب توافق على مفهوم الشرعية السياسية ذاتها. الأمر الذي تحول اليمن معه إلى مسرح لتصادم مشروعين إقليميين متنافسين، كل منهما يحمل رؤية للنظام الإقليمي.
المشروع الناصري (الجمهورية العربية المتحدة) سعى إلى ترجمة الأيديولوجيا القومية العربية إلى سياسة خارجية فعلية، حيث كان الدعم المصري للجمهوريين أداة لتصدير الثورة بقصد احتواء المد الثوري وتوجيهه لخدمة النفوذ المصري، وكذلك تعزيز الأمن القومي المصري بهدف السيطرة على المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، فضلا عن مواجهة النفوذ الملكي وتحجيم القوة السعودية التقليدية. غير أن هذا التدخل اتسم بمفارقة الوصاية، حيث أدت الممارسات البيروقراطية والأمنية المصرية إلى محاولة إفراغ الثورة من مضمونها الشعبي وتحويلها إلى نظام تابع، مما أضعف شرعيته على المدى الطويل.
أما المشروع السعودي (المملكة العربية السعودية)، فقد نظر إلى الثورة عبر منظور العدوى الأمنية، وكان دعمه للملكيين مدفوعاً بغريزة البقاء، والخوف من انهيار نموذج الحكم الملكي التقليدي تحت ضغط الموجة الجمهورية، بالإضافة إلى استحضار الذاكرة التاريخية، حيث أيقظت الثورة هواجس الغزو المصري (محمد علي)، وإيجاد ما يمكن أن نطلق عليه الحدود الآمنة لمنع قيام دولة يمنية قوية وقومية على حدودها الجنوبية.
لذا اعتمدت الاستراتيجية السعودية على رأسمالية المحاصصة باستخدام المال لاستقطاب القبائل، مما حوّل الصراع إلى حرب استنزاف اقتصادي وليس مواجهة عسكرية مباشرة.
هذا ولم يكن الصراع محصوراً بالإطار الإقليمي وحسب، بل كان تجلياً للصراع الثنائي الدولي، حيث الولايات المتحدة وبريطانيا، من جهة، قد وقفتا إلى جانب السعودية والملكيين، انطلاقاً من منطق احتواء الشيوعية ودعم الحلفاء التقليديين، حتى لو كانوا أنظمة تقليدية، ومن جهة ثانية الاتحاد السوفيتي الذي دعم الجمهورية انسجاماً مع سردية دعم حركات التحرر الوطني، في إطار التنافس على النفوذ في العالم الثالث.
ولقد أثبتت التطورات اللاحقة، وخصوصاً حصار السبعين يوماً على صنعاء (1967-1968)، أن الحسم النهائي، رغم كل التدخلات، يعود للإرادة السياسية والعسكرية اليمنية الداخلية، إذ فشلت الاتفاقيات الخارجية كـ”اتفاق جدة 1965″ لأنها لم تبنَ على توازن داخلي حقيقي. وهذا يؤكد مقولة مفادها أن التدخل الخارجي قد يطيل أمد الصراع ويشكل مخرجاته، لكنه لا يستطيع صنع شرعية سياسية دائمة.
فيا ترى هل تكرر اليوم، مع اختلاف الأسماء والتحالفات، النمط التاريخي ذاته واستمرار التشظي الداخلي؟ بحيث تحل قوى الشرعية وأنصار الله الحوثيون والمجلس الانتقالي مكان القوى القديمة، في استمرار لأزمة الشرعية والمركز، وكذلك تحول التحالفات الإقليمية بحيث حلت إيران (كممثل للمشروع الثوري المذهبي) مكان مصر الناصرية، بينما تحولت السعودية من دعم الإمامة إلى قيادة تحالف دعم الشرعية، في دليل على أن المصالح الجيوسياسية، وليس الثوابت الأيديولوجية، هي محرك السياسة الإقليمية، ولا تزال اليمن مسرحاً لتصفية حسابات قوى أكبر، والخاسر الأكبر هو السيادة اليمنية والنسيج الاجتماعي.
على اية حال يقدم التاريخ درساً واضحاً يؤكد إن خلاص اليمن لا يكمن في البحث عن حليف خارجي منقذ، بل في القدرة على بناء إجماع وطني داخلي يستند إلى جملة عوامل موضوعية لعل من أهمها:
. استعادة مفهوم الدولة القائمة على المواطنة المتساوية، متجاوزةً الانتماءات القبلية والمناطقية والطائفية.
. رفض الوصاية الخارجية بكافة أشكالها، والاعتماد على الإرادة الذاتية في صنع القرار.
. التمسك بالإطار الجامع الذي يمثله النظام الجمهوري والوحدة الوطنية ومخرجات الحوار الوطني كأرضية دنيا للتوافق.
كون الحل الدائم ليس نتاج مفاوضات بين قوى خارجية، بل. هو مشروع سياسي يمني يصهر التناقضات في بوتقة المصلحة الوطنية العليا، ويُخرج اليمن من كونه مسألة في السياسة الإقليمية إلى كونه فاعلاً في مصيره.
اقرأ أيضا: 26سبتمبر و14 أكتوبر ذاكرة لا تُزَوَّر، وإرادة لا تنكسر