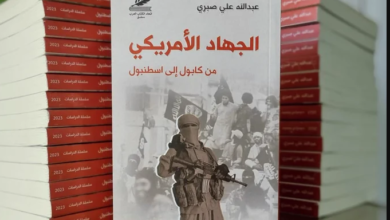الحوار كدواء «غيوم حول الثورة الدستورية»

الحوار كدواء «غيوم حول الثورة الدستورية»

الحوار كدواء «غيوم حول الثورة الدستورية»
وضاح عبد الباي طاهر
«غيوم الثورة الدستورية»، كتاب للأستاذ المفكر زيد الوزير. يقع في 165بالقطع المتوسط. من إصدارات مركز التراث والبحوث اليمني.
ليس هناك أفضل من الحوار كدواء لعللنا، وكشمس تبدد غيوم الفكر والثقافة والسياسة المتلبدة في أفقنا، فنتنسم بواسطته أنفاس الحقيقة، لتتسع الرؤية، وتتلاقح الأفكار، وتُصوَّب الأخطاء التي لسنا- بمجموعنا- بمعصومين عن الوقوع فيها.

والحوار أيضًا فرصة للعتاب بين المتحابين؛ ممن تربطهم روابط شتى أهمها البشرية الجامعة للنوع الإنساني كله، طالما تحلى الحوار بالأدب الرفيع، وسار على المنهج العلمي، ووُزِن بالقسطاس المستقيم الذي لا يميل. كل ذلك خدمةً للحقيقة، ونشدانًا للمعرفة المفيدة لليقين؛ فبالحوار تُستجلي أخطاء التاريخ، وتُحل مشكلات السياسة والثقافة في مجتمعات لازالت أدواؤها تفتك بها، وتفرق بين أبنائها.
لابد إذن من تلمس مواطن الداء، وتحسس مواضع العلل على أيدي حكماء علماء، ومفكرين ذوي خبرة في جميع حقول المعرفة الإنسانية.
أستاذنا الأديب الكبير زيد بن علي الوزير؛ عني التعريف ،فهو من أسرة كريمة لها آثار وأخبار كثيرة طيبة مشهورة ومدونة في كتب التاريخ، حتى لقد أفرد أعلامها بمؤلف خاص لكثرتهم. ولعل من أهم أعلام هذه الأسرة المباركة الإمام المجتهد محمد بن إبراهيم الوزير (ت 840هـ)، وأخوه الأكبر الهادي بن إبراهيم (822هـ).
ومحمد بن إبراهيم هو الذي مهد الطريق، وفسح السبيل لمن جاء بعده بالانفتاح على أهل السنة، متبعًا سلفه من قدماء أهل البيت ممن نبذوا العصبية، وخلعوا رداء التقليد؛ فالحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها.
يقول الإمام علي زين العابدين رضي الله عنه: “ليس التعصب أن يحب المرء قومه؛ فهذا أمر فطري، ولكن التعصب أن يفضل شرار قومه على خيار قوم آخرين”.
لقد تجرد هذا العالم الجليل للحقيقة، وأخلص لها، ولم يتقيد بآراء الرجال، ولو كانوا آباءه، أو من ذوي رحمه، مهما تحلوا به من جلالة العلم، وبلغوه من حرارة الإيمان والتقوى.
وفي الوقت الذي نجد ابن الوزير مؤيدًا لبعض آراء لأهل السنة وأهل الحديث في مسائل كلامية كثيرة، نجده أيضًا منافحا صلبًا لحرية الإرادة الإنسانية موافقًا فيها قدماء أهل البيت والمعتزلة.
وهو في رده على المعتزلة، ومن وافقهم من أهل البيت في قولهم بوجوب اللطف الإلهي على الخالق سبحانه، لا يتردد أيضًا بالرد على الأشاعرة في إنكارهم للحكمة الإلهية.
ولعل أهم ميزة هذا العالم الكبير هو بعده عن تكفير المخالفين، كما فعل قبله الإمام يحيى بن حمزة، وتأوله لهم، وبسط العذر في اجتهادهم فيما ذهبوا إليه، وهو نفس صنيع علامة الأشعرية فخر الدين الرازي، ومن قبله إمامه أبو الحسن الأشعري.
وعلى هذا السبيل مشى أستاذنا الوالد زيد الوزير -حفظه الله- فهو لا يغضب إلا للحق، ولا يطلب ولا يتوخي سوى الإنصاف، وهكذا نحسبه.
يذهب هونيث إلى أن أخلاقية أي مجتمع تقاس بمدى إمكانية ضمان شروط الاعتراف المتبادل بين أفراده. ولكن الإنصاف عزيز كما يقال، وقديمًا قال الشاعر العربي:
ولم تزل قلة الإنصاف قاطعةً* بين الرجال وإن كانوا ذوي رحمِ
يبدي الأستاذ زيد المرارة من عدم الإنصاف لمن تصدوا للكتابة عن ثورة 1948؛ فلم يعطوا لهذا الأسرة أعني– آل الوزير، وغيرهم من رجالات اليمن كالعلامة حسين الكبسي، وجمال جميل، والنقيب أمين أبو راس، والشيخ عبد الوهاب نعمان، وآل بحيبح، وآل هارون حقهم من الذكر اللائق بهم وبنضالهم، وتسجيل مواقفهم وأدوارهم بأمانة ونزاهة، لكن قاتل الله (ساس ويسوس)؛ فإنها ما دخلت في شيء إلا أفسدته؛ ولا يزال السيف في وطننا العربي مستعبدًا للقلم، فهو يجري معه بحسب هواه، وبما تمليه عليه سلطته القاهرة.، وهذا معنى قول البحتري:
وعادة السيف أن يستعبد القلما
لقد ساهم في ثورة 1948، وفي ثورة 26 سبتمبر 1962 كثير من فئات المجتمع اليمني من أبناء عدنان وقحطان دون تفرقة بينهم، أو بخس لأدوار أيٍّ منهم؛ فالجميع يمنيون تجمعهم روابط الأرض والدين والنسب والإنسانية.
يذكر الأستاذ الباحث عيبان السامعي في كتابه «إشكالات الواقع اليمني»، أن الهاشميين مثلوا 80% من قوام تنظيم الضباط الأحرار الذي فجر ثورة 26 سبتمبر 1962. (انظر: ص195).
وإذا كانت الحرب المستعرة في اليمن منذ قرابة تسع سنوات قد فرقت أيدي أبنائه، ومزقت نسيجهم الاجتماعي، ورابطتهم الدينية والجغرافية، فأطلت آفات العنصرية، وأمراض الكراهية والطائفية برأسها؛ فظهر مصطلح « الهاشمية السياسية»، وكتاب «القبيلة الهاشمية ألف عام من الدم»، وكتاب «التنظيم السري للهاشمية السياسية»، و«خيوط الظلام»، وكلها تنضح- كما يقول هذا الباحث المتجرد – بالطائفية والجهوية، ويُلمس من خلالها النزعة الطائفية، فهي لا تقدم معرفة حقيقية، ولا نقدًا علميًا للظاهرة الطائفية بقدر ما تعمل على تهييج العواطف، وإثارة الضغائن، واستثارة النوازع الغريزية. (المصدر السابق، ص 192- 193).
ومع ذلك، فلا يُعفى متطرفي الجانب الآخر من التعصب والعنصرية والممارسات السيئة أيضًا، بعدم قبولهم بالآخر، وفرض رؤيتهم الأحادية مستخدمين أدوات القوة والإكراه والعنف في سابقة لم يعرفها التاريخ اليمني.
وإذا كان لهذه الحرب دور كبير في إحياء هذه النزعات المقيتة، والعصبيات المنتنة؛ فما بالها أيام السلم لم تُطفأ جمرتها؛ فظلت متوارية تحت الرماد، تنتظر من يبعثها نارًا تَضَرم وتشتعل؛ لتحرق الأخضر واليابس؟!
لم يكن اغتيال الإمام يحيى أمرًا صائبًا أو جائزًا، وعُدّ القيام به سابقةً في المذهب الزيدي، وقد كان هذا رأي والد الأستاذ زيد- الأمير علي الوزير، والأستاذ أحمد نعمان، لكن المتهورين من رجال 48 آثروا هذا الرأي، وجنحوا إليه، ومالوا له، ومن البلية أن يكون الرأي في يد من لا يملكه، كما قال علي بن أبي طالب- رضي الله عنه.
يذكر الجاحظ في كتابه «البيان والتبيين»، عند حديثه عن الشاعر بشار بن برد، في إشارة لرأيه في تكفير جميع الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وتصويبه لإبليس، وتفضيل النار التي خُلِق منها على الطين الذي خُلِق منه آدم، في قوله:
الأرضُ مظلمةٌ والنارُ مشرقةٌ* والنارُ معبودةٌ مذ كانت النارُ
يحكي الجاحظ كلامًا لواصل بن عطاء رئيس المعتزلة يقول فيه: “أما لهذا الملحد الأعمى المشنف المتكنى بأبي معاذ مَنْ يقتله؟! أما والله لولا أن الغيلة سجية من سجايا الغالية؛ لبعثت اليه من يبعج بطنه على مضجعه، ويقتله في جوف منزله، وفي يوم حفله، ثم كان لا يتولى ذلك منه إلا عقيلي أو سدوسي”.
ومحل الشاهد أن واصل بن عطاء لم يستحل قتل بشار غيلة، وتنزه وترفع عن التحريض على اغتياله رغم كل ما صدر عنه، وبدر منه، وعد ذلك نوعًا من الغلو لا يقوم به سوى الغلاة المتطرفين الذين لا يحتكمون لمنطق، ولا يذعنون لحجة غير حجة السيف والإكراه والعنف.
لم ينسَ الأستاذ زيد فضل أساتذته عليه، وعاطفته النبيلة نحوهم كالأستاذ الأديب الشاعر أحمد الشامي، أو المؤرخ محمد الأكوع، أو الأستاذ الشاعر عبد الله البردوني- رحمهم الله-، إلا أن ذلك لم يحل دون أن يحاورهم، ويرد عليهم أخطاءهم التي يرى أستاذنا أنهم وقعوا فيها، كل ذلك بأدب جم، وبتواضع العالم المستنير. وقد قال مالك -رحمه الله-: “كلٌ يؤخذ من كلامه ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر”، وقال العلامة الشاعر صالح الحامد:
فتوافقٌ وتخالف ٌ* والودُ باقٍ في الضميرْ
ود الأخوة ثابتٌ* ووشاية الواشي تطيرْ
والأستاذ زيد في حواره مع الأستاذ البردوني التزم الحجة، وتمثل أدب الحوار، بخلاف أستاذه الأستاذ الشاعر والأديب الكبير أحمد الشامي في كتابه «من الأدب اليمني: تاريخ ونقد»؛ فإنه رغم ما أبداه من تصويبات مهمة على كتاب الأستاذ البردوني «رحلة في الشعر اليمني قديمه وحديثه»، وقيامه بتصحيح كثيرًا من الأخطاء التي وقعت في كتابه، والتي لم يكن سببها إلا اعتماد الأستاذ البردوني على ذاكرته، والذاكرة تخون، والحفظ يزيد وينقص، إلا أن الأستاذ الشامي تجاوز ذلك، وخرج عن حد الاعتدال في أدب الحوار؛ فأسف في خصومته بنزق وحدة وعنجهية لا تليق بعالم وشاعر كبير مثله، فعيَّر الأستاذ البردوني بعماه، ولم يكن العمى من كسب البردوني حتى يستحق عليه هذا التثريب والانتقاص. وقديمًا قيل: إذا عبت المخلوق فقد عبت الخالق.
يبدأ الأستاذ زيد الوزير الحوار مع الأستاذ عبد الله البردوني- رحمه الله- على إثر مقابلة أجريت معه في صحيفة الشورى، جرى فيها البردوني بما عرف عنه من علم واسع، واطلاع عميق، وكعادته من حرية الضمير، والجري على السجية والطبيعة التي لا تعرف أن تقول غير ما تعتقد.
لكن الأستاذ البردوني شاعر وأديب كبير وليس مؤرخًا، وإذ نجد أنفسنا نتفق معه ومع الأستاذ زيد في أن هناك تاريخ الدول والملوك (التاريخ الرسمي)؛ الناطق بلسان الدولة، وهناك (تاريخ الشعوب) الذي تسجله بدمائها وعرق جبينها في سبيل مجدها ورفعتها وخلودها، إلا أن الأستاذ زيد، ومعه كل الحق، يختلف مع البردوني أن يجعل من قصص «ألف ليلة وليلة» تاريخًا (تاريخ الشعوب). فألف ليلة وليلة كتاب أدبي مزجت فيه الحقيقة بالخيال الخصب، وألهم كثيرًا من المفكرين والمبدعين حتى الغربيين منهم؛ فدرسوها وأثنوا عليها، وهو يعتبر من بواكير وأصول فن السرد والرواية، وملهمًا لعلماء ومفكرين كبار، وقد يصلح أن يكون مادة للدرس والبحث عن واقع العصر الذي كتبت فيه، غير أنه قد تعاقبت على هذا الكتاب عصور كثيرة بدءًا من ترجمته عن أصله الفارسي «هزار أفسان» والتي تعني (ألف خرافة)، وانتهاء بعصر المماليك، أما أن يكون تاريخًا بالمعنى العلمي للتاريخ؛ فهذا ما لا يوافقه عليه حتى المؤرخون أنفسهم.
يقول فارادي، وهو من أعظم العلماء في عصره في خطاب لصديق له: “لا تفترض أني مفكر عميق، ولا أنني شخص متميز. لقد كنت شخصًا متسمًا بخيال حيوي بحيث كنت أستطيع أن أصدق ما جاء في «ألف ليلة وليلة»، مثلما هو موجود في «الموسوعة». لكن الحقائق كانت مهمة بالنسبة إلي أيضًا، وهي التي حافظت علي. إنني أثق بحقيقةٍ ما، ثم أقوم بفحوص كثيرة لها، ثم عندما تثبتها التجارب أشعر بأنني أمسك في يدي بمرساة، وأنني أتعلق بها”.
وأين هذا من كلام الكاتب السلفي مشهور بن سلمان آل سلمان في كتابه «كتب حذر منها العلماء»، والذي يصفه بـ «الكتاب اللقيط»، وأن معاهد الإرساليات، ومطابع الشيوعيين والزنادقة قامت بالاحتفال به وترويجه.
وإذا عُرف السبب بطل العجب؛ فمدار الطعن في هذا الكتاب؛ كونه يصور الخليفة هارون الرشيد لاهيًا ماجنًا معاقرًا للخمرة، وهو المؤمن التقي المشهور بالاستقامة والصلاح، والذي كان يحج عامًا، ويغزو عامًا بحسب فتوى الشيخ الوهابي صالح الفوزان.
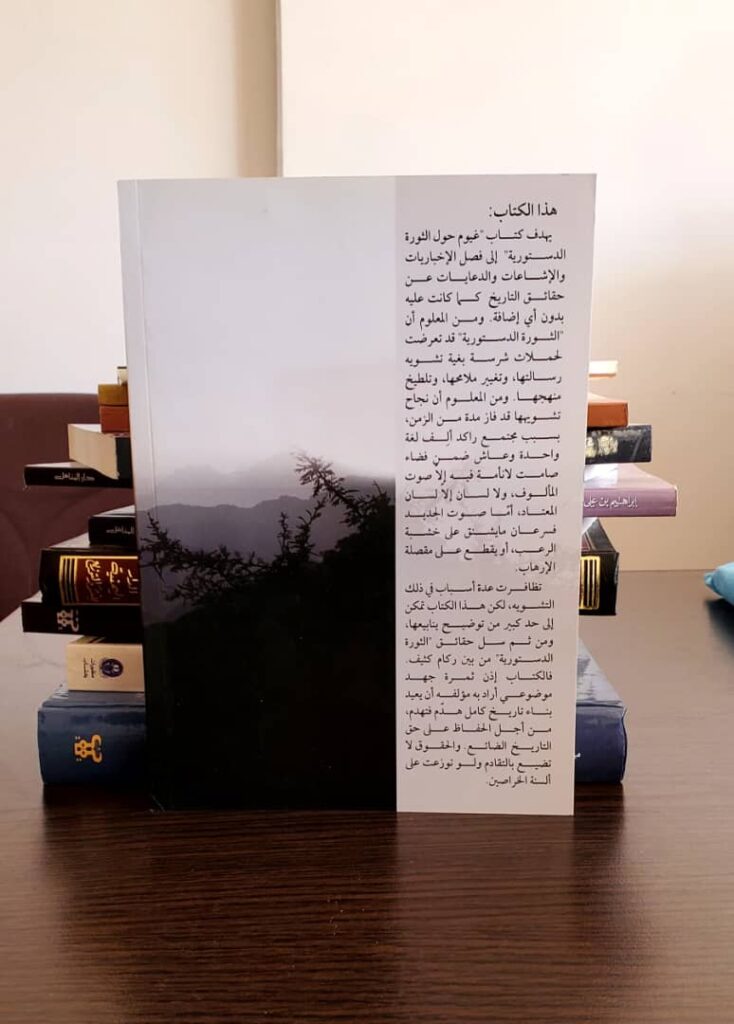
ولم يسلم من هذا الكتاب حتى الجاحظ الذي يصفه المؤلف بالنفاق، ويحذر منه ومن كتبه، كما يحذر من كتاب الأغاني، والعقد الفريد، والكامل للمبرد؛ وهي أصول وأمهات كتب الأدب العربي.
أما رد الأستاذ زيد على العلامة المؤرخ محمد بن علي الأكوع -رحمه الله-، فيقتصر على النزعة المبالغ فيها للقحطانية، والتي كانت رد فعل للنزعة المبالغ فيها للعدنانية، ومع ذلك، فليس ذلك بعاذرٍ كل من دعا إلى عصبية أو عنصرية من أي فئة أو شريحة.
تبدت هذه النزعة والعاطفة الخارجة عن حد الاعتدال في تحقيقات المؤرخ الأكوع لكتب لسان اليمن أبو محمد الحسن الهمداني، وفيها يصف الهاشميين بـ «المتوردين»، وهي عين اللفظة التي قالها الأسود العنسي واصفًا مبعوثي النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، واعتبر القاضي الأكوع الهاشميين من هؤلاء المتوردين الذين يتوجب عليهم أن يعودوا من حيث جاؤوا.
إن من الحيف أن يُجعل الهاشميون لونًا واحدًا، ولو اقتصر القاضي الأكوع بالقدح على من ظلمه، لكان له مسوغ وعذر في ذلك، لكن أن تحل العقوبة بغير من اجترمها؛ فهذا سَرَف يرفضه العقل، ويأباه الإنصاف؛ فالهاشميون- كما يقول الأستاذ عيبان السامعي: “لا يشكلون طبقة/ فئة/ شريحة اجتماعية واحدة ومنسجمة. فالواقع يقول: إن الهاشميين متعددون في مواقعهم الطبقية، فمنهم الأغنياء- أصحاب الأراضي والأملاك الكبيرة… ومنهم الطفيليون الذين ارتبطوا بالسلطة، وأثروا من خلالها بطرق غير مشروعة، ومنهم المنحدرون من الطبقة الوسطى، ويمتهنون المهن العصرية مثل الطب والتعليم والقضاء والسلك الدبلوماسي والصحافة والإعلام والكتابة والإبداع الثقافي والمهن الفنية والهندسية… الخ ومنهم الفقراء والمعدمون، وحال هؤلاء كحال غالبية جماهير الشعب المفقرة يعيشون في أوضاع بائسة تفتقر لمقومات الحياة الكريمة”. (المصدر السابق، ص 194 باختصار).
ولا شك أن هذه الظاهرة المشينة لها أسبابها وعواملها المتعددة التي تحتاج لبحث وتقصي بموضوعية ومنهجية علمية؛ لتجفيف منابعها، واستئصال جذورها؛ حتى يعود الناس إخوانًا متحابين متعاونين مشغولين ببناء أوطانهم، وبما يرقيهم، ويرفع من شئونهم.
ولعل ما يقع على رأس هذه الأسباب هو دعوى احتكار الحكم في فئة أو طائفة بعينها؛ وهو ما ولد كثيرًا من الظواهر السلبية، ليس الصراع على الحكم على امتداد التاريخ اليمني إلا واحدًا منها.
الكتاب إصدار مهم، وعرض أفكاره تحتاج وقفات كثيرة يضيق المقام عنها، لكن يمكن القول في الأخير بأنه يعطي درسًا عميقًا في أدب الحوار باستعمال الكلمة الحسنى، والإدلاء بالحجة المنيرة الدامغة، والمجادلة بالتي هي أحسن.
أرجو أن تكون هذه الكلمة تحية طيبة، لعلم كبير من أعلام الفكر والثقافة في يمننا الكبير، وله أيادي بيضاء لا تنكر يجزيه الله عنها الخير الكثير.
اقرأ أيضا:«حرث في حقول المعرفة» للأديب والمفكر قاسم بن علي الوزير